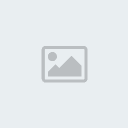•
الآيات 41-50
يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي
الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن
قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ
سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن
بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن
لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن
تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ
اللّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ
فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿41﴾ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ
لِلسُّحْتِ فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ
فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿42﴾
وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللّهِ
ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ
﴿43﴾ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا
النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ
وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ
اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ
وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ
يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿44﴾
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ
لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ﴿45﴾ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ
الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿46﴾ وَلْيَحْكُمْ
أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا
أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿47﴾ وَأَنزَلْنَا
إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ
اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ
جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ
أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا
الخَيْرَاتِ إلى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿48﴾ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ
وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ
مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ
اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿49﴾ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ
أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿50﴾
بيان:
الآيات متصلة الأجزاء يرتبط بعضها ببعض ذات سياق واحد يلوح منه أنها نزلت
في طائفة من أهل الكتاب حكموا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في بعض
أحكام التوراة وهم يرجون أن يحكم فيهم بخلاف ما حكمت به التوراة فيستريحوا
إليه فرارا من حكمها قائلين بعضهم لبعض: ﴿إن أوتيتم هذا - أي ما يوافق
هواهم - فخذوه وإن لم تؤتوه - أي أوتيتم حكم التوراة - فاحذروا﴾.
وأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أرجعهم إلى حكم التوراة فتولوا عنه، وأنه
كان هناك طائفة من المنافقين يميلون إلى مثل ما يميل إليه أولئك المحكمون
المستفتون من أهل الكتاب يريدون أن يفتنوا رسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم) فيحكم بينهم على الهوى ورعاية جانب الأقوياء وهو حكم الجاهلية، ومن
أحسن حكما من الله لقوم يوقنون؟ وبذلك يتأيد ما ورد في أسباب النزول أن
الآيات نزلت في اليهود حين زنا منهم محصنان من أشرافهم، وأراد أحبارهم أن يبدلوا
حكم الرجم الذي في التوراة الجلد، فبعثوا من يسأل رسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم) عن حكم زنا المحصن، ووصوهم إن هو حكم بالجلد أن يقبلوه،
وإن حكم بالرجم أن يردوه فحكم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالرجم
فتولوا عنه فسأل (صلى الله عليه وآله وسلم) ابن صوريا عن حكم التوراة في
ذلك وأقسمه بالله وآياته أن لا يكتم ما يعلمه من الحق فصدق رسول الله (صلى
الله عليه وآله وسلم) بأن حكم الرجم موجود في التوراة القصة وسيجيء في
البحث الروائي الآتي إن شاء الله تعالى.
والآيات مع ذلك مستقلة في بيانها غير مقيدة فيما أفادها بسبب النزول، وهذا شأن
الآيات القرآنية مما نزلت لأسباب خاصة من الحوادث الواقعة، ليس لأسباب نزولها
منها إلا ما لواحد من مصاديقها الكثيرة من السهم، وليس إلا لأن
القرآن كتاب عام دائم لا يتقيد بزمان أو مكان، ولا يختص بقوم أو حادثة خاصة،
وقال تعالى: ﴿إن هو إلا ذكر للعالمين﴾: يوسف: 140 وقال تعالى: ﴿تبارك الذي
نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا﴾: الفرقان: 1 وقال تعالى: ﴿وإنه
لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه﴾: فصلت: 42.
قوله تعالى: ﴿يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر﴾، تسلية
للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتطييب لنفسه مما لقي من هؤلاء المذكورين
في الآية، وهم الذين يسارعون في الكفر أي يمشون فيه المشية السريعة،
ويسيرون فيه السير الحثيث، تظهر من أفعالهم وأقوالهم موجبات الكفر واحدة
بعد أخرى فهم كافرون مسارعون في كفرهم، والمسارعة في الكفر غير المسارعة
إلى الكفر.
وقوله: ﴿من الذين قالوا ءامنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم﴾ بيان لهؤلاء الذين
يسارعون في الفكر أي من المنافقين، وفي وضع هذا الوصف موضع الموصوف إشارة
إلى علة النهي كما أن الأخذ بالوصف السابق أعني قوله: ﴿الذين يسارعون في
الكفر﴾ للإشارة إلى علة المنهي عنه، والمعنى - والله أعلم -: لا يحزنك
هؤلاء بسبب مسارعتهم في الكفر فإنهم إنما آمنوا بألسنتهم لا بقلوبهم وما
أولئك بالمؤمنين، وكذلك اليهود الذين جاءوك وقالوا ما قالوا.
وقوله: ﴿ومن الذين هادوا﴾ عطف على قوله: ﴿من الذين قالوا ءامنا﴾ إلخ على ما
يفيده السياق، وليس من الاستيناف في شيء، وعلى هذا فقوله: ﴿سماعون للكذب
سماعون لقوم آخرين لم يأتوك﴾ خبر لمبتدء محذوف أي هم سماعون إلخ.
وهذه الجمل المتسقة بيان حال الذين هادوا، وأما المنافقون المذكورون في صدر الآية فحالهم لا يوافق هذه الأوصاف كما هو ظاهر.
فهؤلاء المذكورون من اليهود هم سماعون للكذب أي يكثرون من سماع الكذب مع
العلم بأنه كذب، وإلا لم يكن صفة ذم، وهم كثير السمع لقوم آخرين لم يأتوك،
يقبلون منهم كل ما ألقوه إليهم ويطيعونهم في كل ما أرادوه منهم، واختلاف
معنى السمع هو الذي أوجب تكرار قوله: ﴿سماعون﴾ فإن الأول يفيد معنى الإصغاء
والثانية معنى القبول.
وقوله: ﴿يحرفون الكلم من بعد مواضعه﴾ أي بعد استقرارها في مستقرها والجملة
صفة لقوله: ﴿لقوم آخرين﴾ وكذا قوله: ﴿يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم
تؤتوه فاحذروا﴾.
ويتحصل من المجموع أن عدة من اليهود ابتلوا بواقعة دينية فيما بينهم، لها
حكم إلهي عندهم لكن علماءهم غيروا الحكم بعد ثبوته ثم بعثوا طائفة منهم إلى
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمروهم أن يحكموه في الواقعة فإن حكم
بما أنبأهم علماؤهم من الحكم المحرف فليأخذوه وإن حكم بغير ذلك فليحذروا.
وقوله: ﴿ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا﴾ الظاهر أنها معترضة
يبين بها أنهم في أمرهم هذا مفتونون بفتنة إلهية، فلتطب نفس النبي (صلى
الله عليه وآله وسلم) بأن الأمر من الله وإليه وليس يملك منه تعالى شيء في
ذلك، ولا موجب للتحزن فيما لا سبيل إلى التخلص منه.
وقوله: ﴿أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم﴾ فقلوبهم باقية على
قذارتها الأولية لما تكرر منهم من الفسق بعد الفسق فأضلهم الله به، وما يضل
به إلا الفاسقين.
وقوله: ﴿لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم﴾ إيعاد لهم بالخزي في الدنيا وقد فعل بهم، وبالعذاب العظيم في الآخرة.
قوله تعالى: ﴿سماعون للكذب أكالون للسحت﴾ قال الراغب في المفردات:، السحت
القشر الذي يستأصل، قال تعالى: ﴿فيسحتكم بعذاب﴾ وقرىء: فيسحتكم أي بفتح
الياء يقال: سحته وأسحته، ومنه السحت للمحظور الذي يلزم صاحبه العار كأنه
يسحت دينه ومروءته، قال تعالى: ﴿أكالون للسحت﴾ أي لما يسحت دينهم، وقال
(عليه السلام): كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وسمي الرشوة سحتا.انتهى.
فكل مال اكتسب من حرام فهو سحت، والسياق يدل على أن المراد بالسحت في الآية
هو الرشا ويتبين من إيراد هذا الوصف في المقام أن علماءهم الذين بعثوا
طائفة منهم إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كانوا قد أخذوا في الواقعة
رشوة لتحريف حكم الله فقد كان الحكم مما يمكن أن يتضرر به بعضه فسد الباب
بالرشوة، فأخذوا الرشوة وغيروا حكم الله تعالى.
ومن هنا يظهر أن قوله تعالى: ﴿سماعون للكذب أكالون للسحت﴾ باعتبار المجموع
وصف لمجموع القوم، وأما بحسب التوزيع فقوله: ﴿سماعون للكذب﴾ وصف لقوله:
﴿الذين هادوا﴾ وهم المبعوثون إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن في
حكمهم من التابعين، وقوله: ﴿أكالون للسحت﴾ وصف لقوم آخرين، والمحصل أن
اليهود منهم علماء يأكلون الرشا، وعامة مقلدون سماعون لأكاذبيهم.
قوله تعالى: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ إلى آخر الآية تخيير
للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بين أن يحكم بينهم إذا حكموه أو يعرض
عنهم، ومن المعلوم أن اختيار أحد الأمرين لم يكن يصدر منه (صلى الله عليه
وآله وسلم) إلا لمصلحة داعية فيئول إلى إرجاع الأمر إلى نظر النبي (صلى
الله عليه وآله وسلم) ورأيه.
ثم قرر تعالى هذا التخيير بأنه ليس عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) ضرر لو
ترك الحكم فيهم وأعرض عنهم، وبين له أنه لو حكم بينهم فليس له أن يحكم إلا
بالقسط والعدل.
فيعود المضمون بالآخرة إلى أن الله سبحانه لا يرضى أن يجري بينهم إلا حكمه
فإما أن يجري فيهم ذلك أو يهمل أمرهم فلا يجري من قبله (صلى الله عليه وآله
وسلم) حكم آخر.
قوله تعالى: ﴿وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد
ذلك وما أولئك بالمؤمنين﴾ تعجيب من فعالهم أنهم أمة ذات كتاب وشريعة وهم
منكرون لنبوتك وكتابك وشريعتك ثم يبتلون بواقعة في كتابهم حكم الله فيها،
ثم يتولون بعد ما عندهم التوراة فيها حكم الله والحال أن أولئك المبتعدين
من الكتاب وحكمه ليسوا بالذين يؤمنون بذلك.
وعلى هذا المعنى فقوله: ﴿ثم يتولون من بعد ذلك﴾ أي عن حكم الواقعة مع كون
التوراة عندهم وفيها حكم الله، وقوله: ﴿وما أولئك بالمؤمنين﴾ أي بالذين
يؤمنون بالتوراة وحكمها، فهم تحولوا من الإيمان بها وبحكمها إلى الكفر.
ويمكن أن يفهم من قوله: ﴿ثم يتولون﴾، التولي عما حكم به النبي (صلى الله
عليه وآله وسلم) ومن قوله: ﴿وما أولئك بالمؤمنين﴾ نفي الإيمان بالنبي (صلى
الله عليه وآله وسلم) على ما كان يظهر من رجوعهم إليه وتحكيمهم إياه، أو
نفي الإيمان بالتوراة وبالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جميعا، لكن ما
تقدم من المعنى أنسب لسياق الآيات.
وفي الآية تصديق ما للتوراة التي عند اليهود اليوم، وهي التي جمعها لهم
عزراء بإذن ﴿كورش﴾ ملك إيران بعد ما فتح بابل، وأطلق بني إسرائيل من أسر
البابليين وأذن لهم في الرجوع إلى فلسطين وتعمير الهيكل، وهي التي كانت
بيدهم في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهي التي بيدهم اليوم،
فالقرآن يصدق أن فيها حكم الله، وهو أيضا يذكر أن فيها تحريفا وتغييرا.
ويستنتج من الجميع: أن التوراة الموجودة الدائرة بينهم اليوم فيها شيء من
التوراة الأصلية النازلة على موسى (عليه السلام) وأمور حرفت وغيرت إما
بزيادة أو نقصان أو تغيير لفظ أو محل أو غير ذلك، وهذا هو الذي يراه
القرآن في أمر التوراة، والبحث الوافي عنها أيضا يهدي إلى ذلك.
قوله تعالى: ﴿إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون﴾ إلخ بمنزلة التعليل لما ذكر في الآية السابقة، وهي وما بعدها من
الآيات تبين أن الله سبحانه شرع لهذه الأمم على اختلاف عهودهم شرائع، وأودعها في
كتب أنزلها إليهم ليهتدوا بها ويتبصروا بسببها، ويرجعوا إليها فيما
اختلفوا فيه، وأمر الأنبياء والعلماء منهم أن يحكموا بها، ويتحفظوا عليها
ويقوها من التغيير والتحريف، ولا يطلبوا في الحكم ثمنا ليس إلا قليلا، ولا
يخافوا فيها إلا الله سبحانه ولا يخشوا غيره.
وأكد ذلك عليهم وحذرهم اتباع الهوى، وتفتين أبناء الدنيا، وإنما شرع من
الأحكام مختلفا باختلاف الأمم والأزمان ليتم الامتحان الإلهي فإن استعداد
الأزمان مختلف بمرور الدهور، ولا يستكمل المختلفان في الاستعداد شدة وضعفا
بمكمل واحد من التربية العلمية والعملية على وتيرة واحدة.
فقوله: ﴿إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور﴾ أي شيء من الهداية يهتدي بها،
وشيء من النور يتبصر به من المعارف والأحكام على حسب حال بني إسرائيل،
ومبلغ استعدادهم، وقد بين الله سبحانه في كتابه عامة أخلاقهم، وخصوصيات
أحوال شعبهم ومبلغ فهمهم، فلم ينزل إليهم من الهداية إلا بعضها ومن النور
إلا بعضه لسبق عهدهم وقدمة أمتهم، وقلة استعدادهم، قال تعالى: ﴿وكتبنا له
في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء﴾: الأعراف: 154.
وقوله: ﴿يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا﴾ إنما وصف النبيين
بالإسلام وهو التسليم لله، الذي هو الدين عند الله سبحانه للإشارة إلى أن
الدين واحد، وهو الإسلام لله وعدم الاستنكاف عن عبادته، وليس لمؤمن بالله -
وهو مسلم له - أن يستكبر عن قبول شيء من أحكامه وشرائعه.
وقوله: ﴿والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء﴾
أي ويحكم بها الربانيون وهم العلماء المنقطعون إلى الله علما وعملا، أو
الذين إليهم تربية الناس بعلومهم بناء على اشتقاق اللفظ من الرب أو
التربية، والأحبار وهم الخبراء من علمائهم يحكمون بما أمرهم الله به وأراده
منهم أن يحفظوه من كتاب الله، وكانوا من جهة حفظهم له وتحملهم إياه شهداء
عليه لا يتطرق إليه تغيير وتحريف لحفظهم له في قلوبهم، فقوله: ﴿وكانوا عليه
شهداء﴾ بمنزلة النتيجة لقوله: ﴿بما استحفظوا﴾ إلخ أي أمروا بحفظه فكانوا
حافظين له بشهادتهم عليه.
وما ذكرناه من معنى الشهادة هو الذي يلوح من سياق الآية، وربما قيل: إن
المراد بها الشهادة على حكم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الرجم أنه
ثابت في التوراة، وقيل: إن المراد الشهادة على الكتاب أنه من عند الله وحده
لا شريك له، ولا شاهد من جهة السياق يشهد على شيء من هذين المعنيين.
وأما قوله تعالى: ﴿فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا﴾
فهو متفرع على قوله: ﴿إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها﴾، أي لما
كانت التوراة منزلة من عندنا مشتملة على شريعة يقضي بها النبيون والربانيون
والأحبار بينكم فلا تكتموا شيئا منها ولا تغيروها خوفا أو طمعا، أما خوفا
فبأن تخشوا الناس وتنسوا ربكم بل الله فاخشوا حتى لا تخشوا الناس، وأما
طمعا فبأن تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا هو مال أو جاه دنيوي زائل باطل.
ويمكن أن يكون متفرعا على قوله: ﴿بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه
شهداء﴾ بحسب المعنى لأنه في معنى أخذ الميثاق على الحفظ أي أخذنا منهم
الميثاق على حفظ الكتاب وأشهدناهم عليه أن لا يغيروه ولا يخشوا في إظهاره
غيري، ولا يشتروا بآياتي ثمنا قليلا، قال تعالى: ﴿وإذ أخذ الله ميثاق الذين
أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به
ثمنا قليلا﴾: آل عمران: 178 وقال تعالى: ﴿فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب
يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه أ لم
يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه
والدار الآخرة خير للذين يتقون أ فلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا
الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين﴾: الأعراف: 107.
وهذا المعنى الثاني لعله أنسب وأوفق لما يتلوه من التأكيد والتشديد بقوله: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾.
قوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس - إلى قوله والجروح قصاص﴾
السياق وخاصة بالنظر إلى قوله: ﴿والجروح قصاص﴾ يدل على أن المراد به بيان
حكم القصاص في أقسام الجنايات من القتل والقطع والجرح، فالمقابلة الواقعة
في قوله: ﴿النفس بالنفس﴾ وغيره إنما وقعت بين المقتص له والمقتص به والمراد
به أن النفس تعادل النفس في باب القصاص، والعين تقابل العين والأنف الأنف
وهكذا والباء للمقابلة كما في قولك: بعت هذا بهذا.
فيئول معنى الجمل المتسقة إلى أن النفس تقتل بالنفس، والعين تفقأ بالعين
والأنف تجدع بالأنف، والأذن تصلم بالأذن، والسن تقلع بالسن والجروح ذوات
قصاص، وبالجملة أن كلا من النفس وأعضاء الإنسان مقتص بمثله.
ولعل هذا هو مراد من قدر في قوله: ﴿النفس بالنفس﴾ إن النفس مقتصة أو مقتولة
بالنفس وهكذا وإلا فالتقدير بمعزل عن الحاجة، والجمل تامة من دونه والظرف
لغو.
والآية لا تخلو من إشعار بأن هذا الحكم غير الحكم الذي حكموا فيه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتذكره
الآيات السابقة فإن السياق قد تجدد بقوله: ﴿إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور﴾.
والحكم موجود في التوراة الدائرة على ما سيجيء نقله في البحث الروائي التالي إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾ أي فمن عفا من أولياء القصاص كولي
المقتول أو نفس المجني عليه والمجروح عن الجاني، ووهبه ما يملكه من القصاص
فهو أي العفو كفارة لذنوب المتصدق أو كفارة عن الجاني في جنايته.
والظاهر من السياق أن الكلام في تقدير قولنا: فإن تصدق به من له القصاص فهو
كفارة له، وإن لم يتصدق فليحكم صاحب الحكم بما أنزله الله من القصاص، ومن
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
وبذلك يظهر أولا: أن الواو في قوله: ﴿ومن لم يحكم﴾ للعطف على قوله: ﴿من
تصدق﴾ لا للاستيناف كما أن الفاء في قوله: ﴿فمن تصدق﴾ للتفريع: تفريع
المفصل على المجمل، نظير قوله تعالى في آية القصاص: ﴿فمن عفي له من أخيه
شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾: البقرة: 187.
وثانيا: أن قوله: ﴿ومن لم يحكم﴾، من قبيل وضع العلة موضع معلولها والتقدير:
وإن لم يتصدق فليحكم بما أنزل الله فإن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك
هم الظالمون.
قوله تعالى: ﴿وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من
التوراة﴾ التقفية جعل الشيء خلف الشيء وهو مأخوذ من القفا، والآثار جمع أثر
وهو ما يحصل من الشيء مما يدل عليه، ويغلب استعماله في الشكل الحاصل من
القدم ممن يضرب في الأرض، والضمير في ﴿آثارهم﴾ للأنبياء.
فقوله: ﴿وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم﴾ استعارة بالكناية أريد بها
الدلالة على أنه سلك به (عليه السلام) المسلك الذي سلكه من قبله من
الأنبياء، وهو طريق الدعوة إلى التوحيد والإسلام لله.
وقد ذكر بعض المفسرين: أن المراد بقوله: ﴿بإثمي وإثمك﴾ بإثم قتلي إن قتلتني
وإثمك الذي كنت أثمته قبل ذلك كما نقل عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما، أو
أن المراد بإثم قتلي وإثمك الذي لم يتقبل من أجله قربانك كما نقل عن
الجبائي والزجاج، أو أن معناه بإثم قتلي وإثمك الذي هو قتل جميع الناس كما
نقل عن آخرين.
وهذه وجوه ذكروها ليس على شيء منها من جهة اللفظ دليل، ولا يساعد عليه اعتبار.
على أن المقابلة بين الإثمين مع كونهما جميعا للقاتل ثم تسمية أحدهما بإثم المقتول وغيره بإثم القاتل خالية عن الوجه.
قوله تعالى: ﴿فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين﴾ قال الراغب
في مفرداته: الطوع الانقياد ويضاده الكره، والطاعة مثله لكن أكثر ما يقال
في الايتمار لما أمر والارتسام فيما رسم، وقوله: فطوعت له نفسه نحو أسمحت
له قرينته وانقادت له وسولت، وطوعت أبلغ من أطاعت وطوعت له نفسه بإزاء
قولهم: تابت عن كذا نفسه. انتهى ملخصا.
وليس مراده أن طوعت مضمن معنى انقادت أو سولت بل يريد أن التطويع يدل على
التدريج كالإطاعة على الدفعة، كما هو الغالب في بابي الإفعال والتفعيل
فالتطويع في الآية اقتراب تدريجي للنفس من الفعل بوسوسة بعد وسوسة وهمامة
بعد همامة تنقاد لها حتى تتم لها الطاعة الكاملة فالمعنى: انقادت له نفسه
وأطاعت أمره إياها بقتل أخيه طاعة تدريجية، فقوله: ﴿قتل أخيه﴾ من وضع
المأمور به موضع الأمر كقولهم: أطاع كذا في موضع: أطاع الأمر بكذا.
وربما قيل: إن قوله: طوعت بمعنى زينت فقوله: ﴿قتل أخيه﴾ مفعول به، وقيل:
بمعنى طاوعت أي طاوعت له نفسه في قتل أخيه، فالقتل منصوب بنزع الخافض،
ومعنى الآية ظاهر.
وربما استفيد من قوله: ﴿فأصبح من الخاسرين﴾ أنه إنما قتله ليلا، وفيه كما
قيل: إن أصبح - وهو مقابل أمسى - وإن كان بحسب أصل معناه يفيد ذلك لكن عرف
العرب يستعمله بمعنى صار من غير رعاية أصل اشتقاقه، وفي
القرآن شيء كثير من هذا القبيل كقوله: ﴿فأصبحتم بنعمته إخوانا﴾: آل عمران: 130
وقوله: ﴿فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين﴾: المائدة: 52 فلا سبيل إلى
إثبات إرادة المعنى الأصلي في المقام.
قوله تعالى: ﴿فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه﴾
البحث طلب الشيء في التراب ثم يقال: بحثت عن الأمر بحثا كذا في المجمع، .
والمواراة: الستر، ومنه التواري للتستر، والوراء لما خلف الشيء.
والسوأة ما يتكرهه الإنسان.
والويل الهلاك.
ويا ويلتا كلمة تقال عند الهلكة، والعجز مقابل الاستطاعة.
والآية بسياقها تدل على أن القاتل قد كان بقي زمانا على تحير من أمره، وكان
يحذر أن يعلم به غيره، ولا يدري كيف الحيلة إلى أن لا يظفروا بجسده حتى
بعث الله الغراب، ولو كان بعث الغراب وبحثه وقتله أخاه متقاربين لم يكن وجه
لقوله: ﴿يا ويلتا أ عجزت أن أكون مثل هذا الغراب﴾. وكذا المستفاد من
السياق أن الغراب دفن شيئا في الأرض بعد البحث فإن ظاهر الكلام أن الغراب
أراد إراءة كيفية المواراة لا كيفية البحث، ومجرد البحث ما كان يعلمه كيفية
المواراة وهو في سذاجة الفهم بحيث لم ينتقل ذهنه بعد إلى معنى البحث، فكيف
كان ينتقل من البحث إلى المواراة ولا تلازم بينهما بوجه؟ فإنما انتقل إلى
معنى المواراة بما رأى أن الغراب بحث في الأرض ثم دفن فيها شيئا.
والغراب من بين الطير من عادته أنه يدخر بعض ما اصطاده لنفسه بدفنه في
الأرض وبعض ما يقتات بالحب ونحوه من الطير وإن كان ربما بحث في الأرض لكنه
للحصول على مثل الحبوب والديدان لا للدفن والإدخار.
وما تقدم من إرجاع ضمير الفاعل في ﴿ليريه﴾ إلى الغراب هو الظاهر من الكلام
لكونه هو المرجع القريب، وربما قيل: إن الضمير راجع إلى الله سبحانه، ولا
بأس به لكنه لا يخلو عن شيء من البعد، والمعنى صحيح على التقديرين، وأما
قوله: ﴿قال يا ويلتا أ عجزت أن أكون مثل هذا الغراب﴾، فإنما قاله لأنه
استسهل ما رأى من حيلة الغراب للمواراة فإنه وجد نفسه تقدر على إتيان مثل
ما أتى به الغراب من البحث ثم التوسل به إلى المواراة لظهور الرابطة بين
البحث والمواراة، وعند ذلك تأسف على ما فاته من الفائدة، وندم على إهماله
في التفكر في التوسل إلى المواراة حتى يستبين له أن البحث هو الوسيلة
القريبة إليه، فأظهر هذه الندامة بقوله: ﴿يا ويلتا أ عجزت أن أكون مثل هذا
الغراب فأواري سوأة أخي﴾ وهو تخاطب جار بينه وبين نفسه على طريق الاستفهام
الإنكاري، والتقدير أن يستفهم منكرا: أ عجزت أن تكون مثل هذا الغراب فتواري
سوأة أخيك؟ فيجاب: لا.
ثم يستفهم ثانيا استفهاما إنكاريا فيقال: فلم غفلت عن ذلك ولم تتوسل إليها
بهذه الوسيلة على ظهورها وأشقيت نفسك في هذه المدة من غير سبب؟ ولا جواب عن
هذه المسألة، وفيه الندامة فإن الندامة تأثر روحي خاص من الإنسان وتألم
باطني يعرضه من مشاهدته إهماله شيئا من الأسباب المؤدية إلى فوت منفعة أو
حدوث مضرة، وإن شئت فقل هي تأثر الإنسان العارض له من تذكره إهماله في
الاستفادة من إمكان من الإمكانات.
وهذا حال الإنسان إذا أتى من المظالم بما يكره أن يطلع عليه الناس فإن هذه
أمور لا يقبلها المجتمع بنظامه الجاري فيه، المرتبط بعض أجزائه ببعض فلا بد
أن يظهر أثر هذه الأمور المنافية له وإن خفيت على الناس في أول حدوثها،
والإنسان الظالم المجرم يريد أن يجبر النظام على قبوله وليس بقابل نظير أن
يأكل الإنسان أو يشرب شيئا من السم وهو يريد أن يهضمه جهاز هضمه وليس
بهاضم، فهو وإن أمكن وروده في باطنه لكن له موعدا لن يخلفه ومرصدا لن
يتجاوزه، وإن ربك لبالمرصاد.
وعند ذلك يظهر للإنسان نقص تدبيره في بعض ما كان يجب عليه مراقبته ورعايته
فيندم لذلك، ولو عاد فأصلح هذا الواحد فسد آخر ولا يزال الأمر على ذلك حتى
يفضحه الله على رءوس الأشهاد.
وقد اتضح بما تقدم من البيان: أن قوله: ﴿فأصبح من النادمين﴾ إشارة إلى
ندامته على عدم مواراته سوأة أخيه، وربما أمكن أن يقال: إن المراد به ندمه
على أصل القتل وليس ببعيد.
كلام في معنى الإحساس والتفكير:
هذا الشطر من قصة ابني آدم أعني قوله تعالى: ﴿فبعث الله غرابا يبحث في
الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه قال يا ويلتا أ عجزت أن أكون مثل هذا
الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين﴾ آية واحدة في
القرآن لا نظيرة لها من نوعها وهي تمثل حال الإنسان في الانتفاع بالحس، وأنه
يحصل خواص الأشياء من ناحية الحس، ثم يتوسل بالتفكر فيها إلى أغراضه
ومقاصده في الحياة على نحو ما يقضي به البحث العلمي أن علوم الإنسان
ومعارفه تنتهي إلى الحس خلافا للقائلين بالتذكر والعلم الفطري.
وتوضيحه أنك إذا راجعت الإنسان فيما عنده من الصور العلمية من تصور أو
تصديق جزئي أو كلي وبأي صفة كانت علومه وإدراكاته وجدت عنده وإن كان من
أجهل الناس وأضعفهم فهما وفكرا صورا كثيرة وعلوما جمة لا تكاد تنالها يد
الإحصاء بل لا يحصيها إلا رب العالمين.
ومن المشهود من أمرها على كثرتها وخروجها عن طور الإحصاء والتعديد أنها لا
تزال تزيد وتنمو مدة الحياة الإنسانية في الدنيا، ولو تراجعنا القهقرى
وجدناها تنقص ثم تنقص حتى تنتهي إلى الصفر، وعاد الإنسان وما عنده شيء من
العلم بالفعل قال تعالى: ﴿علم الإنسان ما لم يعلم﴾: العلق: 5.
وليس المراد بالآية أنه تعالى يعلمه ما لم يعلم وأما ما علمه فهو فيه في
غنى عن تعليم ربه فإن من الضروري أن العلم في الإنسان أيا ما كان هو
لهدايته إلى ما يستكمل به في وجوده وينتفع به في حياته، والذي تسير إليه
أقسام الأشياء غير الحية بالانبعاثات الطبيعية تسير وتهتدي أقسام الموجودات
الحية - ومنها الإنسان - إليه بنور العلم فالعلم من مصاديق الهدى.
وقد نسب الله سبحانه مطلق الهداية إلى نفسه حيث قال: ﴿الذي أعطى كل شيء
خلقه ثم هدى﴾: طه: 50 وقال: ﴿الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى﴾: الأعلى: 3
وقال وهو بوجه من الهداية بالحس والفكر: ﴿أمن يهديكم في ظلمات البر
والبحر﴾: النمل: 63 وقد مر شطر من الكلام في معنى الهداية في بعض المباحث
السابقة، وبالجملة لما كان كل علم هداية وكل هداية فهي من الله كان كل علم
للإنسان بتعليمه تعالى.
ويقرب من قوله: ﴿علم الإنسان ما لم يعلم﴾ قوله: ﴿والله أخرجكم من بطون
أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة﴾: النحل: 78.
والتأمل في حال الإنسان والتدبر في
الآيات الكريمة يفيدان أن علم الإنسان النظري أعني العلم بخواص الأشياء وما
يستتبعه من المعارف العقلية يبتدىء من الحس فيعلمه الله من طريقه خواص
الأشياء كما يدل عليه قوله: ﴿فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف
يواري سوأة أخيه﴾ الآية.
فنسبة بعث الغراب لإراءة كيفية المواراة إلى الله سبحانه نسبة تعليم كيفية
المواراة إليه تعالى بعينه فالغراب وإن كان لا يشعر بأن الله سبحانه هو
الذي بعثه، وكذلك ابن آدم لم يكن يدري أن هناك مدبرا يدبر أمر تفكيره
وتعلمه، وكانت سببية الغراب وبحثه بالنسبة إلى تعلمه بحسب النظر الظاهري
سببية اتفاقية كسائر الأسباب الاتفاقية التي تعلم الإنسان طرق تدبير المعاش
والمعاد، لكن الله سبحانه هو الذي خلق الإنسان وساقه إلى كمال العلم لغاية
حياته، ونظم الكون نوع نظم يؤديه إلى الاستكمال بالعلم بأنواع من التماس
والتصاك تقع بينه وبين أجزاء الكون، فيتعلم بها الإنسان ما يتوسل به إلى
أغراضه ومقاصده من الحياة فالله سبحانه هو الذي يبعث الغراب وغيره إلى عمل
يتعلم به الإنسان شيئا فهو المعلم للإنسان.
ولهذا المعنى نظائر في
القرآن كقوله تعالى: ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله﴾:
المائدة: 4 عد ما علموه وعلموه مما علمهم الله وإنما تعلموه من سائر الناس
أو ابتكروه بأفكار أنفسهم، وقوله: ﴿واتقوا الله ويعلمكم الله﴾: البقرة: 228
وإنما كانوا يتعلمونه من الرسول، وقوله: ﴿ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه
الله﴾: البقرة: 228 وإنما تعلم الكاتب ما علمه بالتعلم من كاتب آخر مثله
إلا أن جميع ذلك أمور مقصودة في الخلق والتدبير فما حصل من هذه الأسباب من
فائدة العلم الذي يستكمل به الإنسان فالله سبحانه هو معلمه بهذه الأسباب
كما أن المعلم من الإنسان يعلم بالقول والتلقين، والكاتب من الإنسان يعلم
غيره بالقول والقلم مثلا.
وهذا هو السبيل في جميع ما يسند إليه تعالى في عالم الأسباب فالله تعالى هو
خالقه وبينه وبين مخلوقة أسباب هي الأسباب بحسب الظاهر وهي أدوات وآلات
لوجود الشيء، وإن شئت فقل: هي من شرائط وجود الشيء الذي تعلق وجوده من جميع
جهاته وأطرافه بالأسباب، فمن شرائط وجود زيد ﴿الذي ولده عمرو وهند﴾ أن
يتقدمه عمرو وهند وازدواج وتناكح بينهما، وإلا لم يوجد زيد المفروض، ومن
شرائط ﴿الإبصار بالعين الباصرة﴾ أن تكون قبله عين باصرة، وهكذا.
فمن زعم أنه يوحد الله سبحانه بنفي الأسباب وإلغائها، وقدر أن ذلك أبلغ في
إثبات قدرته المطلقة ونفي العجز عنه، وزعم أن إثبات ضرورة تخلل الأسباب قول
بكونه تعالى مجبرا على سلوك سبيل خاص في الإيجاد فاقدا للاختيار فقد ناقض
نفسه من حيث لا يشعر.
وبالجملة فالله سبحانه هو الذي علم الإنسان خواص الأشياء التي تنالها حواسه
نوعا من النيل، علمه إياها من طريق الحواس، ثم سخر له ما في الأرض والسماء
جميعا، قال تعالى: ﴿وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه﴾:
الجاثية: 13.
وليس هذا التسخير إلا لأن يتوسل بنوع من التصرف فيها إلى بلوغ أغراضه
وأمانيه في الحياة أي أنه جعلها مرتبطة بوجوده لينتفع بها، وجعله متفكرا
يهتدي إلى كيفية التصرف والاستعمال والتوسل، ومن الدليل على ذلك قوله
تعالى: ﴿أ لم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره﴾:
الحج: 65، وقوله تعالى: ﴿وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون﴾: الزخرف:
12، وقوله تعالى: ﴿عليها وعلى الفلك تحملون﴾: غافر: 80 وغير ذلك من
الآيات المشابهة لها فانظر إلى لسان
الآيات كيف نسبت جعل الفلك إلى الله سبحانه وهو من صنع الإنسان، ثم نسب الحمل
إليه تعالى وهو من صنع الفلك والأنعام ونسب جريانها في البحر إلى أمره وهو
مستند إلى جريان البحر أو هبوب الريح أو البخار ونحوه، وسمي ذلك كله تسخيرا
منه للإنسان لما أن لإرادته نوع حكومة في الفلك وما يناظرها من الأنعام
وفي الأرض والسماء تسوقها إلى الغايات المطلوبة له.
وبالجملة هو سبحانه أعطاه الفكر على الحس ليتوسل به إلى كماله المقدر له
بسبب علومه الفكرية الجارية في التكوينيات أعني العلوم النظرية.
قال تعالى: ﴿وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون﴾: النحل: 78
وأما العلوم العملية وهي التي تجري فيما ينبغي أن يعمل وما لا ينبغي فإنما
هي بإلهام من الله سبحانه من غير أن يوجدها حس أو عقل نظري، قال تعالى:
﴿ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من
دساها﴾: الشمس: 10 وقال: ﴿فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس
عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم﴾: الروم: 30 فعد العلم بما ينبغي
فعله وهو الحسنة وما لا ينبغي فعله وهو السيئة مما يحصل له بالإلهام
الإلهي وهو القذف في القلب.
فجميع ما يحصل للإنسان من العلم إنما هي هداية إلهية وبهداية إلهية، غير
أنها مختلفة بحسب النوع: فما كان من خواص الأشياء الخارجية فالطريق الذي
يهدي به الله سبحانه الإنسان هو طريق الحس، وما كان من العلوم الكلية
الفكرية فإنما هي بإعطاء وتسخير إلهي من غير أن يبطله وجود الحس أو يستغني
الإنسان عنها في حال من الأحوال، وما كان من العلوم العملية المتعلقة بصلاح
الأعمال وفسادها وما هو تقوى أو فجور فإنما هي بإلهام إلهي بالقذف في
القلوب وقرع باب الفطرة.
والقسم الثالث الذي يرجع بحسب الأصل إلى إلهام إلهي إنما ينجح في عمله ويتم
في أثره إذا صلح القسم الثاني ونشأ على صحة واستقامة كما أن العقل أيضا
إنما يستقيم في عمله إذا استقام الإنسان في تقواه ودينه الفطري، قال تعالى:
﴿وما يذكر إلا أولوا الألباب﴾: آل عمران: 7 وقال تعالى: ﴿وما يتذكر إلا من
ينيب﴾: غافر: 13 وقال تعالى: ﴿ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به
أول مرة﴾: الأنعام: 101 وقال تعالى: ﴿ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه
نفسه﴾: البقرة: 103 أي لا يترك مقتضيات الفطرة إلا من فسد عقله فسلك غير
سبيله.
والاعتبار يساعد هذا التلازم الذي بين العقل والتقوى، فإن الإنسان إذا أصيب
في قوته النظرية فلم يدرك الحق حقا أو لم يدرك الباطل باطلا فكيف يلهم
بلزوم هذا أو اجتناب ذاك؟ كمن يرى أن ليس وراء الحياة المادية المعجلة شيء
فإنه لا يلهم التقوى الديني الذي هو خير زاد للعيشة الآخرة.
وكذلك الإنسان إذا فسد دينه الفطري ولم يتزود من التقوى الديني لم تعتدل
قواه الداخلية المحسة من شهوة أو غضب أو محبة أو كراهة وغيرها، ومع اختلال
أمر هذه القوى لا تعمل قوة الإدراك النظرية عملها عملا مرضيا.
والبيانات القرآنية تجري في بث المعارف الدينية وتعليم الناس العلم النافع
هذا المجرى، وتراعي الطرق المتقدمة التي عينتها للحصول على المعلومات، فما
كان من الجزئيات التي لها خواص تقبل الإحساس فإنها تصريح فيها إلى الحواس
كالآيات المشتملة على قوله: ﴿أ لم تر أ فلا يرون أ فرأيتم، أ فلا تبصرون﴾
وغير ذلك وما كان من الكليات العقلية مما يتعلق بالأمور الكلية المادية أو
التي هي وراء عالم الشهادة فإنها تعتبر فيها العقل اعتبارا جازما وإن كانت
غائبة عن الحس خارجة عن محيط المادة والماديات، كغالب
الآيات الراجعة إلى المبدأ والمعاد المشتملة على أمثال قوله: ﴿لقوم يعقلون﴾،
لقوم يتفكرون﴾، لقوم يتذكرون﴾، يفقهون﴾، وغيرها، وما كان من القضايا
العملية التي لها مساس بالخير والشر والنافع والضار في العمل والتقوى
والفجور فإنها تستند فيها إلى الإلهام الإلهي بذكر ما بتذكره يشعر الإنسان
بإلهامه الباطني كالآيات المشتملة على مثل قوله: ﴿ذلكم خير لكم، فإنه آثم
قلبه، فيهما إثم، والإثم والبغي بغير الحق، إن الله لا يهدي﴾ وغيرها، وعليك
بالتدبر فيها.
ومن هنا يظهر أولا: أن
القرآن الكريم يخطىء طريق الحسيين وهم المعتمدون على الحس والتجربة، النافون
للأحكام العقلية الصرفة في الأبحاث العلمية، وذلك أن أول ما يهتم
القرآن به في بيانه هو أمر توحيد الله عز اسمه، ثم يرجع إليه ويبتنى عليه جميع المعارف الحقيقية التي يبينها ويدعو إليها.
ومن المعلوم أن التوحيد أشد المسائل ابتعادا من الحس، وبينونة للمادة وارتباطا بالأحكام العقلية الصرفة.
والقرآن يبين أن هذه المعارف الحقيقية من الفطرة قال: ﴿فأقم وجهك للدين
حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله﴾: الروم: 30 أي
إن الخلقة الإنسانية نوع من الإيجاد يستتبع هذه العلوم والإدراكات، ولا
معنى لتبديل خلق إلا أن يكون نفس التبديل أيضا من الخلق والإيجاد، وأما
تبديل الإيجاد المطلق أي إبطال حكم الواقع فلا يتصور له معنى فلن يستطيع
الإنسان، وحاشا ذلك أن يبطل علومه الفطرية، ويسلك في الحياة سبيلا آخر غير
سبيلها البتة، وأما الانحراف المشهود عن أحكام الفطرة فليس إبطالا لحكمها
بل استعمالا لها في غير ما ينبغي من نحو الاستعمال نظير ما ربما يتفق أن
الرامي لا يصيب الهدف في رميته فإن آلة الرمي وسائر شرائطه موضوعة بالطبع
للإصابة إلا أن الاستعمال يوقعها في الغلط، والسكاكين والمناشير والمثاقب
والإبر وأمثالها إذا عبئت في الماكينات تعبئة معوجة تعمل عملها الذي فطرت
عليه بعينه من قطع أو نشر أو ثقب وغير ذلك لكن لا على الوجه المقصود، وأما
الانحراف عن العمل الفطري كان يخاط بنشر المنشار، بأن يعوض المنشار فعل
الإبرة من فعل نفسه، فيضع الخياطة موضع النشر، فمن المحال ذلك.
وهذا ظاهر لمن تأمل عامة ما استدل به القوم على صحة طريقهم كقولهم: إن
الأبحاث العقلية المحضة، والقياسات المؤلفة من مقدمات بعيدة من الحس يكثر
وقوع الخطإ فيها كما يدل عليه كثرة الاختلافات في المسائل العقلية المحضة
فلا ينبغي الاعتماد عليها لعدم اطمينان النفس إليها.
وقولهم في الاستدلال على صحة طريق الحس والتجربة: أن الحس آلة لنيل خواص
الأشياء بالضرورة وإذا أحس بأثر في موضوع من الموضوعات على شرائط مخصوصة ثم
تكرر مشاهدة الأثر معه مع حفظ تلك الشرائط بعينها من غير تخلف واختلاف كشف
ذلك عن أن هذا الأثر خاصة الموضوع من غير اتفاق لأن الاتفاق لا يدوم
البتة.
والدليلان كما ترى سيقا لإثبات وجوب الاعتماد على الحس والتجربة ورفض
السلوك العقلي المحض مع كون المقدمات المأخوذة فيهما جميعا مقدمات عقلية
خارجة عن الحس والتجربة ثم أريد بالأخذ بهذه المقدمات العقلية إبطال الأخذ
بها، وهذا هو الذي تقدم أن الفطرة لن تبطل البتة وإنما يغلط الإنسان في
كيفية استعمالها!.
وأفحش من ذلك استعمال التجربة في تشخيص الأحكام المشرعة والقوانين الموضوعة
كأن يوضع حكم ثم يجري بين الناس يختبر بذلك حسن أثره بإحصاء ونحوه فإن غلب
على موارد جريانه حسن النتيجة أخذ حكما ثابتا جاريا وإلا ألقى في جانب
وأخذ آخر كذلك وهكذا، ونظيره فيه جعل الحكم بقياس أو استحسان.
والقرآن يبطل ذلك كله بإثبات أن الأحكام المشرعة فطرية بينة، والتقوى
والفجور العامين إلهاميان علميان، وأن تفاصيلها مما يجب أخذه من ناحية
الوحي، قال تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾: إسراء: 36 وقال: ﴿ولا
تتبعوا خطوات الشيطان﴾: البقرة: 186 والقرآن يسمى الشريعة المشرعة حقا قال
تعالى: ﴿أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه﴾:
البقرة: 231 وقال: ﴿وإن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾: النجم: 28 وكيف يغني
وفي اتباعه مخافة الوقوع في خطر الباطل وهو الضلال؟ قال: ﴿فما ذا بعد الحق
إلا الضلال﴾: يونس: 32 وقال: ﴿فإن الله لا يهدي من يضل﴾: النحل: 37 أي إن
الضلال لا يصلح طريقا يوصل الإنسان إلى خير وسعادة فمن أراد أن يتوسل بباطل
إلى حق أو بظلم إلى عدل أو بسيئة إلى حسنة أو بفجور إلى تقوى فقد أخطأ
الطريق، وطمع من الصنع والإيجاد الذي هو الأصل للشرائع والقوانين فيما لا
يسمح له بذلك البتة، ولو أمكن ذلك لجرى في خواص الأشياء المتضادة، وتكفل
أحد الضدين ما هو من شأن الآخر من العمل والأثر.
وكذلك
القرآن يبطل طريق التذكر الذي فيه إبطال السلوك العلمي الفكري وعزل منطق الفطرة، وقد تقدم الكلام في ذلك.
وكذلك
القرآن يحظر على الناس التفكر من غير مصاحبة تقوى الله سبحانه، وقد تقدم الكلام فيه أيضا في الجملة، ولذلك ترى
القرآن فيما يعلم من شرائع الدين يشفع الحكم الذي يبينه بفضائل أخلاقية وخصال
حميدة تستيقظ بتذكرها في الإنسان غريزة تقواه، فيقوى على فهم الحكم وفقهه،
واعتبر ذلك في أمثال قوله تعالى: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان
منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا
تعلمون﴾: البقرة: 223 وقوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين
لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين﴾: البقرة: 139 وقوله تعالى:
﴿وأقم الصلوة إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله
يعلم ما تصنعون﴾: العنكبوت: 45.
قوله تعالى: ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس
أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس
جميعا﴾ في المجمع:، الأجل في اللغة الجناية، انتهى.
وقال الراغب في المفردات:، الأجل الجناية التي يخاف منها آجلا، فكل أجل جناية وليس كل جناية أجلا.
يقال: فعلت ذلك من أجله، انتهى.
ثم استعمل للتعليل، يقال: فعلته من أجل كذا أي إن كذا سبب فعلي، ولعل
استعمال الكلمة في التعليل ابتدأ أولا في مورد الجناية والجريرة كقولنا:
أساء فلان ومن أجل ذلك أدبته بالضرب أي إن ضربي ناش من جنايته وجريرته التي
هي إساءته أو من جناية هي إساءته، ثم أرسلت كلمة تعليل فقيل: أزورك من أجل
حبي لك ولأجل حبي لك.
وظاهر السياق أن الإشارة بقوله: ﴿من أجل ذلك﴾ إلى نبأ ابني آدم المذكور في
الآيات السابقة أي إن وقوع تلك الحادثة الفجيعة كان سببا لكتابتنا على بني
إسرائيل كذا وكذا، وربما قيل: إن قوله: ﴿من أجل ذلك﴾ متعلق بقوله في الآية
السابقة: ﴿فأصبح من النادمين﴾ أي كان ذلك سببا لندامته، وهذا القول وإن كان
في نفسه غير بعيد كما في قوله تعالى: ﴿كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم
تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى﴾ الآية: البقرة: 202 إلا أن
لازم ذلك كون قوله: ﴿كتبنا على بني إسرائيل﴾ إلخ مفتتح الكلام والمعهود من
السياقات القرآنية أن يؤتى في مثل ذلك بواو الاستيناف كما في آية البقرة
المذكورة آنفا وغيرها.
وأما وجه الإشارة في قوله: ﴿من أجل ذلك﴾ إلى قصة