•
الآيات 68-86
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّىَ تُقِيمُواْ
التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ
وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ
طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿68﴾
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ
وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحًا
فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿69﴾ لَقَدْ أَخَذْنَا
مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلَّمَا
جَاءهُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ
وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿70﴾ وَحَسِبُواْ أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ
فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ اللّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ
وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿71﴾
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ
مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ
رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ
عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ
أَنصَارٍ ﴿72﴾ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ
ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ
عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿73﴾ أَفَلاَ يَتُوبُونَ إلى اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّهُ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿74﴾ مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ
خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلاَنِ
الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى
يُؤْفَكُونَ ﴿75﴾ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ
لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا وَاللّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿76﴾
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ
وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ
كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِيلِ ﴿77﴾ لُعِنَ الَّذِينَ
كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ
مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿78﴾ كَانُواْ لاَ
يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ
﴿79﴾ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ
مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي
الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿80﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالله
والنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء
وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿81﴾ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ
النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ
أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ
الَّذِينَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ
وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿82﴾ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا
أُنزِلَ إلى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا
عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ
الشَّاهِدِينَ ﴿83﴾ وَمَا لَنَا لاَ نُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا جَاءنَا مِنَ
الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ
الصَّالِحِينَ ﴿84﴾ فَأَثَابَهُمُ اللّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء
الْمُحْسِنِينَ ﴿85﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا
أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿86﴾
بيان:
الآيات في نفسها تقبل الاتصال والاتساق بحسب النظم، ولا تقبل الاتصال بقوله
تعالى: ﴿ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل﴾ الآية مع الغض عن قوله تعالى:
﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك﴾ الآية وأما ارتباط قوله تعالى:
﴿يا أيها الرسول بلغ﴾ الآية فقد عرفت الكلام فيه.
والأشبه أن يكون هذه
الآيات جارية على سياق
الآيات السابقة من أوائل السورة إلى هنا أعني ارتباط مضامين
الآيات آخذة من قوله تعالى: ﴿ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا﴾: الآية - 12 من السورة إلى آخر هذه
الآيات المبحوث عنها باستثناء نزرة مما تتخللها كآية الولاية وآية التبليغ
وغيرهما مما تقدم البحث عنه، ومثله الكلام في اتصال آيات آخر السورة بهذه
الآيات فإنها جميعا يجمعها أنها كلام يتعلق بشأن أهل الكتاب.
قوله تعالى: ﴿قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل﴾
إلى آخر الآية، الإنسان يجد من نفسه خلال أعماله أنه إذا أراد إعمال قوة
وشدة فيما يحتاج إلى ذلك، وجب أن يعتمد على مستوى يستوي عليه أو يتصل به
كمن أراد أن يجذب أو يدفع أو يحمل أو يقيم شيئا ثقيلا فإنه يثبت قدميه على
الأرض أولا ثم يصنع ما شاء لما يعلم أن لو لا ذلك لم يتيسر له ما يريد، وقد
بحث عنه في العلوم المربوطة به.
وإذا أجرينا هذا المعنى في الأمور المعنوية كأفعال الإنسان الروحية أو ما
يتعلق من أفعال الجوارح بالأمور النفسية كان ذلك منتجا أن صدور مهام
الأفعال وعظائم الأعمال يتوقف على أس معنوي ومبنى قوى نفسي كتوقف جلائل
الأمور على الصبر والثبات وعلو الهمة وقوة العزيمة وتوقف النجاح في
العبودية على حق التقوى والورع عن محارم الله.
ومن هنا يظهر أن قوله تعالى: ﴿لستم على شيء﴾ كناية عن عدم اعتمادهم على شيء
يثبت عليه أقدامهم فيقدروا بذلك على إقامة التوراة والإنجيل وما أنزل
إليهم من ربهم تلويحا إلى أن دين الله وحكمه لها من الثقل ما لا يتيسر حمله
للإنسان حتى يعتمد على أساس ثابت ولا يمكنه إقامته بمجرد هوى من نفسه كما
يشير تعالى إلى ذلك بالنسبة إلى
القرآن الكريم بقوله: ﴿إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا﴾: المزمل: 5، وقوله: ﴿لو أنزلنا هذا
القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس
لعلهم يتفكرون﴾: الحشر: 21، وقوله: ﴿إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها﴾ الآية: الأحزاب: 72.
وقال في أمر التوراة خطابا لموسى (عليه السلام): ﴿فخذها بقوة وأمر قومك
يأخذوا بأحسنها﴾: الأعراف: 154، وقال خطابا لبني إسرائيل: ﴿خذوا ما آتيناكم
بقوة﴾: البقرة: 63 وقال خطابا ليحيى (عليه السلام): ﴿يا يحيى خذ الكتاب
بقوة﴾: مريم: 12.
فيعود المعنى إلى أنكم فاقدوا العماد الذي يجب عليكم أن تعتمدوا عليه في
إقامة دين الله الذي أنزل إليكم في كتبه وهو التقوى والإنابة إلى الله
بالرجوع إليه مرة بعد أخرى والاتصال به والإيواء إلى ركنه بل مستكبرون عن
طاعته ومتعدون حدوده.
ويظهر هذا المعنى من قوله تعالى خطابا لنبيه والمؤمنين: ﴿شرع لكم من الدين
ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى﴾ فجمع
الدين كله فيما ذكره، ثم قال: ﴿أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه﴾ فبين أن
ذلك كله يرجع إلى إقامة الدين كلمة واحدة من غير تفرق ثم قال: ﴿كبر على
المشركين ما تدعوهم إليه﴾ وذلك لكبر الاتفاق والاستقامة في اتباع الدين
عليهم، ثم قال: ﴿الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب﴾ فأنبأ أن
إقامة الدين لا يتيسر إلا بهداية من الله، ولا يصلح لها إلا المتصف
بالإنابة التي هي الاتصال بالله وعدم الانقطاع عنه بالرجوع إليه مرة بعد
أخرى، ثم قال: ﴿وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم﴾ فذكر أن
السبب في تفرقهم وعدم إقامتهم للدين هو بغيهم وتعديهم عن الوسط العدل
المضروب لهم الشورى: 14.
وقال أيضا في نظيرتها من الآيات: ﴿فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي
فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا
يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون﴾: الروم: 32 فذكر
فيها أيضا أن الوسيلة إلى إقامة دين الفطرة الإنابة إلى الله، وحفظ الاتصال
بحضرته، وعدم الانقطاع عن سببه.
وقد أشار إلى هذه الحقيقة في
الآيات السابقة على هذه الآية المبحوث عنها أيضا حيث ذكر أن الله لعن اليهود
وغضب عليهم لتعديهم حدوده فألقى بينهم العداوة والبغضاء، وذكر هذا المعنى
في غير هذا المورد في خصوص النصارى بقوله: ﴿فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء
إلى يوم القيامة﴾: المائدة: 14.
وقد حذر الله سبحانه المسلمين عن مثل هذه المصيبة المؤلمة التي سيحلها على
أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأنبأهم أنهم لا يتيسر ولن يتيسر لهم إقامة
التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، وقد صدق جريان التاريخ ما أخبر
به الكتاب من تشتت المذاهب فيهم وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم، فحذر الأمة
الإسلامية أن يردوا موردهم في الانقطاع عن ربهم، وعدم الإنابة إليه في
قوله: ﴿وأقم وجهك للدين حنيفا﴾: الروم: 30 في عدة آيات من السورة.
وقد تقدم البحث عن بعض
الآيات الملوحة إلى ذلك في ما تقدم من أجزاء الكتاب وسيأتي الكلام على بعض آخر منها إن شاء الله تعالى.
وأما قوله تعالى: ﴿وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا﴾
فقد تقدم البحث عن معناه، وقوله: ﴿فلا تأس على القوم الكافرين﴾ تسلية منه
تعالى لنبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) في صورة النهي عن الأسى.
قوله تعالى: ﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى﴾ الآية
ظاهرها أن الصابئون عطف على ﴿الذين آمنوا﴾ بحسب موضعه وجماعة من النحويين
يمنعون العطف على اسم إن بالرفع قبل مضي الخبر، والآية حجة عليهم.
والآية في مقام بيان أن لا عبرة في باب السعادة بالأسماء والألقاب كتسمي
جمع بالمؤمنين وفرقة بالذين هادوا، وطائفة بالصابئين وآخرين بالنصارى،
وإنما العبرة بالإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، وقد تقدم البحث
عن معنى الآية في
تفسير سورة البقرة الآية 62 في الجزء الأول من الكتاب.
قوله تعالى: ﴿لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا﴾ إلى آخر
الآية هذه الآية وما بعدها إلى عدة آيات تتعرض لحال أهل الكتاب كالحجة على
ما يشتمل عليه قوله تعالى: ﴿قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا
التوراة والإنجيل﴾ إلخ، فإن هذه الجرائم والآثام لا تدع للإنسان اتصالا
بربه حتى يقيم كتب الله معتمدا عليه.
ويحتمل أن تكون
الآيات مرتبطة بقوله: ﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا﴾ إلخ، فيكون تصديقا بأن
الأسماء والألقاب لا تنفع شيئا في مرحلة السعادة إذ لو نفعت لصدت هؤلاء عن
قتل الأنبياء وتكذيبهم والهلاك بمهلكات الفتن وموبقات الذنوب.
ويمكن أن يكون هذه
الآيات كالمبينة لقوله: ﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا﴾ إلخ، وهو كالمبين لقوله: ﴿يا أهل الكتاب لستم على شيء﴾ الآية والمعنى ظاهر.
وقوله: ﴿فريقا كذبوا وفريقا يقتلون﴾ الظاهر أن كلمتي ﴿فريقا﴾ في الموضعين
مفعولان للفعلين بعدهما قدما عليهما للعناية بأمرهما، والتقدير: كذبوا
فريقا ويقتلون فريقا، والمجموع جواب قوله: ﴿كلما جاءهم﴾ إلخ، والمعنى نحو
من قولنا: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم أساءوا مواجهته وإجابته
وجعلوا الرسل الآتين فريقين: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
قال في المجمع: فإن قيل: لم عطف المستقبل على الماضي يعني في قوله: ﴿فريقا
كذبوا وفريقا يقتلون﴾؟ فجوابه: ليدل على أن ذلك من شأنهم ففيه معنى كذبوا
وقتلوا ويكذبون ويقتلون مع أن قوله: ﴿يقتلون﴾ فأصله يجب أن يكون موافقا
لرءوس الآي، انتهى.
قوله تعالى: ﴿وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا﴾ إلخ، متمم للكلام في
الآية السابقة، والحسبان هو الظن، والفتنة هي المحنة التي تغر الإنسان أو
هي أعم من كل شر وبلية، والعمى هو عدم إبصار الحق وعدم تمييز الخير من
الشر، والصمم عدم سماع العظة وعدم الإعباء بالنصيحة، وهذا العمى والصمم
معلولا حسبانهم أن لا تكون فتنة، والظاهر أن حسبانهم ذلك معلول ما قدروا
لأنفسهم من الكرامة بكونهم من شعب إسرائيل وأنهم أبناء الله وأحباؤه فلا
يمسهم السوء وإن فعلوا ما فعلوا وارتكبوا ما ارتكبوا.
فمعنى الآية - والله أعلم - أنهم لمكان ما اعتقدوا لأنفسهم من كرامة التهود
ظنوا أن لا يصيبهم سوء أو لا يفتنون بما فعلوا فأعمى ذلك الظن والحسبان
أبصارهم عن إبصار الحق، وأصم ذلك آذانهم عن سماع ما ينفعهم من دعوة
أنبيائهم.
وهذا مما يرجح ما احتملناه أن
الآيات كالحجة المبينة لقوله: ﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا﴾ الآية فمحصل المعنى
أن الأسماء والألقاب لا تنفع أحدا شيئا فهؤلاء اليهود لم ينفعهم ما قدروا
لأنفسهم من الكرامة بالتسمي بل أعماهم وأوردهم مورد الهلكة والفتنة لما
كذبوا أنبياء الله وقتلوهم.
قوله تعالى: ﴿ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما
يعملون﴾ التوبة من الله على عباده رجوعه تعالى بالرحمة إليهم، وهذا يدل على
أن الله سبحانه قد كان بعدهم من رحمته وعنايته ولذلك أخذهم الحسبان
المذكور ولزمهم العمى والصمم، لكن الله سبحانه رجع إليهم ثانية بالتوبة
فرفع هذا الحسبان عن قلوبهم، والعمى والصمم عن أبصارهم وآذانهم، فعرفوا
أنفسهم بأنهم عباد لا كرامة لهم على الله إلا بالتقوى، وأبصروا الحق وسمعوا
عظة الله لهم بلسان أنبيائه فتبين لهم أن التسمي لا ينفع شيئا.
ثم عموا وصموا كثير منهم، وإسناد العمى والصمم إلى جمعهم أولا ثم إلى كثير
منهم - بإتيان كثير منهم بدلا من واو الجمع، أخذ بالنصفة في الكلام
بالدلالة على أن إسناد العمى والصمم إلى جمعهم من قبيل إسناد حكم البعض إلى
الكل، والواقع أن المتصف بهاتين الصفتين كثير منهم لا كلهم أولا، وإيماء
إلى أن العمى والصمم المذكورين أولا شملا جميعهم على ما يدل عليه المقابلة
ثانيا، وأن التوبة الإلهية لم يبطل أثرها ولم تذهب سدى بالمرة بل نجا
بالتوبة بعضهم فلم يأخذهم العمى والصمم اللاحقان أخيرا ثالثا.
ثم ختم تعالى الآية بقوله: ﴿والله بصير بما يعملون﴾ للدلالة على أن الله
تعالى لا يغفله شيء، فغيره تعالى إذا أكرم قوما بكرامة ضرب ذلك على بصره
بحجاب يمنعه أن يرى منهم السوء والمكروه، وليس الله سبحانه على هذا النعت
بل هو البصير لا يحجبه شيء عن شيء.
قوله تعالى: ﴿لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم﴾ وهذا كالبيان
لكون النصارى لم تنفعهم النصرانية والانتساب إلى المسيح (عليه السلام) عن
تعلق الكفر بهم إذ أشركوا بالله ولم يؤمنوا به حق إيمانه حيث قالوا: إن
الله هو المسيح بن مريم.
والنصارى وإن اختلفوا في كيفية اشتمال المسيح بن مريم على جوهرة الألوهية
بين قائل باشتقاق أقنوم المسيح وهو العلم من أقنوم الرب تعالى وهو الحياة،
وذلك الأبوة والبنوة، وقائل بأنه تعالى صار هو المسيح على نحو الانقلاب،
وقائل بأنه حل فيه كما تقدم بيان ذلك تفصيلا في الكلام على عيسى بن مريم
(عليهما السلام) في
تفسير سورة آل عمران في الجزء الثالث من الكتاب.
لكن الأقوال الثلاثة جميعا تقبل الانطباق على هذه الكلمة أن الله هو المسيح
بن مريم فالظاهر أن المراد بالذين تفوهوا بهذه الكلمة جميع النصارى
الغالين في المسيح (عليه السلام) لا خصوص القائلين منهم بالانقلاب.
وتوصيف المسيح بابن مريم لا يخلو من دلالة أو إشعار بسبب كفرهم وهو نسبة
الألوهية إلى إنسان ابن إنسان مخلوقين من تراب، وأين التراب ورب الأرباب؟!.
قوله تعالى: ﴿وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم﴾ إلى آخر
الآية احتجاج على كفرهم وبطلان قولهم بقول المسيح (عليه السلام) نفسه فإن
قوله (عليه السلام): ﴿اعبدوا الله ربي وربكم﴾ يدل على أنه عبد مربوب مثلهم،
وقوله: ﴿إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة﴾ يدل على أن من يجعل
لله شريكا في ألوهيته فهو مشرك كافر محرم عليه الجنة.
وفي قوله تعالى حكاية عنه (عليه السلام): ﴿فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه
النار وما للظالمين من أنصار﴾ عناية بإبطال ما ينسبونه إلى المسيح من حديث
التفدية، وأنه (عليه السلام) باختياره الصلب فدى بنفسه عنهم فهم مغفور لهم
مرفوع عنهم التكاليف الإلهية ومصيرهم إلى الجنة ولا يمسون نارا كما تقدم
نقل ذلك عنهم في
تفسير سورة آل عمران في قصة عيسى (عليه السلام) فقصة التفدية والصلب إنما سيقت لهذا الغرض.
وما تحكيه الآية من قوله (عليه السلام) موجود في متفرقات الأبواب من
الأناجيل كالأمر بالتوحيد، وإبطال عبادة المشرك، والحكم بخلود الظالمين في
النار.
قوله تعالى: ﴿لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة﴾ أي أحد الثلاثة:
الأب والابن والروح، أي هو ينطبق على كل واحد من الثلاثة، وهذا لازم قولهم:
إن الأب إله، والابن إله، والروح إله، وهو ثلاثة، وهو واحد يضاهئون بذلك
نظير قولنا: إن زيد بن عمرو إنسان، فهناك أمور ثلاثة هي: زيد وابن عمرو
والإنسان، وهناك أمر واحد وهو المنعوت بهذه النعوت، وقد غفلوا عن أن هذه
الكثرة إن كانت حقيقية غير اعتبارية أوجبت الكثرة في المنعوت حقيقة، وأن
المنعوت إن كان واحدا حقيقة أوجب ذلك أن تكون الكثرة اعتبارية غير حقيقية
فالجمع بين هذه الكثرة العددية والوحدة العددية في زيد المنعوت بحسب
الحقيقة مما يستنكف العقل عن تعقله.
ولذا ربما ذكر بعض الدعاة من النصارى أن مسألة التثليث من المسائل المأثورة
من مذاهب الأسلاف التي لا تقبل الحل بحسب الموازين العلمية، ولم يتنبه أن
عليه أن يطالب الدليل على كل دعوى يقرع سمعه سواء كان من دعاوي الأسلاف أو
من دعاوي الأخلاف.
قوله تعالى: ﴿وما من إله إلا إله واحد﴾ إلى آخر الآية رد منه تعالى لقولهم:
﴿إن الله ثالث ثلاثة﴾ بأن الله سبحانه لا يقبل بذاته المتعالية الكثرة
بوجه من الوجوه فهو تعالى في ذاته واحد، وإذا اتصف بصفاته الكريمة وأسمائه
الحسنى لم يزد ذلك على ذاته الواحدة شيئا ولا الصفة إذا أضيفت إلى الصفة
أورث ذلك كثرة وتعددا فهو تعالى أحدي الذات لا ينقسم لا في خارج ولا في وهم
ولا في عقل.
فليس الله سبحانه بحيث يتجزأ في ذاته إلى شيء وشيء قط، ولا أن ذاته بحيث
يجوز أن يضاف إليه شيء فيصير اثنين أو أكثر، كيف؟ وهو تعالى مع هذا الشيء
الذي تراد إضافته إليه تعالى في وهم أو فرض أو خارج.
فهو تعالى واحد في ذاته لكن لا بالوحدة العددية التي لسائر الأشياء المتكون
منها الكثرات، ولا منعوت بكثرة في ذات أو اسم، أو صفة، كيف؟ وهذه الوحدة
العددية والكثرة المتألفة منها كلتاهما من آثار صنعه وإيجاده فكيف يتصف بما
هو من صنعه؟.
وفي قوله تعالى: ﴿وما من إله إلا إله واحد﴾ من التأكيد في إثبات التوحيد ما
ليس في غيره حيث سيق الكلام بنحو النفي والاستثناء، ثم أدخل ﴿من﴾ على
النفي لإفادة تأكيد الاستغراق، ثم جيء بالمستثنى وهو قوله: ﴿إله واحد﴾
بالتنكير المفيد للتنويع ولو أورد معرفة كقولنا ﴿إلا الإله الواحد﴾ لم يفد
ما يرام من حقيقة التوحيد.
فالمعنى: ليس في الوجود شيء من جنس الإله أصلا إلا إله واحد نوعا من الوحدة
لا يقبل التعدد أصلا لا تعدد الذات ولا تعدد الصفات، لا خارجا ولا فرضا،
ولو قيل: وما من إله إلا الله الواحد لم يدفع به قول النصارى إن الله ثالث
ثلاثة فإنهم لا ينكرون الوحدة فيه تعالى، وإنما يقولون: إنه ذات واحدة لها
تعين بصفاتها الثلاث، وهي واحدة في عين أنها كثيرة حقيقة.
ولا يندفع ما احتملوه من المعنى إلا بإثبات وحدة لا تتألف منه كثرة أصلا، وهو الذي يتوخاه
القرآن الكريم بقوله: ﴿وما من إله إلا إله واحد﴾.
وهذا من لطائف المعاني التي يلوح إليها الكتاب الإلهي في حقيقة معنى
التوحيد وسنغور في البحث المستوفى عنه في بحث قرآني خاص ثم في بحث عقلي
وآخر نقلي إيفاء لحقه.
قوله تعالى: ﴿وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم﴾
تهديد لهم بالعذاب الأليم الأخروي الذي هو ظاهر الآية الكريمة.
ولما كان القول بالتثليث الذي تتضمنه كلمة: ﴿إن الله ثالث ثلاثة﴾ ليس في
وسع عقول عامة الناس أن تتعقله فأغلب النصارى يتلقونه قولا مذهبيا مسلما
بلفظة من غير أن يعقلوا معناه، ولا أن يطمعوا في تعقله كما ليس في وسع
العقل السليم أن يعقله عقلا صحيحا، وإنما يتعقل كتعقل الفروض المحالة
كالإنسان اللاإنسان، والعدد الذي ليس بواحد ولا كثير ولا زوج ولا فرد فلذلك
تتسلمه العامة تسلما من غير بحث عن معناه، وإنما يعتقدون في البنوة
والأبوة شبه معنى التشريف فهؤلاء في الحقيقة ليسوا من أهل التثليث، وإنما
يمضغون الكلمة مضغا، وينتمون إليها انتماء بخلاف غير العامة منهم وهم الذين
ينسب الله سبحانه إليهم اختلاف المذاهب ويقرر أن ذلك ببغيهم كما قال
تعالى: ﴿أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه - إلى أن قال: - وما تفرقوا إلا
من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم﴾: الشورى: 14.
فالكفر الحقيقي الذي لا ينتهي إلى استضعاف - وهو الذي فيه إنكار التوحيد
والتكذيب بآيات الله - إنما يتم في بعضهم دون كلهم، وإنما أوعد الله بالنار
الخالد الذين كفروا وكذبوا بآيات الله، قال: ﴿والذين كفروا وكذبوا بآيات
الله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾: البقرة: 39 إلى غير ذلك من
الآيات، وقد مر الكلام في ذلك في
تفسير قوله تعالى: ﴿إلا المستضعفين﴾ الآية: النساء: 98.
ولعل هذا هو السر في التبعيض الظاهر من قوله: ﴿ليمسن الذين كفروا منهم﴾ أو
أن المراد به الإشارة إلى أن من النصارى من لا يقول بالتثليث، ولا يعتقد في
المسيح إلا أنه عبد الله ورسوله، كما كانت على ذلك مسيحيوا الحبشة وغيرها
على ما ضبطه التاريخ فالمعنى: لئن لم ينته النصارى عما يقولون نسبة قول بعض
الجماعة إلى جميعهم ليمسن الذين كفروا منهم - وهم القائلون بالتثليث منهم -
عذاب أليم.
وربما وجهوا الكلام أعني قوله: ﴿ليمسن الذين كفروا منهم﴾ بأنه من قبيل وضع
الظاهر موضع المضمر، والأصل: ليمسنهم انتهى، وإنما عدل إلى وضع الموصول
وصلته مكانه ليدل على أن ذلك القول كفر بالله، وأن الكفر سبب العذاب الذي
توعدهم به.
وهذا وجه لا بأس به لو لا أن الآية مصدرة بقوله: ﴿لقد كفر الذين قالوا إن
الله ثالث ثلاثة﴾ ونظيره في البعد قول بعض آخر: إن ﴿من﴾ في قوله ﴿منهم﴾
بيانية فإنه قول من غير دليل.
قوله تعالى: ﴿أ فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم﴾ تحضيض على
التوبة والاستغفار، وتذكير بمغفرة الله ورحمته، أو إنكار أو توبيخ.
قوله تعالى: ﴿ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة
كانا يأكلان الطعام﴾ رد لقولهم: ﴿إن الله ثالث ثلاثة﴾ أو لقولهم هذا وقولهم
المحكي في الآية السابقة: ﴿إن الله هو المسيح بن مريم﴾ جميعا، ومحصله
اشتمال المسيح على جوهرة الألوهية، بأن المسيح لا يفارق سائر رسل الله
الذين توفاهم الله من قبله كانوا بشرا مرسلين من غير أن يكونوا أربابا من
دون الله سبحانه، وكذلك أمه مريم كانت صديقة تصدق بآيات الله تعالى وهي
بشر، وقد كان هو وأمه جميعا يأكلان الطعام، وأكل الطعام مع ما يتعقبه مبني
على أساس الحاجة التي هو أول أمارة من أمارات الإمكان والمصنوعية فقد كان
المسيح (عليه السلام) ممكنا متولدا من ممكن، وعبدا ورسولا مخلوقا من أمه
كانا يعبدان الله، ويجريان في سبيل الحاجة والافتقار من دون أن يكون ربا.
وما بيد القوم من كتب الإنجيل معترفة بذلك تصرح بكون مريم فتاة كانت تؤمن
بالله وتعبده، وتصرح بأن عيسى تولد منها كالإنسان من الإنسان، وتصرح بأن
عيسى كان رسولا من الله إلى الناس كسائر الرسل وتصرح بأن عيسى وأمه مريم
كانا يأكلان الطعام.
فهذه أمور صرحت بها الأناجيل، وهي حجج على كونه (عليه السلام) عبدا رسولا.
ويمكن أن تكون الآية مسوقة لنفي ألوهية المسيح وأمه كليهما على ما يظهر من
قوله تعالى: ﴿أ أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله﴾: المائدة:
161 أنه كان هناك من يقول بألوهيتها كالمسيح أو أن المراد به اتخاذها إلها
كما ينسب إلى أهل الكتاب أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله،
وذلك بالخضوع لها ولهم بما لا يخضع لبشر بمثله.
وكيف كان فالآية على هذا التقدير تنفي عن المسيح وأمه معا الألوهية بأن
المسيح كان رسولا كسائر الرسل، وأمه كانت صديقة، وهما معا كانا يأكلان
الطعام، وذلك كله ينافي الألوهية.
وفي قوله تعالى: ﴿قد خلت من قبله الرسل﴾ حيث وصف الرسل بالخلو من قبله، وهو
الموت تأكيد للحجة بكونه بشرا يجوز عليه الموت والحياة كما جاز على الرسل
من قبله.
قوله تعالى: ﴿انظر كيف نبين لهم
الآيات ثم انظر أنى يؤفكون﴾ الخطاب للنبي، (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو في
مقام التعجيب أي تعجب من كيفية بياننا لهم الآيات، وهو أوضح بيان لأظهر آية
في بطلان دعواهم ألوهية المسيح، وكيفية صرفهم عن تعقل هذه
الآيات فإلى أي غاية يصرفون عنها، ولا تلتفت إلى نتيجتها - وهي بطلان دعواهم - عقولهم؟.
قوله تعالى: ﴿قل أ تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله
هو السميع العليم﴾ كان الخضوع لأمر الربوبية إنما انتشر بين البشر في أقدم
عهوده، وخاصة بين العامة منهم - وعامتهم كانوا يعبدون الأصنام - طمعا في أن
يدفع الرب عنهم الشر ويوصل إليهم النفع كما يتحصل من الأبحاث التاريخية،
وأما عبادة الله لأنه الله عز اسمه فلم يكن يعدو الخواص منهم كالأنبياء
والربانيين من أممهم.
فأمر الله سبحانه رسوله أن يخاطبهم خطاب البشر الساذج الجاري على ما تلهمه
فطرته الساذجة في عبادة الله كما خاطب الوثنيين وعباد الأصنام بذلك فيذكرهم
أن الذي يضطر الإنسان بعبادة الرب هو أنه يرى أزمة الخير والشر والنفع
والضر بيده فيعبده لأنه يملك الضر والنفع طمعا في أن يدفع عنه الضر ويوصل
إليه الخير لعبادته له.
وكل ما هو دون الله تعالى لا يملك شيئا من ضر ولا نفع لأنه مملوك لله محضا
مسلوب عنه القدرة في نفسه فكيف يسوغ تخصيصه بالعبادة، وإشراكه مع ربه الذي
هو المالك له ولغيره، وقد كان من الواجب أن يخص هو تعالى بالعبادة، ولا
يتعدى عنه إلى غيره لأنه هو الذي يختص به السمع والإجابة فيسمع ويجيب
المضطر إذ دعاه، وهو الذي يعلم حوائج عباده ولا يغفل عنها ولا يغلط فيها
بخلاف غيره تعالى فإنه إنما يملك ما ملكه الله، ويقوى على ما قواه الله
سبحانه.
فقد تبين بهذا البيان: أولا: أن الحجة التي تشتمل عليها هذه الآية غير
الحجة التي تشتمل عليها الآية السابقة وإن توقفتا معا على مقدمة مشتركة،
وهي كون المسيح وأمه ممكنين محتاجين، فالآية السابقة حجتها أن المسيح وأمه
كانا بشرين محتاجين عبدين مطيعين لله سبحانه، ومن كان حاله هذا الحال لم
يصح أن يكون إلها معبودا، وحجة هذه الآية: أن المسيح ممكن محتاج مملوك
بنفسه لا يملك ضرا ولا نفعا، ومن كان حاله هذا الحال لم يستقم ألوهيته
وعبادته من دون الله.
وثانيا: أن الحجة مأخوذة مما يدركه الفهم البسيط والعقل الساذج من جهة غرض
الإنسان البسيط في عبادته فإنه إنما يتخذ ربا ويعبده ليدفع عنه الضر ويجلب
إليه النفع، وهذا إنما يملكه الله تعالى دون غيره، فلا غرض يتعلق بعبادة
غير الله فمن الواجب أن يرفض عبادته.
وثالثا: أن قوله: ﴿ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا﴾ إنما أخذت فيه لفظة ﴿ما﴾
دون لفظة ﴿من﴾ مع المسيح من أولي العقل لأن الحجة بعينها هي التي تقام على
الوثنيين وعبدة الأصنام التي لا شعور لها، ولا دخل في كون المسيح (عليه
السلام) من أولي العقل في تمام الحجة فهي تامة في كل معبود مفروض دون الله
سبحانه.
على أن غيره تعالى وإن كان من أولي العقل والشعور لا يملكون شيئا من العقل
والشعور من عند أنفسهم كسائر ما ينسب إليهم من شئون وجودهم قال تعالى: ﴿إن
الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم
صادقين، أ لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون
بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون﴾:
الأعراف: 159.
وكذلك تقديم الضر على النفع في قوله: ﴿ضرا ولا نفعا﴾ للجري على وفق ما
تدركه وتدعوا إليه الفطرة الساذجة كما مر، فإن الإنسان بحسب الطبع يرى ما
تلبس به من النعم الموجودة عنده ما دامت عنده مملوكة لنفسه لا تلتفت نفسه
إلى إمكان فقدها ولا تتصور ألمه عند فقدها بخلاف المضار التي يجدها بالفعل،
والنعم التي يفتقدها ويجد ألم فقدها، فإن الفطرة تنبهها إلى الالتجاء إلى
رب يدفع عنها الضر والضير، ويجلب إليها النعمة المسلوبة كما قال تعالى:
﴿وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره
مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه﴾: يونس: 12، وقال تعالى: ﴿ولئن أذقناه رحمة منا
من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي﴾: حم السجدة: 50، وقال تعالى: ﴿وإذا
أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض﴾: حم
السجدة: 51.
فتحصل أن مس الضر أبعث للإنسان إلى الخضوع للرب وعبادته من وجدان النفع،
ولذلك قدم الله سبحانه الضر على النفع في قوله: ﴿ما لا يملك لكم ضرا ولا
نفعا﴾ وكذا في سائر الموارد التي تماثله كقوله: ﴿اتخذوا من دونه آلهة لا
يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا
ولا حياة ولا نشورا﴾: الفرقان: 3.
ورابعا: أن مجموع الآية: ﴿أ تعبدون من دون الله﴾ إلى آخرها حجة على وجوب
قصر العبادة في الله سبحانه من دون إشراك غيره معه وهي منحلة إلى حجتين
ملخصهما: أن اتخاذ الإله وعبادة الرب إنما هو لغرض دفع الضر وجلب النفع
فيجب أن يكون الإله المعبود مالكا لذلك ولا يجوز عبادة من لا يملك شيئا،
والله سبحانه هو السميع المجيب للدعوة العليم بكنه الحاجة من غير جهل دون
غيره فوجب عبادته من غير إشراك غيره.
قوله تعالى: ﴿قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق﴾ خطاب آخر للنبي
(صلى الله عليه وآله وسلم) بأمره أن يدعو أهل الكتاب إلى عدم الغلو في
دينهم، وأهل الكتاب وخاصة النصارى مبتلون بذلك، و﴾الغالي﴾ المتجاوز عن الحد
بالإفراط، ويقابله ﴿القالي﴾ في طرف التفريط.
ودين الله الذي يفسره كتبه المنزلة يأمر بالتوحيد ونفي الشريك وينهى عن
اتخاذ الشركاء لله سبحانه، وقد ابتلي بذلك أهل الكتاب عامة اليهود
والنصارى، وإن كان أمر النصارى في ذلك أشنع وأفظع قال تعالى: ﴿وقالت اليهود
عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون
قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم
أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا إلا
هو سبحانه عما يشركون﴾: التوبة: 31.
والقول بأن عزيرا ابن الله وإن كان غير ظاهر اليوم عند اليهود لكن الآية تشهد بأنهم كانوا يقولون ذلك في عصر النزول.
والظاهر أن ذلك كان لقبا تشريفيا يلقبونه به قبال ما خدمهم وأحسن إليهم في
إرجاعهم إلى أورشليم بيت المقدس بعد إسارة بابل، وجمع لهم التوراة ثانيا
بعد ضياعه في قصة بخت نصر، وقد كانوا يعدون بنوة الله لقبا تشريفيا كما
يتخذ النصارى اليوم الأبوة كذلك ويسمون الباباوات والبطارقة والقسيسين
بالآباء الباب والبابا: الأب وقد قال تعالى: ﴿وقالت اليهود والنصارى نحن
أبناء الله وأحباؤه﴾: المائدة: 18.
بل الآية الثانية أعني قوله: ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله
والمسيح بن مريم﴾ تدل على ذلك حيث اقتصر فيها على ذكر المسيح (عليه
السلام)، ولم يذكر عزيرا فدل على دخوله في عموم قوله: ﴿أحبارهم ورهبانهم﴾
وأنهم إنما كانوا يسمونه ابن الله كما يسمون أحبارهم أبناء الله، وقد خصوه
بالذكر وحده شكرا لإحسانه إليهم كما تقدمت الإشارة إليه.
وبالجملة وضعهم بعض أنبيائهم وأحبارهم ورهبانهم موضع الربوبية وخضوعهم لهم
بما لا يخضع بمثله إلا لله سبحانه غلو منهم في دينهم ينهاهم الله عن ذلك
بلسان نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم).
وتقييد الغلو في الدين بغير الحق - ولا يكون الغلو إلا كذلك - إنما هو
للتأكيد وتذكير لازم المعنى مع ملزومه لئلا يذهل عنه السامع وقد ذهل حين
غلا أو كان كالذاهل.
وإطلاق الأب على الله سبحانه بتحليل معناه وتجريده عن وسمة نواقص المادة
الجسمانية أي من بيده الإيجاد والتربية، وكذلك الابن بمعناه المجرد
التحليلي وإن لم يمنعه العقل لكنه ممنوع شرعا لتوقيفية أسماء الله سبحانه
لما في التوسع في إطلاق الأسماء المختلفة عليه تعالى من المفاسد، وكفى
مفسدة في إطلاق الأب والابن ما لقيته الأمتان: اليهود والنصارى وخاصة
النصارى من أولياء الكنيسة خلال قرون متمادية ولن يزال الأمر على ذلك.
قوله تعالى: ﴿ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن
سواء السبيل﴾ ظاهر السياق أن المراد بهؤلاء القوم الذين نهوا عن اتباع
أهوائهم هم المتبوعون المطاعون في آرائهم وأوامرهم فيكون ضلالهم لمكان
التزامهم بآرائهم إضلالهم كثيرا هو اتباع غيرهم لهم، وضلالهم عن سواء
السبيل هو المتحصل لهم من ضلالهم وإضلالهم، وهو ضلال على ضلال.
وكذلك ظاهر السياق أن المراد بهم هم الوثنية وعبدة الأصنام فإن ظاهر السياق
أن الخطاب إنما هو لجميع أهل الكتاب لا للمعاصرين منهم للنبي (صلى الله
عليه وآله وسلم) حتى يكون نهيا لمتأخريهم عن اتباع متقدميهم.
ويؤيده بل يدل عليه قوله تعالى: ﴿وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت
النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من
قبل﴾: التوبة: 30.
فيكون ذلك حقيقة تحليلية تاريخية أشار إليها
القرآن الكريم هي أن القول بالأبوة والبنوة مما تسرب إلى أهل الكتاب من قبل من
تقدمهم من الوثنية، وقد تقدم في الكلام على قصص المسيح (عليه السلام) في
سورة آل عمران في الجزء الثالث من الكتاب أن هذا القول في جملة من الأقوال
والآراء موجود عند الوثنية البرهمنية والبوذية في الهند والصين، وكذلك مصر
القديم وغيرهم، وإنما أخذ بالتسرب في الملة الكتابية بيد دعاتها، فظهر في
زي الدين وكان الاسم لدين التوحيد والمسمى للوثنية.
قوله تعالى: ﴿لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم﴾
إلى آخر الآيتين إخبار بأن الكافرين منهم ملعونون بلسان أنبيائهم، وفيه
تعريض لهؤلاء الذين كفرهم الله في هذه
الآيات من اليهود ملعونين بدعوة أنبيائهم أنفسهم، وذلك بسبب عصيانهم لأنبيائهم،
وهم كانوا مستمرين على الاعتداء وقوله: ﴿كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه﴾
﴿إلخ﴾ بيان لقوله: ﴿وكانوا يعتدون﴾.
قوله تعالى: ﴿ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا﴾ ﴿إلخ﴾، وهذا من قبيل
الاستشهاد بالحس على كونهم معتدين فإنهم لو قدروا دينهم حق قدره لزموه ولم
يعتدوه، ولازم ذلك أن يتولوا أهل التوحيد ويتبرءوا من الذين كفروا لأن
أعداء ما يقدسه قوم أعداء لذلك القوم، فإذا تحابوا وتوالوا دل ذلك على
إعراض ذلك القوم وتركهم ما كانوا يقدسونه ويحترمونه، وصديق العدو عدو، ثم
ذمهم الله تعالى بقوله: ﴿لبئس ما قدمت لهم أنفسهم﴾ وهو ولاية الكفار عن هوى
النفس، وكان جزاؤه ووباله ﴿أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون﴾، ففي
الآية وضع جزاء العمل وعاقبته موضع العمل كأن أنفسهم قدمت لهم جزاء العمل
بتقديم نفس العمل.
قوله تعالى: ﴿ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم
أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون﴾ أي ولو كان أهل الكتاب هؤلاء يؤمنون بالله
والنبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وما أنزل إليه، أو نبي أنفسهم كموسى
مثلا وما أنزل إليه كالتوراة مثلا ما اتخذوا أولئك الكفار أولياء لأن
الإيمان يجب سائر الأسباب، ولكن كثيرا منهم فاسقون متمردون عن الإيمان.
وفي الآية وجه آخر احتملوه، وهو أن يرجع ضمائر قوله: ﴿كانوا﴾ و﴾يؤمنون﴾
و﴾هم﴾ في قوله: ﴿ما اتخذوهم﴾ راجعة إلى الذين كفروا، والمعنى: ولو كان
الذين كفروا أولئك الكفار الذين يتولاهم أهل الكتاب يؤمنون بالله والنبي
والقرآن ما اتخذتهم أهل الكتاب أولياء، وإنما تولوهم لمكان كفرهم، وهذا وجه
لا بأس به غير أن الإضراب في قوله: ﴿ولكن كثيرا منهم فاسقون﴾ لا يلائمه.
قوله تعالى: ﴿لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا - إلى قوله - نصارى﴾ لما بين سبحانه في
الآيات السابقة الرذائل المشتركة بين أهل الكتاب عامة، وبعض ما يختص ببعضهم كقول
اليهود: ﴿يد الله مغلولة﴾ وقول النصارى: ﴿إن الله هو المسيح بن مريم﴾ ختم
الآيات بما يختص به كل من الطائفين إذا قيس حالهم من المؤمنين ودينهم، وأضاف إلى
حالهم حال المشركين ليتم الكلام في وقع الإسلام من قلوب الأمم غير المسلمة
من حيث قربهم وبعدهم من قبوله.
ويتم الكلام في أن النصارى أقرب تلك الأمم مودة للمسلمين وأسمع لدعوتهم الحقة.
وإنما عدهم الله سبحانه أقرب مودة للمسلمين لما وقع من إيمان طائفة منهم
بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كما يدل عليه قوله في الآية التالية:
﴿وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول﴾ ﴿إلخ﴾، لكن لو كان إيمان طائفة تصحح هذه
النسبة إلى جميعهم كان من الواجب أن تعد اليهود والمشركون كمثل النصارى
وينسب إليهما نظير ما نسب إليهم لمكان إسلام طائفة من اليهود كعبد الله بن
سلام وأصحابه، وإسلام عدة من مشركي العرب وهم عامة المسلمين اليوم فتخصيص
النصارى بمثل قوله: ﴿وإذا سمعوا ما أنزل﴾ ﴿إلخ﴾، دون اليهود والمشركين يدل
على حسن إقبالهم على الدعوة الإسلامية وإجابة النبي (صلى الله عليه وآله
وسلم) مع أنهم على خيار بين أن يقيموا على دينهم ويؤدوا الجزية، وبين أن
يقبلوا الإسلام، أو يحاربوا.
وهذا بخلاف المشركين فإنهم لم يكن يقبل منهم إلا قبول الدعوة فكثرة
المؤمنين منهم لا يدل على حسن الإجابة، على ما كابد النبي (صلى الله عليه
وآله وسلم) من جفوتهم ولقاه المسلمون من أيديهم بقسوتهم ونخوتهم.
وكذلك اليهود وإن كانوا كالنصارى في إمكان إقامتهم على دينهم وتأدية الجزية
إلى المسلمين لكنهم تمادوا في نخوتهم، وتصلبوا في عصبيتهم، وأخذوا بالمكر
والمكيدة، ونقضوا عهودهم، وتربصوا الدوائر على المسلمين، ومسوهم بأمر المس
وآلمه.
وهذا الذي جرى من أمر النصارى مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والدعوة
الإسلامية، وحسن إجابتهم، وكذا من أمر اليهود والمشركين في التمادي على
الاستكبار والعصبية جرى بعينه بعده (صلى الله عليه وآله وسلم) على حذو ما
جرى في عهده فما أكثر من لبى الدعوة الإسلامية من فرق النصارى خلال القرون
الماضية، وما أقل ذلك من اليهود والوثنيين! فاحتفاظ هذه الخصيصة في هؤلاء
وهؤلاء يصدق الكتاب العزيز في ما أفاده.
ومن المعلوم أن قوله تعالى: ﴿لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا﴾ من قبيل بيان الضابط العام في صورة خطاب خاص نظير ما مر في
الآيات السابقة: ﴿ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا﴾ و﴾ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم﴾.
قوله تعالى: ﴿ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون﴾ القسيس معرب
﴿كشيش﴾ والرهبان جمع الراهب وقد يكون مفردا، قال الراغب: الرهبة والرهب
مخافة مع تحرز - إلى أن قال - والترهب التعبد، والرهبانية غلو في تحمل
التعبد من فرط الرهبة، قال تعالى: ﴿ورهبانية ابتدعوها﴾ والرهبان يكون واحدا
وجمعا فمن جعله واحدا جمعه على رهابين، انتهى.
علل تعالى ما ذكره من كون النصارى أقرب مودة وآنس قلوبا للذين آمنوا بخصال
ثلاث يفقدها غيرهم من اليهود والمشركين، وهي أن فيهم علماء وأن فيهم رهبانا
وزهادا، وأنهم لا يستكبرون وذلك مفتاح تهيؤهم للسعادة.
وذلك أن سعادة حياة الدين أن تقوم بصالح العمل عن علم به، وإن شئت فقل: إن
يذعن بالحق فيطبق عمله عليه فله حاجة إلى العلم ليدرك به حق الدين وهو دين
الحق، ومجرد إدراك الحق لا يكفي للتهيؤ للعمل على طبقه حتى ينتزع الإنسان
من نفسه الهيئة المانعة عنه، وهو الاستكبار عن الحق بعصبية وما يشابهها،
وإذا تلبس الإنسان بالعلم النافع والنصفة في جنب الحق برفع الاستكبار تهيأ
للخضوع للحق بالعمل به لكن بشرط عدم منافاة الجو لذلك فإن لموافقة الجو
للعمل تأثيرا عظيما في باب الأعمال فإن الأعمال التي يعتورها عامة المجتمع
وينمو عليها أفراده، وتستقر عليهم عادتهم خلفا عن سلف لا يبقى للنفس فراغ
أن تتفكر في أمرها أو تتدبر وتدبر في التخلص عنها إذا كانت ضارة مفسدة
للسعادة، وكذلك الحال في الأعمال الصالحة إذا استقر التلبس بها في مجتمع
يصعب على النفس تركها، ولذا قيل: إن العادة طبيعة ثانية، ولذا كان أيضا أول
فعل مخالف حرجا على النفس في الغاية وهو عند النفس دليل على الإمكان، ثم
لا يزال كلما تحقق فعل زاد في سهولة التحقق ونقص بقدره من صعوبته.
فإذا تحقق الإنسان أن عملا كذا حق صالح ونزع عن نفسه أغراض العناد واللجاج
بإماتة الاستكبار والاستعلاء على الحق كان من العون كل العون على إتيانه أن
يرى إنسانا يرتكبه فتتلقى نفسه إمكان العمل.
ومن هنا يظهر أن المجتمع إنما يتهيأ لقبول الحق إذا اشتمل على علماء
يعلمونه ويعلمونه، وعلى رجال يقومون بالعمل به حتى يذعن العامة بإمكان
العمل ويشاهدوا حسنه، وعلى اعتياد عامتهم على الخضوع للحق وعدم الاستكبار
عنه إذا انكشف لهم.
ولهذا علل الله سبحانه قرب النصارى من قبول الدعوة الحقة الدينية بأن فيهم
قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ففيهم علماء لا يزالون يذكرونهم مقام
الحق ومعارف الدين قولا، وفيهم زهاد يذكرونهم عظمة ربهم وأهمية سعادتهم
الأخروية والدنيوية عملا، وفيهم عدم الاستكبار عن قبول الحق.
وأما اليهود فإنهم وإن كان فيهم أحبار علماء لكنهم مستكبرون لا تدعهم رذيلة العناد والاستعلاء أن يتهيئوا لقبول الحق.
وأما الذين أشركوا فإنهم يفقدون العلماء والزهاد، وفيهم رذيلة الاستكبار.
قوله تعالى: ﴿وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفي







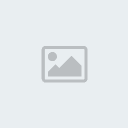


 ناتها،
ناتها،
