•
الآيات 33-40
إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ
فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ
ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ﴿33﴾ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ
عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿34﴾ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ
وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿35﴾ إِنَّ الَّذِينَ
كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ
لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ
مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿36﴾ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ
النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿37﴾
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا
كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿38﴾ فَمَن تَابَ
مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ
اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿39﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء
وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿40﴾
بيان:
الآيات غير خالية الارتباط بما قبلها، فإن ما تقدمها من قصة قتل ابن آدم
أخاه وما كتبه الله سبحانه على بني إسرائيل من أجله، وإن كان من تتمة
الكلام على بني إسرائيل وبيان حالهم من غير أن يشتمل على حد أو حكم
بالمطابقة لكنها لا تخلو بحسب لازم مضمونها من مناسبة مع هذه
الآيات المتعرضة لحد المفسدين في الأرض والسراق.
قوله تعالى: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا﴾.
﴿فسادا﴾ مصدر وضع موضع الحال، ومحاربة الله وإن كانت بعد استحالة معناها
الحقيقي وتعين إرادة المعنى المجازي منها ذات معنى وسيع يصدق على مخالفة كل
حكم من الأحكام الشرعية وكل ظلم وإسراف لكن ضم الرسول إليه يهدي إلى أن
المراد بها بعض ما للرسول فيه دخل، فيكون كالمتعين أن يراد بها ما يرجع إلى
إبطال أثر ما للرسول عليه ولاية من جانب الله سبحانه كمحاربة الكفار مع
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وإخلال قطاع الطريق بالأمن العام الذي
بسطه بولايته على الأرض، وتعقب الجملة بقوله: ﴿ويسعون في الأرض فسادا﴾ يشخص
المعنى المراد وهو الإفساد في الأرض بالإخلال بالأمن وقطع الطريق دون مطلق
المحاربة مع المسلمين، على أن الضرورة قاضية بأن النبي (صلى الله عليه
وآله وسلم) لم يعامل المحاربين من الكفار بعد الظهور عليهم والظفر بهم هذه
المعاملة من القتل والصلب والمثلة والنفي.
على أن الاستثناء في الآية التالية قرينة على كون المراد بالمحاربة هو
الإفساد المذكور فإنه ظاهر في أن التوبة إنما هي من المحاربة دون الشرك
ونحوه.
فالمراد بالمحاربة والإفساد على ما هو الظاهر هو الإخلال بالأمن العام،
والأمن العام إنما يختل بإيجاد الخوف العام وحلوله محله، ولا يكون بحسب
الطبع والعادة إلا باستعمال السلاح المهدد بالقتل طبعا ولهذا ورد فيما ورد
من السنة
تفسير الفساد في الأرض بشهر السيف ونحوه، وسيجيء في البحث الروائي التالي إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: ﴿أن يقتلوا أو يصلبوا﴾ إلخ التقتيل والتصليب والتقطيع تفعيل من
القتل والصلب والقطع يفيد شدة في معنى المجرد أو زيادة فيه، ولفظة ﴿أو﴾
إنما تدل على الترديد المقابل للجمع، وأما الترتيب أو التخيير بين أطراف
الترديد فإنما يستفاد أحدهما من قرينة خارجية حالية أو مقالية فالآية غير
خالية عن الإجمال من هذه الجهة.
وإنما تبينها السنة وسيجيء أن المروي عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أن
الحدود الأربعة مترتبة بحسب درجات الإفساد كمن شهر سيفا فقتل النفس وأخذ
المال أو قتل فقط أو أخذ المال فقط أو شهر سيفا فقط على ما سيأتي في البحث
الروائي التالي إن شاء الله.
وأما قوله: ﴿أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف﴾ فالمراد بكونه من خلاف أن
يأخذ القطع كلا من اليد والرجل من جانب مخالف لجانب الأخرى كاليد اليمنى
والرجل اليسرى، وهذا هو القرينة على كون المراد بقطع الأيدي والأرجل قطع
بعضها دون الجميع أي إحدى اليدين وإحدى الرجلين مع مراعاة مخالفة الجانب.
وأما قوله: ﴿أو ينفوا من الأرض﴾ فالنفي هو الطرد والتغييب وفسر في السنة بطرده من بلد إلى بلد.
وفي الآية أبحاث أخر فقهية تطلب من كتب الفقه.
قوله تعالى: ﴿ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم﴾ الخزي هو الفضيحة، والمعنى ظاهر.
وقد استدل بالآية على أن جريان الحد على المجرم لا يستلزم ارتفاع عذاب الآخرة، وهو حق في الجملة.
قوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم﴾ إلخ وأما بعد القبض
عليهم وقيام البينة فإن الحد غير ساقط، وأما قوله تعالى: ﴿فاعلموا أن الله
غفور رحيم﴾ فهو كناية عن رفع الحد عنهم، والآية من موارد تعلق المغفرة بغير
الأمر الأخروي.
قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة﴾ إلخ
قال الراغب في المفردات: الوسيلة التوصل إلى الشيء برغبة، وهي أخص من
الوصيلة لتضمنها لمعنى الرغبة، قال تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، وحقيقة
الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة، وتحري مكارم
الشريعة، وهي كالقربة، وإذ كانت نوعا من التوصل وليس إلا توصلا واتصالا
معنويا بما يوصل بين العبد وربه ويربط هذا بذاك، ولا رابط يربط العبد بربه
إلا ذلة العبودية، فالوسيلة هي التحقق بحقيقة العبودية وتوجيه وجه المسكنة
والفقر إلى جنابه تعالى، فهذه هي الوسيلة الرابطة، وأما العلم والعمل فإنما
هما من لوازمها وأدواتها كما هو ظاهر إلا أن يطلق العلم والعمل على نفس
هذه الحالة.
ومن هنا يظهر أن المراد بقوله: ﴿وجاهدوا في سبيله﴾ مطلق الجهاد الذي يعم
جهاد النفس وجهاد الكفار جميعا إذ لا دليل على تخصيصه بجهاد الكفار مع
اتصال الجملة بما تقدمها من حديث ابتغاء الوسيلة، وقد عرفت ما معناه: على
أن الآيتين التاليتين بما تشتملان عليه من التعليل إنما تناسبان إرادة مطلق
الجهاد من قوله: ﴿وجاهدوا في سبيله﴾.
ومع ذلك فمن الممكن أن يكون المراد بالجهاد هو القتال مع الكفار نظرا إلى أن تقييد الجهاد بكونه في سبيل الله إنما وقع في
الآيات الآمرة بالجهاد بمعنى القتال، وأما الأعم فخال عن التقييد كقوله تعالى:
﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين﴾: العنكبوت: 69
وعلى هذا فالأمر بالجهاد في سبيل الله بعد الأمر بابتغاء الوسيلة إليه من
قبيل ذكر الخاص بعد العام اهتماما بشأنه، ولعل الأمر بابتغاء الوسيلة إليه
بعد الأمر بالتقوى أيضا من هذا القبيل.
قوله تعالى: ﴿إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض﴾ إلى آخر الآيتين ظاهره
- كما تقدمت الإشارة إليه - أن يكون تعليلا لمضمون الآية السابقة، والمحصل
أنه يجب عليكم أن تتقوا الله وتبتغوا إليه الوسيلة وتجاهدوا في سبيله فإن
ذلك أمر يهمكم في صرف عذاب أليم مقيم عن أنفسكم، ولا بدل له يحل محله فإن
الذين كفروا فلم يتقوا الله ولم يبتغوا إليه الوسيلة ولم يجاهدوا في سبيله
لو أنهم ملكوا ما في الأرض جميعا - وهو أقصى ما يتمناه ابن آدم من الملك
الدنيوي عادة - ثم زيد عليه مثله ليكون لهم ضعفا ما في الأرض ثم أرادوا أن
يفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن
يخرجوا من النار وهي العذاب وما هم بخارجين منها لأنه عذاب خالد مقيم عليهم
لا يفارقهم أبدا.
وفي الآية إشارة أولا إلى أن العذاب هو الأصل القريب من الإنسان وإنما يصرف
عنه الإيمان والتقوى كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿وإن منكم إلا واردها كان
على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا﴾: مريم:
72 وكذا قوله: ﴿إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾:
العصر: 3.
وثانيا: أن الفطرة الأصلية الإنسانية وهي التي تتألم من النار غير باطلة
فيهم ولا منتفية عنهم وإلا لم يتألموا ولم يتعذبوا بها ولم يريدوا الخروج
منها.
قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ الآية الواو للاستيناف
والكلام في مقام التفصيل فهو في معنى: ﴿وأما السارق والسارقة﴾ إلخ ولذلك
دخل الفاء في الخبر أعني قوله: ﴿فاقطعوا أيديهما﴾ لأنه في معنى جواب أما،
كذا قيل.
وأما استعمال الجمع في قوله: ﴿أيديهما﴾ مع أن المراد هو المثنى فقد قيل:
إنه استعمال شائع، والوجه فيه: أن بعض الأعضاء أو أكثرها في الإنسان مزدوجة
كالقرنين والعينين والأذنين واليدين والرجلين والقدمين، وإذا أضيفت هذه
إلى المثنى صارت أربعا ولها لفظ الجمع كأعينهما وأيديهما وأرجلهما ونحو ذلك
ثم اطرد الجمع في الكلام إذا أضيف عضو إلى المثنى وإن لم يكن العضو من
المزدوجات كقولهم: ملأت ظهورهما وبطونهما ضربا، قال تعالى: ﴿إن تتوبا إلى
الله فقد صغت قلوبكما﴾: التحريم: 4 واليد ما دون المنكب والمراد بها في
الآية اليمين بتفسير السنة، ويصدق قطع اليد بفصل بعض أجزائها أو جميعها عن
البدن بآلة قطاعة.
قوله: ﴿جزاء بما كسبا نكالا من الله﴾ الظاهر أنه في موضع الحال من القطع
المفهوم من قوله: ﴿فاقطعوا﴾ أي حال كون القطع جزاء بما كسبا نكالا من الله،
والنكال هو العقوبة التي يعاقب بها المجرم لينتهي عن إجرامه، ويعتبر بها
غيره من الناس.
وهذا المعنى أعني كون القطع نكالا هو المصحح لأن يتفرع عليه قوله: ﴿فمن تاب
من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه﴾ إلخ أي لما كان القطع نكالا يراد
به رجوع المنكول به عن معصيته فمن تاب من بعد ظلمه توبة ثم أصلح ولم يحم
حول السرقة - وهذا أمر يستثبت به معنى التوبة - فإن الله يتوب عليه ويرجع
إليه بالمغفرة والرحمة لأن الله غفور رحيم، قال تعالى: ﴿ما يفعل الله
بعذابكم إن شكرتم وءامنتم وكان الله شاكرا عليما﴾: النساء: 174.
وفي الآية أبحاث أخر كثيرة فقهية للطالب أن يراجع فيها كتب الفقه.
قوله تعالى: ﴿أ لم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض﴾ الآية في موضع
التعليل لما ذكر في الآية السابقة من قبول توبة السارق والسارقة إذا تابا
وأصلحا من بعد ظلمهما فإن الله سبحانه لما كان له ملك السموات والأرض،
وللملك أن يحكم في مملكته ورعيته بما أحب وأراد من عذاب أو رحمة كان له
تعالى أن يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء على حسب الحكمة والمصلحة فيعذب
السارق والسارقة إن لم يتوبا ويغفر لهما إن تابا.
وقوله: ﴿والله على كل شيء قدير﴾ في موضع التعليل لقوله: ﴿له ملك السموات
والأرض﴾ فإن الملك بضم الميم من شئون القدرة كما أن الملك بكسر الميم من
فروع الخلق والإيجاد أعني القيمومة الإلهية.
بيان ذلك: أن الله تعالى خالق الأشياء وموجدها فما من شيء إلا وما له من
نفسه وآثار نفسه لله سبحانه، هو المعطي لما أعطى والمانع لما منع، فله أن
يتصرف في كل شيء، وهذا هو الملك بكسر الميم قال تعالى: ﴿قل الله خالق كل
شيء وهو الواحد القهار﴾: الرعد: 16، وقال: ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض﴾: البقرة: 255 وهو
تعالى مع ذلك قادر على أي تصرف شاء وأراد إذ كلما فرض من شيء فهو منه فله
مضي الحكم ونفوذ الإرادة وهو الملك بضم الميم والسلطنة على كل شيء فهو
تعالى مالك لأنه قيوم على كل شيء، وملك لأنه قادر غير عاجز ولا ممنوع من
نفوذ مشيئته وإرادته.
بحث روائي:
في الكافي، بإسناده عن أبي صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قدم
على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قوم من بني ضبة مرضى فقال لهم
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أقيموا عندي فإذا برأتم بعثتكم في
سرية، فقالوا: أخرجنا من المدينة، فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من
أبوالها، ويأكلون من ألبانها فلما برءوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كان في
الإبل فبلغ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فبعث إليهم عليا (عليه
السلام) وإذا هم في واد قد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه قريبا من أرض
اليمن فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فنزلت هذه
الآية: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله - ويسعون في الأرض فسادا أن
يقتلوا أو يصلبوا - أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف﴾: . أقول: ورواه في
التهذيب، بإسناده عن أبي صالح عنه (عليه السلام)، باختلاف يسير، ورواه
العياشي، في تفسيره عنه (عليه السلام): وزاد في آخره فاختار رسول الله (صلى
الله عليه وآله وسلم) أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، والقصة مروية في
جوامع أهل السنة ومنها الصحاح الستة بطرق على اختلاف في خصوصياتها، ومنها
ما وقع في بعضها أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد أن ظفر بهم
قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم، وفي بعضها: فقتل النبي (صلى الله
عليه وآله وسلم) منهم وصلب وقطع وسمل الأعين، وفي بعضها: أنه سمل أعينهم
لأنهم سملوا أعين الرعاة، وفي بعضها: أن الله نهاه عن سمل الأعين، وأن
الآية نزلت معاتبة لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أمر هذه
المثلة، وفي بعضها: أنه أراد أن يسمل أعينهم ولم يسمل، إلى غير ذلك.
والروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) خالية عن ذكر سمل الأعين.
وفي الكافي، بإسناده عن عمرو بن عثمان بن عبيد الله المدائني عن أبي الحسن
الرضا (عليه السلام) قال: سئل عن قول الله عز وجل: ﴿إنما جزاء الذين
يحاربون الله ورسوله - ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا﴾ الآية فما الذي
إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ فقال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في
الأرض فسادا فقتل قتل به، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم
يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن شهر السيف فحارب الله ورسوله وسعى في
الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض. قلت كيف ينفى من الأرض
وما حد نفيه؟ قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره، ويكتب
إلى أهل ذلك المصر أنه منفي فلا تجالسوه ولا ت

عوه
ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فإن خرج من ذلك
المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت: فإن توجه إلى أرض
الشرك ليدخلها؟ قال: إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها: . أقول:
ورواه الشيخ في التهذيب، والعياشي في تفسيره عن أبي إسحاق المدائني عنه
(صلى الله عليه وآله وسلم) والروايات في هذه المعاني مستفيضة عن أئمة أهل
البيت (عليهم السلام) وكذا روي ذلك بعدة طرق من طرق أهل السنة، وفي بعض
رواياتهم أن الإمام بالخيار إن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء قطع الأيدي
والأرجل من خلاف وإن شاء نفى، ونظيره ما وقع في بعض روايات الخاصة من كون
الإمام بالخيار كالذي رواه في الكافي، مسندا عن جميل بن دراج عن الصادق
(عليه السلام): في الآية قال فقلت: أي شيء عليهم من هذه الحدود التي سمى
الله عز وجل؟ قال: ذلك إلى الإمام إن شاء قطع، وإن شاء نفى، وإن شاء صلب،
وإن شاء قتل: قلت: النفي إلى أين؟ قال (عليه السلام) ينفى من مصر إلى آخر،
وقال: إن عليا (عليه السلام) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.
وتمام الكلام في الفقه غير أن الآية لا تخلو عن إشعار بالترتيب بين الحدود
بحسب اختلاف مراتب الفساد فإن الترديد بين القتل والصلب والقطع والنفي -
وهي أمور غير متعادلة ولا متوازنة بل مختلفة من حيث الشدة والضعف - قرينة
عقلية على ذلك.
كما أن ظاهر الآية أنها حدود للمحاربة والفساد فمن شهر سيفا وسعى في الأرض
فسادا أو قتل نفسا فإنما يقتل لأنه محارب مفسد وليس ذلك قصاصا يقتص منه
لقتل النفس المحترمة فلا يسقط القتل لو رضي أولياء المقتول بالدية كما رواه
العياشي في تفسيره، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، وفيه: قال
أبو عبيدة: أصلحك الله أ رأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفر
(عليه السلام): إن عفوا عنه فعلى الإمام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق،
فقال أبو عبيدة: فإن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه أ
لهم ذلك؟ قال: لا، عليه القتل.
وفي الدر المنثور، أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في كتاب
الأشراف وابن جرير وابن أبي حاتم عن الشعبي قال: كان حارثة بن بدر التميمي
من أهل البصرة قد أفسد في الأرض وحارب، وكلم رجالا من قريش أن يستأمنوا له
عليا فأبوا فأتى سعيد بن قيس الهمداني فأتى عليا فقال: يا أمير المؤمنين
ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا؟ قال: أن يقتلوا
أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ثم قال: إلا
الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فقال سعيد: وإن كان حارثة بن بدر،
فقال سعيد: هذا حارثة بن بدر قد جاء تائبا فهو آمن؟ قال: نعم، قال: فجاء به
إليه ف

عه وقبل ذلك منه وكتب له أمانا.
أقول: قول سعيد في الرواية: ﴿وإن كان حارثة بن بدر﴾ ضميمة ضمها إلى الآية
لإبانة إطلاقها لكل تائب بعد المحاربة والإفساد وهذا كثير في الكلام.
وفي الكافي، بإسناده عن سورة بني كليب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد حاجة فيلقاه رجل فيستقفيه
فيضربه فيأخذ ثوبه؟ قال: أي شيء يقول فيه من قبلكم؟ قلت: يقولون: هذه ذعارة
معلنة وإنما المحارب في قرى مشركة، فقال: أيها أعظم حرمة: دار الإسلام أو
دار الشرك؟ قال: فقلت: دار الإسلام فقال: هؤلاء من أهل هذه الآية: ﴿إنما
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾ إلى آخر الآية.
أقول: ما أشار إليه الراوي من قول القوم هو الذي وقع في بعض روايات الجمهور
كما في بعض روايات سبب النزول عن الضحاك قال: نزلت هذه الآية في المشركين،
وما في
تفسير الطبري: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية فكتب إليه
أنس يخبره: أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر من العرنيين وهم من بجيلة،
قال أنس: فارتدوا عن الإسلام، وقتلوا الراعي، واستاقوا الإبل، وأخافوا
السبيل، وأصابوا الفرج الحرام فسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
جبرئيل عن القضاء فيمن حارب فقال: من سرق وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام
فاصلبه، إلى غير ذلك من الروايات.
والآية بإطلاقها يؤيد ما في خبر الكافي، ومن المعلوم أن سبب النزول لا يوجب تقيد ظاهر الآية.
وفي
تفسير القمي: في قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله - وابتغوا إليه الوسيلة﴾ الآية قال: فقال: تقربوا إليه بالإمام.
أقول: أي بطاعته فهو من قبيل الجري والانطباق على المصداق، ونظيره ما عن
ابن شهر آشوب قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في قوله تعالى:
﴿وابتغوا إليه الوسيلة﴾: أنا وسيلته: . وقريب منه ما في بصائر الدرجات،
بإسناده عن سلمان عن علي (عليه السلام)، ويمكن أن يكون الروايتان من قبيل
التأويل فتدبر فيهما.
وفي المجمع: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): سلوا الله لي الوسيلة
فإنها درجة في الجنة لا ينالها إلا عبد واحد وأرجو أن أكون أنا هو.
وفي المعاني، بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم): إذا سألتم الله فاسألوا لي الوسيلة، فسألنا النبي (صلى
الله عليه وآله وسلم) عن الوسيلة، فقال: هي درجتي في الجنة الحديث وهو طويل
معروف بحديث الوسيلة.
وأنت إذا تدبرت الحديث، وانطباق معنى الآية عليه وجدت أن الوسيلة هي مقام
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من ربه الذي به يتقرب هو إليه تعالى،
ويلحق به آله الطاهرون ثم الصالحون من أمته، وقد ورد في بعض الروايات عنهم
(عليهم السلام): أن رسول الله آخذ بحجزة ربه ونحن آخذون بحجزته، وأنتم
آخذون بحجزتنا.
وإلى ذلك يرجع ما ذكرناه في روايتي القمي وابن شهر آشوب أن من المحتمل أن
تكونا من التأويل، ولعلنا نوفق لشرح هذا المعنى في موضع يناسبه مما سيأتي.
ومن الملحق بهذه الروايات ما رواه العياشي عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر
(عليه السلام) يقول: عدو علي هم المخلدون في النار قال الله: ﴿وما هم
بخارجين منها﴾.
وفي البرهان: في قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ الآية: عن
التهذيب، بإسناده عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: تقطع يد السارق ويترك
إبهامه وراحته، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها.
وفي التهذيب، أيضا بإسناده عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): في كم تقطع يد السارق؟ فقال: في ربع دينار. قال: قلت له: في
درهمين؟ فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ. قال: فقلت له: أ رأيت من
سرق أقل من ربع الدينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله
سارق في تلك الحال؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع
عليه اسم السارق، وهو عند الله سارق ولكن لا تقطع إلا في ربع دينار أو
أكثر، ولو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس
مقطعين.
أقول: يريد (عليه السلام) بقوله: ولو قطعت يد السارق إلخ أن في حكم القطع
تخفيفا من الله رحمة منه لعباده، وهذا المعنى أعني اختصاص الحكم بسرقة ربع
دينار أو أكثر مروي ببعض طرق الجمهور أيضا ففي صحيحي البخاري ومسلم،
بإسنادهما عن عائشة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: لا يقطع
يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا.
وفي
تفسير العياشي، عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه قال: إذا أخذ
السارق فقطع وسط الكف فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السجن
فإن سرق في السجن قتل.
وفيه، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): عن رجل سرق وقطعت يده اليمنى ثم
سرق فقطعت رجله اليسرى ثم سرق الثالثة؟ قال: كان أمير المؤمنين (عليه
السلام) يخلده في السجن ويقول: إني لأستحيي من ربي أن أدعه بلا يد يستنظف
بها ولا رجل يمشي بها إلى حاجته.
قال: فكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، وإذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين قال: وكان لا يرى أن يغفل عن شيء من الحدود.
وفيه: عن زرقان صاحب ابن أبي دواد وصديقه بشدة قال: رجع ابن أبي دواد ذات
يوم من عند المعتصم، وهو مغتم فقلت له في ذلك فقال: وددت اليوم أني قدمت
منذ عشرين سنة قال: قلت له: ولم ذاك؟ قال: لما كان من هذا الأسود أبا جعفر
محمد بن علي بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين المعتصم قال: قلت: وكيف
كان ذلك؟ قال: إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة
الحد عليه فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه، وقد أحضر محمد بن علي فسألنا عن
القطع في أي موضع يجب أن يقطع؟ قال: فقلت: من الكرسوع لقول الله في التيمم:
﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾ واتفق معي على ذلك قوم. وقال آخرون: بل يجب
القطع من المرفق قال: وما الدليل على ذلك؟ قالوا: لأن الله لما قال:
﴿وأيديكم إلى المرافق﴾ في الغسل دل على ذلك أن حد اليد هو المرفق. قال:
فالتفت إلى محمد بن علي فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ فقال: قد تكلم
القوم فيه يا أمير المؤمنين قال: دعني بما تكلموا به أي شيء عندك؟ قال:
اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك
فيه، فقال. أما إذا أقسمت علي بالله إني أقول: إنهم أخطئوا فيه السنة، فإن
القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فتترك الكف، قال: وما الحجة في
ذلك؟ قال: قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): السجود على سبعة
أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، والرجلين فإذا قطعت يده من الكرسوع أو
المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿وأن المساجد
لله﴾ يعني هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها ﴿فلا تدعوا مع الله أحدا﴾
وما كان لله لم يقطع. قال: فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل
الأصابع دون الكف. قال ابن أبي دواد: قامت قيامتي وتمنيت أني لم أك حيا.
قال ابن أبي زرقان: إن ابن أبي دواد قال: صرت إلى المعتصم بعد ثالثة فقلت:
إن نصيحة أمير المؤمنين علي واجبة وأنا أكلمه بما أعلم أني أدخل به النار
قال: وما هو؟ قلت: إذا جمع أمير المؤمنين في مجلسه فقهاء رعيته وعلماءهم
لأمر واقع من أمور الدين فسألهم عن الحكم فيه فأخبروه بما عندهم من الحكم
في ذلك، وقد حضر المجلس بنوه وقواده ووزراؤه وكتابه، وقد تسامع الناس بذلك
من وراء بابه ثم يترك أقاويلهم كلهم لقول رجل يقول شطر هذه الأمة بإمامته،
ويدعون أنه أولى منه بمقامه ثم يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء؟ قال: فتغير
لونه، وانتبه لما نبهته له، وقال: جزاك الله عن نصيحتك خيرا. قال: فأمر
اليوم الرابع فلانا من كتاب وزرائه بأن يدعوه إلى منزله فدعاه فأبى أن
يجيبه، وقال: قد علمت أني لا أحضر مجالسكم فقال: إني إنما أدعوك إلى الطعام
وأحب أن تطأ ثيابي وتدخل منزلي فأتبرك بذلك وقد: أحب فلان بن فلان من
وزراء الخليفة لقائك فصار إليه فلما أطعم منها أحس مآلم السم فدعا بدابته
فسأله رب المنزل أن يقيم قال: خروجي من دارك خير لك، فلم يزل يومه ذلك
وليلته في خلفه حتى قبض.
أقول: ورويت القصة بغيره من الطرق، وإنما أوردنا الرواية بطولها كبعض ما
تقدمها من الروايات المتكررة لاشتمالها على أبحاث قرآنية دقيقة يستعان بها
على فهم الآيات.
وفي الدر المنثور، أخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمر:
أن امرأة سرقت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقطعت يدها
اليمنى فقالت: هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: نعم أنت اليوم من خطيئتك
كيوم ولدتك أمك، فنزل الله في سورة المائدة: ﴿فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح
فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم﴾.
أقول: الرواية من قبيل التطبيق واتصال الآية بما قبلها، ونزولهما معا ظاهر.







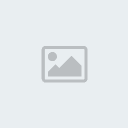

 عوه
عوه

