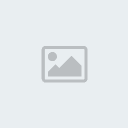•
الآيات 4-5
يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ
وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ
مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ
وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ
سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿4﴾ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ
الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن
يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ﴿5﴾
بيان:
قوله تعالى: ﴿يسألونك ما ذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات﴾ سؤال مطلق أوجب
عنه بجواب عام مطلق فيه إعطاء الضابط الكلي الذي يميز الحلال من الحرام،
وهو أن يكون ما يقصد التصرف فيه بما يعهد في مثله من التصرفات أمرا طيبا،
وإطلاق الطيب أيضا من غير تقييده بشيء يوجب أن يكون المعتبر في تشخيص طيبه
استطابة الأفهام المتعارفة ذلك فما يستطاب عند الأفهام العادية فهو طيب،
وجميع ما هو طيب حلال.
وإنما نزلنا الحلية والطيب على المتعارف المعهود لمكان أن الإطلاق لا يشمل غيره على ما بين في فن الأصول.
قوله تعالى: ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا
مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه﴾ قيل: إن الكلام معطوف على موضع
الطيبات أي وأحل لكم ما علمتم من الجوارح أي صيد ما علمتم من الجوارح،
فالكلام بتقدير مضاف محذوف اختصارا لدلالة السياق عليه.
والظاهر أن الجملة معطوفة على موضع الجملة الأولى.
و﴿ما﴾ في قوله: ﴿وما علمتم﴾ شرطية وجزاؤها قوله ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ من غير حاجة إلى تكلف التقدير.
والجوارح جمع جارحة وهي التي تكسب الصيد من الطير والسباع كالصقر والبازي
والكلاب والفهود، وقوله: ﴿مكلبين﴾ حال، وأصل التكليب تعليم الكلاب وتربيتها
للصيد أو اتخاذ كلاب الصيد وإرسالها لذلك، وتقييد الجملة بالتكليب لا يخلو
من دلالة على كون الحكم مختصا بكلب الصيد لا يعدوه إلى غيره من الجوارح.
وقوله: ﴿مما أمسكن عليكم﴾ التقييد بالظرف للدلالة على أن الحل محدود بصورة صيدها لصاحبها لا لنفسها.
وقوله: ﴿واذكروا اسم الله عليه﴾ تتميم لشرائط الحل وأن يكون الصيد مع كونه
مصطادا بالجوارح ومن طريق التكليب والإمساك على الصائد مذكورا عليه اسم
الله تعالى.
ومحصل المعنى أن الجوارح المعلمة بالتكليب - أي كلاب الصيد - إذا كانت
معلمة واصطادت لكم شيئا من الوحش الذي يحل أكله بالتذكية وقد سميتم عليه
فكلوا منه إذا قتلته دون أن تصلوا إليه فذلك تذكية له، وأما دون القتل
فالتذكية بالذبح والإهلال به لله يغني عن هذا الحكم.
ثم ذيل الكلام بقوله: ﴿واتقوا الله إن الله سريع الحساب﴾ إشعارا بلزوم
اتقاء الله فيه حتى لا يكون الاصطياد إسرافا في القتل، ولا عن تله وتجبر
كما في صيد اللهو ونحوه فإن الله سريع الحساب يجازي سيئة الظلم والعدوان في
الدنيا قبل الآخرة، ولا يسلك أمثال هذه المظالم والعدوانات بالاغتيال
والفك بالحيوان العجم إلا إلى عاقبة سوأى على ما شاهدنا كثيرا.
قوله تعالى: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم
وطعامكم حل لهم﴾ إعادة ذكر حل الطيبات مع ذكره في الآية السابقة، وتصديره
بقوله: ﴿اليوم﴾ للدلالة على الامتنان منه تعالى على المؤمنين بإحلال طعام
أهل الكتاب والمحصنات من نسائهم للمؤمنين.
وكان ضم قوله: ﴿أحل لكم الطيبات﴾ إلى قوله: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب﴾ إلخ
من قبيل ضم المقطوع به إلى المشكوك فيه لإيجاد الطمأنينة في نفس المخاطب
وإزالة ما فيه من القلق والاضطراب كقول
السيد لخادمه: لك جميع ما ملكتكه وزيادة هي كذا وكذا فإنه إذا ارتاب في تحقق ما
يعده سيده من الإعطاء شفع ما يشك فيه بما يقطع به ليزول عن نفسه أذى الريب
إلى راحة العلم، ومن هذا الباب يوجه قوله تعالى: ﴿للذين أحسنوا الحسنى
وزيادة﴾: يونس: 26 وقوله تعالى: ﴿لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد﴾: ق: 35.
فكان نفوس المؤمنين لا تسكن عن اضطراب الريب في أمر حل طعام أهل الكتاب لهم
بعد ما كانوا يشاهدون التشديد التام في معاشرتهم ومخالطتهم ومساسهم
وولايتهم حتى ضم إلى حديث حل طعامهم أمر حل الطيبات بقول مطلق ففهموا منه
أن طعامهم من سنخ سائر الطيبات المحللة فسكن بذلك طيش نفوسهم، واطمأنت
قلوبهم وكذلك القول في قوله: ﴿والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين
أوتوا الكتاب من قبلكم﴾. وأما قوله: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم
وطعامكم حل لهم﴾ فالظاهر أنه كلام واحد ذو مفاد واحد، إذ من المعلوم أن
قوله: ﴿وطعامكم حل لهم﴾ ليس في مقام تشريع حكم الحل لأهل الكتاب، وتوجيه
التكليف إليهم وإن قلنا بكون الكفار مكلفين بالفروع الدينية كالأصول، فإنهم
غير مؤمنين بالله ورسوله وبما جاء به رسوله ولا هم يسمعون ولا هم يقبلون،
وليس من دأب
القرآن أن يوجه خطابا أو يذكر حكما إذا استظهر من المقام أن الخطاب معه يكون لغوا والتكليم معه يذهب سدى.
اللهم إلا إذا أصلح ذلك بشيء من فنون التكليم كالالتفات من خطاب الناس إلى
خطاب النبي ونحو ذلك كقوله: ﴿قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا
وبينكم﴾: آل عمران: 64 وقوله: ﴿قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا﴾:
إسراء: 93 إلى غير ذلك من الآيات.
وبالجملة ليس المراد بقوله: ﴿وطعام الذين﴾، بيان حل طعام أهل الكتاب
للمسلمين حكما مستقلا وحل طعام المسلمين لأهل الكتاب حكما مستقلا آخر، بل
بيان حكم واحد وهو ثبوت الحل وارتفاع الحرمة عن الطعام، فلا منع في البين
حتى يتعلق بأحد الطرفين نظير قوله تعالى: ﴿فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن
إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن﴾: الممتحنة: 10 أي لا حل في
البين حتى يتعلق بأحد الطرفين.
ثم إن الطعام بحسب أصل اللغة كل ما يقتات به ويطعم لكن قيل: إن المراد به
البر وسائر الحبوب ففي لسان العرب: وأهل الحجاز إذا أطلقوا اللفظ بالطعام
عنوا به البر خاصة.
قال: وقال الخليل: العالي في كلام العرب أن الطعام هو البر خاصة، انتهى.
وهو الذي يظهر من كلام ابن الأثير في النهاية، ولهذا ورد في أكثر الروايات
المروية عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام): أن المراد بالطعام في الآية هو
البر وسائر الحبوب إلا ما في بعض الروايات مما يظهر به معنى آخر وسيجيء
الكلام فيه في البحث الروائي الآتي.
وعلى أي حال لا يشمل هذا الحل ما لا يقبل التذكية من طعامهم كلحم الخنزير،
أو يقبلها من ذبائحهم لكنهم لم يذكوها كالذي لم يهل به لله، ولم يذك تذكية
إسلامية فإن الله سبحانه عد هذه المحرمات المذكورة في آيات التحريم - وهي
الآي الأربع التي في سور البقرة والمائدة والأنعام والنحل - رجسا وفسقا
وإثما كما بيناه فيما مر، وحاشاه سبحانه أن يحل ما سماه رجسا أو فسقا أو
إثما امتنانا بمثل قوله ﴿اليوم أحل لكم الطيبات﴾.
على أن هذه المحرمات بعينها واقعة قبيل هذه الآية في نفس السورة، وليس لأحد
أن يقول في مثل المورد بالنسخ وهو ظاهر، وخاصة في مثل سورة
المائدة التي ورد فيها أنها ناسخة غير منسوخة.
قوله تعالى: ﴿والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من
قبلكم﴾، الإتيان في متعلق الحكم بالوصف أعني ما في قوله: ﴿الذين أوتوا
الكتاب﴾ من غير أن يقال: من اليهود والنصارى مثلا أو يقال: من أهل الكتاب،
لا يخلو من إشعار بالعلية واللسان لسان الامتنان، والمقام مقام التخفيف
والتسهيل، فالمعنى: أنا نمتن عليكم بالتخفيف والتسهيل في رفع حرمة الازدواج
بين رجالكم والمحصنات من نساء أهل الكتاب لكونهم أقرب إليكم من سائر
الطوائف غير المسلمة، وهم أوتوا الكتاب وأذعنوا بالتوحيد والرسالة بخلاف
المشركين والوثنيين المنكرين للنبوة، ويشعر بما ذكرنا أيضا تقييد قوله:
﴿أوتوا الكتاب﴾ بقوله: ﴿من قبلكم﴾ فإن فيه إشعارا واضحا بالخطط والمزج
والتشريك.
وكيف كان لما كانت الآية واقعة موقع الامتنان والتخفيف لم تقبل النسخ بمثل
قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾: البقرة: 212 وقوله تعالى:
﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾: الممتحنة: 10 وهو ظاهر.
على أن الآية الأولى واقعة في سورة البقرة، وهي أول سورة مفصلة نزلت
بالمدينة قبل المائدة: وكذا الآية الثانية واقعة في سورة الممتحنة، وقد
نزلت بالمدينة قبل الفتح، فهي أيضا قبل
المائدة نزولا، ولا وجه لنسخ السابق للاحق مضافا إلى ما ورد: أن
المائدة آخر ما نزلت على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فنسخت ما قبلها، ولم ينسخها شيء.
على أنك قد عرفت في الكلام على قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى
يؤمن﴾: الآية البقرة: 212 في الجزء الثاني من الكتاب أن الآيتين أعني آية
البقرة وآية الممتحنة أجنبيتان من الدلالة على حرمة نكاح الكتابية.
ولو قيل بدلالة آية الممتحنة بوجه على التحريم كما يدل على سبق المنع الشرعي ورود آية
المائدة في مقام الامتنان والتخفيف - ولا امتنان ولا تخفيف لو لم يسبق منع - كانت آية
المائدة هي الناسخة لآية الممتحنة لا بالعكس لأن النسخ شأن المتأخر، وسيأتي في البحث الروائي كلام في الآية الثانية.
ثم المراد بالمحصنات في الآية: العفائف وهو أحد معان الإحصان، وذلك أن
قوله: ﴿والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب﴾، يدل على
أن المراد بالمحصنات غير ذوات الأزواج وهو ظاهر، ثم الجمع بين المحصنات من
أهل الكتاب والمؤمنات على ما مر من توضيح معناها يقضي بأن المراد بالمحصنات
في الموضعين معنى واحد، وليس هو الإحصان بمعنى الإسلام لمكان قوله:
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وليس المراد بالمحصنات الحرائر فإن
الامتنان المفهوم من الآية لا يلائم تخصيص الحل بالحرائر دون الإماء، فلم
يبق من معاني الإحصان إلا العفة فتعين أن المراد بالمحصنات العفائف.
وبعد ذلك كله إنما تصرح الآية بتشريع حل المحصنات من أهل الكتاب للمؤمنين
من غير تقييد بدوام أو انقطاع إلا ما ذكره من اشتراط الأجر وكون التمتع
بنحو الإحصان لا بنحو المسافحة واتخاذ الأخدان، فينتج أن الذي أحل للمؤمنين
منهن أن يكون على طريق النكاح عن مهر وأجر دون السفاح، من غير شرط آخر من
نكاح دوام أو انقطاع، وقد تقدم في قوله تعالى: ﴿فما استمتعتم به منهن
فأتوهن﴾: الآية النساء: 24 في الجزء الرابع من الكتاب أن المتعة نكاح
كالنكاح الدائم، وللبحث بقايا تطلب من علم الفقه.
قوله تعالى: ﴿إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان﴾
الآية في مساق قوله تعالى في آيات محرمات النكاح: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلك أن
تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين﴾: النساء: 24. والجملة قرينة على كون
المراد بالآية بيان حلية التزوج بالمحصنات من أهل الكتاب من غير شمول منها
لملك اليمين.
قوله تعالى: ﴿ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين﴾
الكفر في الأصل هو الستر فتحقق مفهومه يتوقف على أمر ثابت يقع عليه الستر
كما أن الحجاب لا يكون حجابا إلا إذا كان هناك محجوب فالكفر يستدعي مكفورا
به ثابتا كالكفر بنعمة الله والكفر بآيات الله والكفر بالله ورسوله واليوم
الآخر.
فالكفر بالإيمان يقتضي وجود إيمان ثابت، وليس المراد به المعنى المصدري من
الإيمان بل معنى اسم المصدر وهو الأثر الحاصل والصفة الثابتة في قلب المؤمن
أعني الاعتقادات الحقة التي هي منشأ الأعمال الصالحة، فيئول معنى الكفر
بالإيمان إلى ترك العمل بما يعلم أنه حق كتولي المشركين، والاختلاط بهم،
والشركة في أعمالهم مع العلم بحقية الإسلام، وترك الأركان الدينية من
الصلاة والزكاة والصوم والحج مع العلم بثبوتها أركانا للدين.
فهذا هو المراد من الكفر بالإيمان لكن هاهنا نكتة وهي أن الكفر لما كان
سترا وستر الأمور الثابتة لا يصدق بحسب ما يسبق إلى الذهن إلا مع المداومة
والمزاولة فالكفر بالإيمان إنما يصدق إذا ترك الإنسان العمل بما يقتضيه
إيمانه، ويتعلق به علمه، ودام عليه، وأما إذا ستر مرة أو مرتين من غير أن
يدوم عليه فلا يصدق عليه الكفر وإنما هو فسق أتى به.
ومن هنا يظهر أن المراد بقوله: ﴿ومن يكفر بالإيمان﴾ هو المداومة والاستمرار عليه وإن كان عبر بالفعل دون الوصف.
فتارك الاتباع لما حق عنده من الحق، وثبت عنده من أركان الدين كافر بالإيمان، حابط العمل كما قال تعالى: ﴿فقد حبط عمله﴾.
فالآية تنطبق على قوله تعالى: ﴿وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن
يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين
والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا
يعملون﴾: الأعراف: 174 فوصفهم باتخاذ سبيل الغي وترك سبيل الرشد بعد
رؤيتهما وهي العلم بهما ثم بدل ذلك بتوصيفهم بتكذيب الآيات، والآية إنما
تكون آية بعد العلم بدلالتها، ثم فسره بتكذيب الآخرة لما أن الآخرة لو لم
تكذب منع العلم بها عن ترك الحق، ثم أخبر بحبط أعمالهم.
ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم
ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا﴾: الكهف: 150 وانطباق
الآيات على مورد الكفر بالإيمان بالمعنى الذي تقدم بيانه ظاهر.
وبالتأمل فيما ذكرنا يظهر وجه اتصال الجملة أعني قوله: ﴿ومن يكفر بالإيمان
فقد حبط عمله﴾، بما قبله فالجملة متممة للبيان السابق، وهي في مقام التحذير
عن الخطر الذي يمكن أن يتوجه إلى المؤمنين بالتساهل في أمر الله،
والاسترسال مع الكفار فإن الله سبحانه إنما أحل طعام أهل الكتاب والمحصنات
من نسائهم للمؤمنين ليكون ذلك تسهيلا وتخفيفا منه لهم، وذريعة إلى انتشار
كلمة التقوى، وسراية الأخلاق الطاهرة الإسلامية من المسلمين المتخلقين بها
إلى غيرهم، فيكون داعية إلى العلم النافع، وباعثة نحو العمل الصالح.
فهذا هو الغرض من التشريع لا لأن يتخذ ذلك وسيلة إلى السقوط في مهابط
الهوى، والإصعاد في أودية الهوسات، والاسترسال في حبهن والغرام بهن،
والتوله في جمالهن، فيكن قدوة تتسلط بذلك أخلاقهن وأخلاق قومهن على أخلاق
المسلمين، ويغلب فسادهن على صلاحهم، ثم يكون البلوى ويرجع المؤمنون إلى
أعقابهم القهقرى، ومآل ذلك عود هذه المنة الإلهية فتنة ومحنة مهلكة،
وصيرورة هذا التخفيف الذي هو نعمة نقمة.
فحذر الله المؤمنين بعد بيان حلية طعامهم والمحصنات من نسائهم أن لا
يسترسلوا في التنعم بهذه النعمة استرسالا يؤدي إلى الكفر بالإيمان، وترك
أركان الدين، والإعراض عن الحق فإن ذلك يوجب حبط العمل، وينجر إلى خسران
السعي في الآخرة.
واعلم أن للمفسرين في هذه الآية أعني قوله: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات﴾ إلى
آخر الآية خوضا عظيما ردهم إلى تفاسير عجيبة لا يحتملها ظاهر اللفظ،
وينافيها سياق الآية كقول بعضهم: إن قوله: ﴿أحل لكم الطيبات﴾ يعني من
الطعام كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، وقول بعضهم: إن قوله: ﴿وطعام
الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ أي بمقتضى الأصل الأولي لم يحرمه الله عليكم
قط، وإن اللحوم من الحل وإن لم يذكوها إلا بما عندهم من التذكية، وقول
بعضهم: إن المراد بقوله: ﴿وطعام الذين﴾ هو مؤاكلتهم، وقول بعضهم: إن المراد
بقوله: ﴿والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾
بيان الحلية بحسب الأصل من غير أن يكون محرما قبل ذلك بل قوله تعالى:
﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾: النساء: 24 كاف في إحلالهن، وقول بعضهم: إن
المراد بقوله: ﴿ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله﴾ التحذير عن رد ما في صدر
الآية من قضية حل طعام أهل الكتاب والمحصنات من نسائهم.
فهذه وأمثالها معان احتملوها، وهي بين ما لا يخلو من مجازفة وتحكم كتقييد
قوله: ﴿اليوم أحل﴾، بما تقدم من غير دليل عليه وبين ما يدفعه ظاهر السياق
من التقييد باليوم والامتنان والتخفيف وغير ذلك مما تقدم بيانه والبيان
السابق الذي استظهرنا فيه باعتبار ظواهر
الآيات الكريمة كاف في إبطالها وإبانة وجه الفساد فيها.
وأما كون آية: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ دالة على حل نكاح الكتابية فظاهر
البطلان لظهور كون الآية في مقام بيان محرمات النساء ومحللاتهن بحسب طبقات
النسب والسبب لا بحسب طبقات الأديان والمذاهب.
بحث روائي:
في الدر المنثور: في قوله تعالى: ﴿يسألونك ما ذا أحل لهم﴾ الآية: أخرج ابن
جرير عن عكرمة: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعث أبا رافع في قتل
الكلاب فقتل حتى بلغ العوالي، فدخل عاصم بن عدي وسعد بن خيثمة وعويم بن
ساعدة فقالوا: ما ذا أحل لنا يا رسول الله؟ فنزلت: ﴿يسألونك ما ذا أحل لهم﴾
الآية.
وفيه، أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال: لما أمر النبي (صلى الله
عليه وآله وسلم) بقتل الكلاب قالوا: يا رسول الله ما ذا أحل لنا من هذه
الأمة؟ فنزلت: ﴿يسألونك ما ذا أحل لهم﴾ الآية.
أقول: الروايتان يشرح بعضهما بعضا فالمراد السؤال عما يحل لهم من الكلاب من
حيث اتخاذها واستعمالها في مآرب مختلفة كالصيد ونحوه، وقوله تعالى:
﴿يسألونك ما ذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات﴾ لا يلائم هذا المعنى لتقيدها
وإطلاق الآية.
على أن ظاهر الروايتين والرواية الآتية إن قوله: ﴿وما علمتم من الجوارح﴾
معطوف على موضع الطيبات، والمعنى: وأحل لكم ما علمتم، ولذلك التزم جمع من
المفسرين على تقدير ما فيه كما تقدم، وقد تقدم أن الظاهر كون قوله: ﴿وما
علمتم﴾ شرطا جزاؤه قوله: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾.
والمراد بالأمة المسئول عنها في الرواية نوع الكلاب على ما تفسره الرواية الآتية.
وفيه، أخرج الفاريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني
والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن أبي رافع قال: جاء جبرئيل إلى النبي
(صلى الله عليه وآله وسلم) فاستأذن عليه فأذن له فأبطأ فأخذ رداءه فخرج
فقال: قد أذنا لك قال: أجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة فنظروا
فإذا في بعض بيوتهم جرو. قال أبو رافع: فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة
ففعلت، وجاء الناس فقالوا: يا رسول الله ما ذا يحل لنا من هذه الأمة التي
أمرت بقتلها؟ فسكت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فأنزل الله: ﴿يسألونك
ما ذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات - وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾ فقال
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا أرسل الرجل كلبه وذكر اسم الله
فأمسك عليه فليأكل ما لم يأكل.
أقول ما ذكر في الرواية من كيفية نزول جبرئيل غريب في بابه على أن الرواية
لا تخلو عن اضطراب حيث تدل على إمساك جبرائيل عن الدخول على النبي (صلى
الله عليه وآله وسلم) لوجود جرو في بعض بيوتهم على أنها لا تنطبق على ظاهر
الآية من إطلاق السؤال والجواب والعطف الذي في قوله وما علمتم من الجوارح
فالرواية أشبه بالموضوعة.
وفيه، أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عامر: أن عدي بن حاتم الطائي أتى رسول
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فسأله عن صيد الكلاب فلم يدر ما يقول له
حتى أنزل الله عليه هذه الآية في
المائدة تعلمونهن مما علمكم الله.
أقول وفي معناه غيره من الأخبار والإشكال المتقدم آت فيه والظاهر أن هذه
الروايات وما في معناها من تطبيق الحوادث على الآية غير أنه تطبيق غير تام
والظاهر أنهم ذكروا له (صلى الله عليه وآله وسلم) صيد الكلاب ثم سألوه عن
ضابط كلي في تمييز الحلال من الحرام فذكر في الآية سؤالهم ثم أجيب بإعطاء
الضابط الكلي بقوله يسألونك ما ذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ثم أجيبوا في
خصوص ما تذاكروا فيه فهذا هو الذي يفيده لحن القول في الآية.
وفي الكافي، بإسناده عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
في كتاب علي (عليه السلام) في قوله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين
قال هي الكلاب: أقول: ورواه العياشي في تفسيره، عن سماعة بن مهران عنه
(عليه السلام). وفيه، بإسناده عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قال أبو عبد
الله (عليه السلام): كان أبي يفتي وكان يتقي ونحن نخاف في صيد البزاة
والصقور، فأما الآن فإنا لا نخاف ولا يحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته، فإنه في
كتاب علي (عليه السلام): أن الله عز وجل قال: ﴿وما علمتم من الجوارح
مكلبين﴾ في الكلاب. وفيه، بإسناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، قال: سألته عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب قال لا
تأكلوا إلا ما ذكيتم إلا الكلاب، قلت: فإن قتله؟ قال: كل فإن الله يقول:
﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين - تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن
عليكم﴾، ثم قال: كل شيء من السباع يمسك الصيد على نفسها إلا الكلاب معلمة؟
فإنها تمسك على صاحبها قال: وإذا أرسلت الكلب فاذكر اسم الله عليه فهو
ذكاته. وفي
تفسير العياشي، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل سرح الكلب
المعلم، ويسمي إذا سرحه، قال: يأكل مما أمسكن عليه وإن أدركه وقتله. وإن
وجد معه كلب غير معلم فلا تأكل منه. قلت: فالصقور والعقاب والبازي؟ قال: إن
أدركت ذكاته فكل منه، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه. قلت: فالفهد ليس
بمنزلة الكلب؟ قال: فقال: لا، ليس شيء مكلب إلا الكلب. وفيه، عن أبي بصير
عن أبي عبد الله (عليه السلام): في قول الله: ﴿ما علمتم من الجوارح مكلبين -
تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم - واذكروا اسم الله عليه﴾
قال: لا بأس بأكل ما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه فإذا أكل الكلب منه
قبل أن تدركه فلا تأكله.
أقول: والخصوصيات المأخوذة في الروايات كاختصاص الحل عند القتل بصيد الكلب
لقوله تعالى: ﴿مكلبين﴾ وقوله: ﴿مما أمسكن عليكم﴾ واشتراط أن لا يشاركه كلب
غير معلم كل ذلك مستفاد من الآية.
وقد تقدم بعض الكلام في ذلك.
وفيه، عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن كلب المجوس يكلبه
المسلم ويسمي ويرسله قال: نعم إنه مكلب إذا ذكر اسم الله عليه فلا بأس.
أقول: وفيه الأخذ بإطلاق قوله ﴿مكلبين﴾ وقد روي في الدر المنثور، عن ابن
أبي حاتم عن ابن عباس: في المسلم يأخذ كلب المجوسي المعلم أو بازه أو صقره
مما علمه المجوسي فيرسله فيأخذه قال: لا تأكله وإن سميت لأنه من تعليم
المجوسي وإنما قال: ﴿تعلمونهن مما علمكم الله﴾ وضعفه ظاهر، فإن الخطاب في
قوله: ﴿مما علمكم الله﴾ وإن كان متوجها إلى المؤمنين ظاهرا إلا أن الذي
علمهم الله مما يعلمونه الكلاب ليس غير ما علمه الله المجوس وغيرهم.
وهذا المعنى يساعد فهم السامع أن يفهم أن لا خصوصية لتعليم المؤمن من حيث
إنه تعليم المؤمن، فلا فرق في الكلب المعلم بين أن يكون معلمه مسلما أو غير
مسلم كما لا فرق من جهة الملك بين كونه مملوكا للمسلم ومملوكا لغيره.
وفي
تفسير العياشي، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام): في قول الله
تبارك وتعالى: ﴿وطعامهم حل لكم﴾ قال: العدس والحبوب وأشباه ذلك يعني أهل
الكتاب أقول: ورواه في التهذيب، عنه، ولفظه: قال: العدس والحمص وغير ذلك
وفي الكافي، والتهذيب، في روايات عن عمار بن مروان وسماعة عن أبي عبد الله
(عليه السلام): في طعام أهل الكتاب وما يحل منه، قال: الحبوب وفي الكافي،
بإسناده عن ابن مسكان، عن قتيبة الأعشى قال: سأل رجل أبا عبد الله وأنا
عنده فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فتذبح
أ يؤكل ذبيحته؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تدخل ثمنها في مالك
ولا تأكلها فإنما هي الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم، فقال له الرجل: قال
الله تعالى: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ فقال
أبو عبد الله (عليه السلام): كان أبي يقول: إنما هي الحبوب وأشباهها: .
أقول: ورواه الشيخ في التهذيب، والعياشي في تفسيره عن قتيبة الأعشى عنه
(عليه السلام).
والأحاديث - كما ترى - تفسر طعام أهل الكتاب المحلل في الآية بالحبوب
وأشباهها، وهو الذي يدل عليه لفظ الطعام عند الإطلاق كما هو ظاهر من
الروايات والقصص المنقولة عن الصدر الأول، ولذلك ذهب المعظم من علمائنا إلى
حصر الحل في الحبوبات وأشباهها وما يتخذ منها مما يتغذى به.
وقد شدد النكير عليهم بعضهم بأن ذلك مما يخالف عرف
القرآن في استعمال الطعام.
قال، ليس هذا هو الغالب في لغة القرآن، فقد قال الله تعالى في هذه السورة - أي
المائدة -: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة﴾ ولا يقول أحد: إن الطعام من صيد البحر هو البر أو الحبوب.
وقال: ﴿كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه﴾ ولم
يقل أحد: إن الطعام هنا البر أو الحب مطلقا، إذ لم يحرم شيء منه على بني
إسرائيل لا قبل التوراة ولا بعدها، فالطعام في الأصل كل ما يطعم أي يذاق أو
يؤكل، قال تعالى في ماء النهر حكاية عن طالوت: ﴿فمن شرب منه فليس مني ومن
لم يطعمه فإنه مني﴾، وقال: ﴿فإذا طعمتم فانتشروا﴾ أي أكلتم.
وليت شعري ما ذا فهم من قولهم: ﴿الطعام إذا أطلق كان المراد به الحبوب
وأشباهها﴾ فلم يلبث حتى أورد عليهم بمثل قوله: ﴿يطعمه﴾ وقوله: ﴿طعمتم﴾ من
مشتقات الفعل؟ وإنما قالوا ما قالوا في لفظ الطعام، لا في الأفعال المصوغة
منه.
وأورد بمثل: ﴿وطعام البحر﴾ والإضافة أجلى قرينة، فليس ينبت في البحر بر ولا شعير.
وأورد بمثل: ﴿كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل﴾ ثم ذكر هو نفسه أن من المعلوم من دينهم أنهم لم يحرم عليهم البر أو الحب.
وكان ينبغي عليه أن يراجع من
القرآن موارد أطلق اللفظ فيها إطلاقا ثم يقول ما هو قائله كقوله: ﴿فدية طعام
مسكين﴾: البقرة: 148 وقوله: ﴿أوكفارة طعام مساكين﴾: المائدة: 95 وقوله:
﴿ويطعمون الطعام﴾: الإنسان: 8 وقوله: ﴿فلينظر الإنسان إلى طعامه﴾: عبس: 24
ونحو ذلك.
ثم قال: وليس الحب مظنة للتحليل والتحريم، وإنما اللحم هو الذي يعرض له ذلك
لوصف حسي كموت الحيوان حتف أنفه، أو معنوي كالتقرب به إلى غير الله ولذلك
قال تعالى: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون
ميتة أو دما مسفوحا﴾: الآية الأنعام: 154 وكله يتعلق بالحيوان وهو نص في
حصر التحريم فيما ذكر، فتحريم ما عداه يحتاج إلى نص.
وكلامه هذا أعجب من سابقه: أما قوله: ليس الحب مظنة للتحليل والتحريم وإنما
اللحم هو الذي يعرض له ذلك، فيقال له: في أي زمان يعني ذلك؟ أ في مثل هذه
الأزمنة وقد استأنس الأذهان بالإسلام وعامة أحكامه منذ عدة قرون، أم في
زمان النزول ولم يمض من عمر الدين إلا عدة سنين؟ وقد سألوا النبي (صلى الله
عليه وآله وسلم) عن أشياء هي أوضح من حكم الحبوب وأشباهها وأجلى، وقد حكى
الله تعالى بعض ذلك كما في قوله: ﴿يسألونك ما ذا ينفقون﴾: البقرة: 251 وقد
روى عبد بن حميد عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجالا قالوا: كيف نتزوج نساءهم
وهم على دين ونحن على دين فأنزل الله: ﴿ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله﴾
الحديث.
وقد مر وسيجيء لهذا القول نظائر في تضاعيف الروايات كما نقلناه في حج التمتع وغير ذلك.
وإذا كانوا يقولون مثل هذا القول بعد نزول الآية بحلية المحصنات من نساء
أهل الكتاب فما الذي يمنعهم أن يسألوا قبل نزول الآية عن مؤاكلة أهل
الكتاب، والأكل مما يؤخذ منهم من الحبوب، والأغذية المتخذة من ذلك كالخبز
والهريسة وسائر الأغذية التي تتخذ من الحبوب وأمثالها إذا عملها أهل
الكتاب، وهم على دين، ونحن على دين وقد حذر الله المؤمنين عن موادتهم
وموالاتهم والاقتراب منهم، والركون إليهم في آيات كثيرة؟.
بل هذا الكلام مقلوب عليه في قوله: إن اللحم هو المظنة للتحريم والتحليل
فكيف يسعهم أن يسألوا عنه وقد بين الله عامة محرمات اللحوم في آية الأنعام:
﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه﴾: الأنعام: 154 ثم في آية
النحل وهما مكيتان، ثم في آية البقرة وهي قبل
المائدة نزولا، ثم في قوله: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ وهي قبل هذه الآية؟.
والآية على قول هذا القائل نص أو كالنص في عدم تحريم ذبائحهم، فكيف صح لهؤلاء أن يسألوا عن حلية ذبائح أهل الكتاب وقد نزلت
الآيات مكيتها ومدنيتها مرة بعد أخرى في أمرها ودلت على حليتها، واستقر العمل على حفظها وتلاوتها وتعلمها والعمل بها؟.
وأما قوله: إن آية الأنعام نص في حصر المحرمات فيما ذكر فيها فحرمه غيرها
كذبيحة أهل الكتاب يحتاج إلى دليل، فلا شك في احتياج كل حكم إلى دليل يقوم
عليه، وهذا الكلام صريح منه في أن هذا الحصر إنما ينفع إذا لم يكن هناك
دليل يقوم على تحريم أمر آخر وراء ما ذكر في الآية.
وعلى هذا فإن كان مراده بالدليل ما يشمل السنة فالقائل بتحريم ذبائح أهل
الكتاب يستند في ذلك إلى ما ورد من الروايات في الآية وقد نقلنا بعضا منها
فيما تقدم.
وإن أراد الدليل من الكتاب فمع أنه تحكم لا دليل عليه إذ السنة قرينة
الكتاب لا يفترقان في الحجية يسأل عنه ما ذا يقول في ذبيحة الكفار غير أهل
الكتاب كالوثنيين والماديين؟ أ فيحرمها لكونها ميتة فاقدة للتذكية الشرعية؟
فما الفرق بين عدم التذكية بعدم الاستقبال وعدم ذكر الله عليه أصلا وبين
التذكية التي هي غير التذكية الإسلامية وليس يرتضيها الله سبحانه وقد
نسخها؟ فالجميع خبائث في نظر الدين، وقد حرم الله الخبائث، قال تعالى:
﴿ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث﴾: الأعراف: 175 وقد قال تعالى في
الآية: ﴿السابقة على هذه الآية يسألونك ما ذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات﴾
ولحن السؤال والجواب فيها أوضح دليل على حصر الحل في الطيبات، وكذا ما في
أول هذه الآية من قوله: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات﴾ والمقام مقام الامتنان يدل
على الحصر المذكور.
وإن كان تحريم ذبائح الكفار لكونها بالإهلال به لغير الله كالذبح باسم
الأوثان عاد الكلام بعدم الفرق بين الإهلال به لغير الله، والإهلال به لله
على طريقة منسوخة لا يرتضيها الله سبحانه.
ثم قال: وقد شدد الله فيما كان عليه مشركوا العرب من أكل الميتة بأنواعها
المتقدمة والذبح للأصنام لئلا يتساهل به المسلمون الأولون تبعا للعادة،
وكان أهل الكتاب أبعد منهم عن أكل الميتة والذبح للأصنام.
وقد نسي أن النصارى من أهل الكتاب يأكلون لحم الخنزير، وقد ذكره الله تعالى
وشدد عليه، وأنهم يأكلون جميع ما تستبيحه المشركون لارتفاع التحريم عنهم
بالتفدية.
على أن هذا استحسان سخيف لا يجدي نفعا ولا يعول على مثله في
تفسير كلام الله وفهم معاني آياته، ولا في فقه أحكام دينه.
ثم قال: ولأنه كان من سياسة الدين التشديد في معاملة مشركي العرب حتى لا
يبقى في الجزيرة أحد إلا ويدخل في الإسلام وخفف في معاملة أهل الكتاب، ثم
ذكر موارد من فتيا بعض الصحابة بحلية ما ذبحوه للكنائس وغير ذلك.
وهذا الكلام منه مبني على ما يظهر من بعض الروايات أن الله اختار العرب على غيرهم من الأمم، وأن لهم كرامة على غيرهم.
ولذلك كانوا يسمون غيرهم بالموالي، ولا يلائمه ظاهر
الآيات القرآنية، وقد قال الله تعالى: ﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾: الحجرات: 13
ومن طرق أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أحاديث كثيرة في هذا المعنى.
ولم يجعل الإسلام في دعوته العرب في جانب وغيرهم في جانب، بل إنما جعل غير
أهل الكتاب من المشركين سواء كانوا عربا أو غيرهم في جانب، فلم يقبل منهم
إلا أن يسلموا ويؤمنوا، وأهل الكتاب سواء كانوا عربا أو غيرهم في جانب،
فقبل منهم الدخول في الذمة وإعطاء الجزية إلا أن يسلموا.
وهذا الوجه بعد تمامه لا يدل على أزيد من التساهل في حقهم في الجملة
لإبهامه، وأما أنه يجب أن يكون بإباحة ذبائحهم إذا ذبحوها على طريقتهم
وسنتهم فمن أين له الدلالة على ذلك؟ وهو ظاهر.
وأما ما ذكره من عمل بعض الصحابة وقولهم إلى غير ذلك فلا حجية فيه.
فقد تبين من جميع ما تقدم عدم دلالة الآية ولا أي دليل آخر على حلية ذبائح أهل الكتاب إذا ذبحت بغير التذكية الإسلامية.
فإن قلنا بحلية ذبائحهم للآية كما نقل عن بعض أصحابنا فلنقيدها بما إذا علم
وقوع الذبح عن تذكية شرعية كما يظهر من قول الصادق (عليه السلام) في خبر
الكافي، والتهذيب، المتقدم: ﴿فإنما هي الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم﴾
الحديث.
وللكلام تتمة تطلب من الفقه.
وفي
تفسير العياشي، عن الصادق (عليه السلام): في قوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين
أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ الآية قال: هن العفائف وفيه، عنه (عليه السلام): في
قوله: ﴿والمحصنات من المؤمنات﴾ الآية قال: هن المسلمات. وفي
تفسير القمي، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: وإنما يحل نكاح أهل الكتاب الذين يؤدون الجزية، وغيرهم لم تحل مناكحتهم.
أقول: وذلك لكونهم محاربين حينئذ.
وفي الكافي، والتهذيب، عن الباقر (عليه السلام): إنما يحل منهن نكاح البله.
وفي الفقيه، عن الصادق (عليه السلام): في الرجل المؤمن يتزوج النصرانية
واليهودية قال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقيل:
يكون له فيها الهوى فقال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير
واعلم أن عليه في دينه غضاضة وفي التهذيب، عن الصادق (عليه السلام) قال: لا
بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة. وفي الفقيه، عن
الباقر (عليه السلام): أنه سئل عن الرجل المسلم أ يتزوج المجوسية؟ قال: لا،
ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها، ويعزل عنها، ولا يطلب
ولدها. وفي الكافي، بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في حديث: قال: وما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية
مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر. وفي الكافي، بإسناده عن زرارة، وفي
تفسير العياشي، عن مسعدة بن صدقة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله
تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ فقال: منسوخة بقوله:
﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾. أقول: ويشكل بتقدم قوله: ﴿ولا تمسكوا﴾ الآية
على قوله: ﴿والمحصنات﴾ الآية نزولا ولا يجوز تقدم الناسخ على المنسوخ.
مضافا إلى ما ورد أن سورة
المائدة ناسخة غير منسوخة، وقد تقدم الكلام فيه.
ومن الدليل على أن الآية غير منسوخة ما تقدم من الرواية الدالة على جواز
التمتع بالكتابية وقد عمل بها الأصحاب وقد تقدم في آية المتعة أن التمتع
نكاح وتزويج.
نعم لو قيل بكون قوله: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ الآية مخصصا متقدما خرج
به النكاح الدائم من إطلاق قوله: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من
قبلكم﴾ لدلالته على النهي عن الإمساك بالعصمة، وهو ينطبق على النكاح الدائم
كما ينطبق على إبقاء عصمة الزوجية بعد إسلام الزوج وهو مورد نزول الآية.
ولا يصغى إلى قول من يعترض عليه بكون الآية نازلة في إسلام الزوج مع بقاء
الزوجة على الكفر، فإن سبب النزول لا يقيد اللفظ في ظهوره، وقد تقدم في
تفسير آية النسخ من سورة البقرة في الجزء الأول من الكتاب أن النسخ في عرف
القرآن وبحسب الأصل يعم غير النسخ المصطلح كالتخصيص.
وفي بعض الروايات أيضا أن الآية منسوخة بقوله: ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾ الآية وقد تقدم الإشكال فيه، وللكلام تتمة تطلب من الفقه.
وفي
تفسير العياشي: في قوله تعالى: ﴿ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله﴾ الآية: عن أبان
بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أدنى ما يخرج
به الرجل من الإسلام أن يرى الرأي بخلاف الحق فيقيم عليه قال: ﴿ومن يكفر
بالإيمان فقد حبط عمله﴾، وقال (عليه السلام): الذي يكفر بالإيمان الذي لا
يعمل بما أمر الله به ولا يرضى به. وفيه، عن محمد بن مسلم عن أحدهما
(عليهما السلام) قال: هو ترك العمل حتى يدعه أجمع.
أقول: وقد تقدم ما يتضح به ما في هذه الأخبار من خصوصيات التفسير.
وفيه، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله
عز وجل: ﴿ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله﴾ قال: ترك العمل الذي أقربه، من
ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولا شغل.
أقول: وقد سمى الله تعالى الصلاة إيمانا في قوله: ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾ البقرة: 134 ولعله (عليه السلام) خصها بالذكر لذلك.
وفي
تفسير القمي، قال (عليه السلام): من آمن ثم أطاع أهل الشرك وفي البصائر، عن أبي
حمزة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿ومن
يكفر بالإيمان فقد حبط عمله - وهو في الآخرة من الخاسرين﴾ قال: تفسيرها في
بطن القرآن: ومن يكفر بولاية علي. وعلي هو الإيمان.
أقول: هو من البطن المقابل للظهر بالمعنى الذي بيناه في الكلام على المحكم
والمتشابه في الجزء الثالث من الكتاب ويمكن أن يكون من الجري والتطبيق على
المصداق، وقد سمى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عليا (عليه السلام)
إيمانا حينما برز إلى عمرو بن عبد ود يوم الخندق حيث قال (صلى الله عليه
وآله وسلم): (برز الإيمان كله إلى الكفر كله).
وفي هذا المعنى بعض روايات أخر.