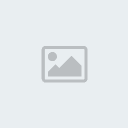•
الآيات 20-26
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ
عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاء وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم
مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّن الْعَالَمِينَ ﴿20﴾ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا
الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوا
عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿21﴾ قَالُوا يَا مُوسَى
إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىَ
يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿22﴾
قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا
ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ
غَالِبُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿23﴾
قَالُواْ يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا
فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿24﴾
قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ
بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿25﴾ قَالَ فَإِنَّهَا
مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلاَ
تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿26﴾
بيان:
الآيات غير خالية عن الاتصال بما قبلها فإنها تشتمل على نقضهم بعض المواثيق
المأخوذة عليهم وهو الميثاق بالسمع والطاعة لموسى، وتجبيههم موسى (عليه
السلام) بالرد الصريح لما دعاهم إليه وابتلائهم جزاء لذنبهم هذا بالتيه وهو
عذاب إلهي.
وفي بعض الأخبار ما يشعر أن هذه
الآيات نزلت قبل غزوة بدر في أوائل الهجرة، على ما ستجيء الإشارة إليها في البحث الروائي التالي إن شاء الله.
قوله تعالى: ﴿وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم﴾ إلى آخر الآية
الآيات النازلة في قصص موسى تدل على أن هذه القصة - دعوة موسى إياهم إلى دخول
الأرض المقدسة - إنما كانت بعد خروجهم من مصر، كما أن قوله في هذه الآية:
﴿وجعلكم ملوكا﴾ يدل على ذلك أيضا.
ويدل قوله: ﴿وءاتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين﴾ على سبق عدة من
الآيات النازلة عليهم كالمن والسلوى وانفجار العيون من الحجارة وإضلال الغمام.
ويدل قوله: ﴿القوم الفاسقين﴾ المتكرر مرتين على تحقق المخالفة ومعصية
الرسول منهم قبل القصة مرة بعد مرة حتى عادوا بذلك متلبسين بصفة الفسق.
فهذه قرائن تدل على وقوع القصة أعني قصة التيه في الشطر الأخير من زمان مكث
موسى (عليه السلام) فيهم بعد أن بعثه الله تعالى إليهم وأن غالب القصص
المقتصة في
القرآن عنهم إنما وقعت قبل ذلك.
فقول موسى لهم: ﴿اذكروا نعمة الله عليكم﴾ أريد به مجموع النعم التي أنعم
الله بها عليهم، وحباهم بها وإنما بدأ بذلك مقدمة لما سيندبهم إليه من دخول
الأرض المقدسة فذكرهم نعم ربهم لينشطوا بذلك لاستزادة النعمة واستتمامها
فإن الله قد كان أنعم عليهم ببعثة موسى وهذا يتهم إلى دينه، ونجاتهم من آل
فرعون، وإنزال التوراة، وتشريع الشريعة فلم يبق لهم من تمام النعمة إلا أن
يمتلكوا أرضا مقدسة يستقلون فيها بالقطون والسؤدد.
وقد قسم النعمة التي ذكرهم بها ثلاثة أقسام حين التفصيل فقال: ﴿إذ جعل فيكم
أنبياء﴾ وهم الأنبياء الذين في عمود نسبهم كإبراهيم وإسحاق ويعقوب ومن
بعدهم من الأنبياء، أو خصوص الأنبياء من بني إسرائيل كيوسف أو الأسباط
وموسى وهارون، والنبوة نعمة أخرى.
ثم قال: ﴿وجعلكم ملوكا﴾ أي مستقلين بأنفسكم خارجين من ذل استرقاق الفراعنة
وتحكم الجبابرة، وليس الملك إلا من استقل في أمر نفسه وأهله وماله، وقد كان
بنو إسرائيل في زمن موسى يسيرون بسنة اجتماعية هي أحسن السنن وهي سنة
التوحيد التي تأمرهم بطاعة الله ورسوله، والعدل التام في مجتمعهم، وعدم
الاعتداء على غيرهم من الأمم من غير أن يتأمر عليهم بعضهم أو يختلف طبقاتهم
اختلافا يختل به أمر المجتمع، وما عليهم إلا موسى وهو نبي غير سائر سيرة
ملك أو رئيس عشيرة يستعلي عليهم بغير الحق.
وقيل: المراد بجعلهم ملوكا هو ما قدر الله فيهم من الملك الذي يبتدىء من
طالوت فداود إلى آخر ملوكهم، فالكلام على هذا وعد بالملك إخبارا بالغيب فإن
الملك لم يستقر فيهم إلا بعد موسى بزمان.
وهذا الوجه لا بأس به لكن لا يلائمه قوله: ﴿وجعلكم ملوكا﴾ ولم يقل: وجعل
منكم ملوكا، كما قال: ﴿جعل فيكم أنبياء﴾. ويمكن أن يكون المراد بالملك مجرد
ركوز الحكم عند بعض الجماعة فيشمل سنة الشيخوخة، ويكون على هذا موسى (عليه
السلام) ملكا وبعده يوشع النبي وقد كان يوسف ملكا من قبل، وينتهي إلى
الملوك المعروفين طالوت وداود وسليمان وغيرهم.
هذا، ويرد على هذا الوجه أيضا ما يرد على سابقه.
ثم قال: ﴿وءاتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين﴾ وهي العنايات والألطاف
الإلهية التي اقترنت بآيات باهرة قيمة بتعديل حياتهم لو استقاموا على ما
قالوا، وداموا على ما واثقوا، وهي
الآيات البينات التي أحاطت بهم من كل جانب أيام كانوا بمصر، وبعد إذ نجاهم الله من فرعون وقومه، فلم يتوافر ويتواتر من
الآيات المعجزات والبراهين الساطعات والنعم التي يتنعم بها في الحياة على أمة من
الأمم الماضية المتقدمة على عهد موسى ما توافرت وتواترت على بني إسرائيل.
وعلى هذا فلا وجه لقول بعضهم: إن المراد بالعالمين عالمو زمانهم وذلك أن
الآية تنفي أن يكون أمة من الأمم إلى ذلك الوقت أوتيت من النعم ما أوتي بنو
إسرائيل، وهو كذلك.
قوله تعالى: ﴿يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا
على أدباركم فتنقلبوا خاسرين﴾ أمرهم بدخول الأرض المقدسة، وكان يستنبط من
حالهم التمرد والتأبي عن القبول، ولذلك أكد أمره بالنهي عن الارتداد وذكر
استتباعه الخسران.
والدليل على أنه كان يستنبط منهم الرد توصيفه إياهم بالفاسقين بعد ردهم،
فإن الرد وهو فسق واحد لا يصحح إطلاق ﴿الفاسقين﴾ عليهم الدال على نوع من
الاستمرار والتكرر.
وقد وصف الأرض بالمقدسة، وقد فسروه بالمطهرة من الشرك لسكون الأنبياء والمؤمنين فيها، ولم يرد في
القرآن الكريم ما يفسر هذه الكلمة.
والذي يمكن أن يستفاد منه ما يقرب من هذا المعنى قوله تعالى: ﴿إلى المسجد
الأقصى الذي باركنا حوله﴾: إسراء: 1 وقوله: ﴿وأورثنا القوم الذين كانوا
يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها﴾: الأعراف: 173 وليست
المباركة في الأرض إلا جعل الخير الكثير فيها، ومن الخير الكثير إقامة
الدين وإذهاب قذارة الشرك.
وقوله: ﴿كتب الله لكم﴾ ظاهر
الآيات أن المراد به قضاء توطنهم فيها، ولا ينافيه قوله في آخرها: ﴿فإنها محرمة
عليهم أربعين سنة﴾ بل يؤكده فإن قوله: ﴿كتب الله لكم﴾ كلام مجمل أبهم فيه
ذكر الوقت وحتى الأشخاص، فإن الخطاب للأمة من غير تعرض لحال الأفراد
والأشخاص، كما قيل: إن السامعين لهذا الخطاب الحاضرين المكلفين به ماتوا
وفنوا عن آخرهم في التيه، ولم يدخل الأرض المقدسة إلا أبناؤهم وأبناء
أبنائهم مع يوشع بن نون، وبالجملة لا يخلو قوله: ﴿فإنها محرمة عليهم أربعين
سنة﴾ عن إشعار بأنها مكتوبة لهم بعد ذلك.
وهذه الكتابة هي التي يدل عليها قوله تعالى: ﴿ونريد أن نمن على الذين
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض﴾:
القصص: 6 وقد كان موسى (عليه السلام) يرجو لهم ذلك بشرط الاستعانة بالله
والصبر حيث يقول: ﴿قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا
ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف
تعملون﴾: الأعراف: 192. وهذا هو الذي يخبر تعالى عن إنجازه بقوله:
﴿وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا
فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا﴾: الأعراف: 173 فدلت
الآية على أن استيلاءهم على الأرض المقدسة وتوطنهم فيها كانت كلمة إلهية
وكتابا وقضاء مقضيا مشترطا بالصبر على الطاعة وعن المعصية، وفي مر الحوادث.
وإنما عممنا الصبر لمكان إطلاق الآية، ولأن الحوادث الشاقة كانت تتراكم
عليهم أيام موسى ومعها الأوامر والنواهي الإلهية، وكلما أصروا على المعصية
اشتدت عليهم التكاليف الشاقة كما تدل على ذلك أخبارهم المذكورة في
القرآن الكريم.
وهذا هو الظاهر من
القرآن في معنى كتابة الأرض المقدسة لهم، والآيات مع ذلك مبهمة في زمان الكتابة
ومقدارها غير أن قوله تعالى في ذيل آيات سورة الإسراء: ﴿وإن عدتم عدنا
وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا﴾: إسراء: 8 وكذا قول موسى لهم في ذيل الآية
السابقة: ﴿عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون﴾:
الأعراف: 192 وقوله أيضا: ﴿وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم -
إلى أن قال - وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي
لشديد﴾: إبراهيم: 7 وما يناظرها من
الآيات تدل على أن هذه الكتابة كتابة مشترطة لا مطلقة غير قابلة للتغير والتبدل.
وقد ذكر بعض المفسرين أن مراد موسى في محكي قوله في الآية: ﴿كتب الله لكم﴾
ما وعد الله إبراهيم (عليه السلام)، ثم ذكر ما في التوراة من وعد الله
إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنه سيعطي الأرض لنسلهم، وأطال البحث في ذلك.
ولا يهمنا البحث في ذلك على شريطة الكتاب سواء كانت هذه العدات من التوراة الأصلية أو مما لعبت به يد التحريف فإن
القرآن لا يفسر بالتوراة.
قوله تعالى: ﴿قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا
منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون﴾ قال الراغب: أصل الجبر إصلاح الشيء
بضرب من القهر يقال: جبرته فانجبر واجتبر.
قال: وقد يقال الجبر تارة في الإصلاح المجرد نحو قول علي رضي الله عنه: يا
جابر كل كسير ويا مسهل كل عسير، ومنه قولهم للخبز: جابر بن حبة، وتارة في
القهر المجرد نحو قوله (عليه السلام): لا جبر ولا تفويض، قال: والإجبار في
الأصل حمل الغير على أن يجبر الآخر لكن تعورف في الإكراه المجرد فقيل:
أجبرته على كذا كقولك: أكرهته.
قال: والجبار في صفة الإنسان يقال لمن يجبر نقيصة بادعاء منزلة من التعالي
لا يستحقها، وهذا لا يقال إلا على طريق الذم كقوله عز وجل: ﴿وخاب كل جبار
عنيد﴾ وقوله تعالى.
﴿و لم يجعلني جبارا شقيا﴾ وقوله عز وجل: ﴿إن فيها قوما جبارين﴾ قال: ولتصور
القهر بالعلو على الأقران قيل: نخلة جبارة وناقة جبارة انتهى موضع الحاجة.
فظهر أن المراد بالجبارين هم أولو السطوة والقوة من الذين يجبرون الناس على ما يريدون.
وقوله: ﴿وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها﴾ اشتراط منهم خروج القوم الجبارين
في دخول الأرض، وحقيقته الرد لأمر موسى وإن وعدوه ثانيا الدخول على الشرط
بقولهم: ﴿فإن يخرجوا منها فإنا داخلون﴾.
وقد ورد في عدة من الأخبار في صفة هؤلاء الجبارين من العمالقة وعظم أجسامهم
وطول قامتهم أمور عجيبة لا يستطيع ذو عقل سليم أن يصدقها، ولا يوجد في
الآثار الأرضية والأبحاث الطبيعية ما يؤيدها فليست إلا موضوعة مدسوسة.
قوله تعالى: ﴿قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما﴾ إلى آخر الآية
ظاهر السياق أن المراد بالمخافة مخافة الله سبحانه وأن هناك رجالا كانوا
يخافون الله أن يعصوا أمره وأمر نبيه، ومنهم هذان الرجلان اللذان قالا، ما
قالا وأنهما كانا يختصان من بين أولئك الذين يخافون بأن الله أنعم عليهما،
وقد مر في موارد تقدمت من الكتاب أن النعمة إذا أطلقت في عرف
القرآن يراد بها الولاية الإلهية فهما كانا من أولياء الله تعالى، وهذا في نفسه
قرينة على أن المراد بالمخافة مخافة الله سبحانه فإن أولياء الله لا يخشون
غيره قال تعالى: ﴿ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾: يونس:
62.
ويمكن أن يكون متعلق ﴿أنعم﴾ المحذوف أعني المنعم به هو الخوف، فيكون المراد
أن الله أنعم عليهما بمخافته، ويكون حذف مفعول ﴿يخافون﴾ للاكتفاء بذكره في
قوله: ﴿أنعم الله عليهما﴾ إذ من المعلوم أن مخافتهما لم يكن من أولئك
القوم الجبارين وإلا لم يدعو بني إسرائيل إلى الدخول بقولهما: ﴿ادخلوا
عليهم الباب﴾.
وذكر بعض المفسرين: أن ضمير الجمع في ﴿يخافون﴾ عائد إلى بني إسرائيل
والضمير العائد إلى الموصول محذوف، والمعنى: وقال رجلان من الذين يخافهم
بنو إسرائيل قد أنعم الله على الرجلين بالإسلام، وأيدوه بما نسب إلى ابن
جبير من قراءة ﴿يخافون﴾ بضم الياء قالوا.
وذلك أن رجلين من العمالقة كانا قد آمنا بموسى، ولحقا بني إسرائيل ثم قالا
لبني إسرائيل ما قالا إراءة لطريق الظفر على العمالقة والاستيلاء على
بلادهم وأرضهم.
وكان هذا التفسير باستناد منهم إلى بعض الأخبار الواردة في
تفسير الآيات لكنه من الآحاد المشتملة على ما لا شاهد له من الكتاب وغيره.
وقوله: ﴿ادخلوا عليهم الباب﴾ لعل المراد به أول بلد من بلاد أولئك الجبابرة
يلي بني إسرائيل، وقد كان على ما يقال: أريحا، وهذا استعمال شائع أو
المراد باب البلدة.
وقوله: ﴿فإذا دخلتموه فإنكم غالبون﴾ وعد منهما لهم بالفتح والظفر على
العدو، وإنما أخبرا إخبارا بتيا اتكالا منهما بما ذكره موسى (عليه السلام)
أن الله كتب لهم تلك الأرض لإيمانهما بصدق إخباره، أو أنهما عرفا ذلك بنور
الولاية الإلهية.
وقد ذكر المعظم من مفسري الفريقين: أن الرجلين هما يوشع بن نون وكالب بن يوفنا وهما من نقباء بني إسرائيل الاثني عشر.
ثم دعواهم إلى التوكل على ربهم بقولهما: ﴿وعلى الله فتوكلوا إن كنتم
مؤمنين﴾ لأن الله سبحانه كافي من توكل عليه وفيه تطييب لنفوسهم وتشجيع لهم.
قوله تعالى: ﴿قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها﴾ الآية
تكرارهم قولهم: ﴿إنا لن ندخلها﴾ ثانيا لإيئاس موسى (عليه السلام) من أن يصر
على دعوته فيعود إلى الدعوة بعد الدعوة.
وفي الكلام وجوه من الإهانة والإزراء والتهكم بمقام موسى وما ذكرهم به من
أمر ربهم ووعده فقد سرد الكلام سردا عجيبا، فهم أعرضوا عن مخاطبة الرجلين
الداعيين إلى دعوة موسى (عليه السلام) أولا، ثم أوجزوا الكلام مع موسى بعد
ما أطنبوا فيه بذكر السبب والخصوصيات في بادىء كلامهم، وفي الإيجاز بعد
الإطناب في مقام التخاصم والتجاوب دلالة على استملال الكلام وكراهة استماع
الحديث أن يمضي عليه المتخاصم الآخر.
ثم أكدوا قولهم: ﴿لن ندخلها﴾ ثانيا بقولهم: ﴿أبدا﴾ ثم جرأهم الجهالة على ما
هو أعظم من ذلك كله، وهو قولهم مفرعين على ردهم الدعوة: ﴿فاذهب أنت وربك
فقاتلا إنا هاهنا قاعدون﴾. وفي الكلام أوضح الدلالة على كونهم مشبهين
كالوثنيين، وهو كذلك فإنهم القائلون على ما يحكيه الله سبحانه عنهم في
قوله: ﴿وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم
قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون﴾: الأعراف:
183 ولم يزالوا على التجسيم والتشبيه حتى اليوم على ما يدل عليه كتبهم
الدائرة بينهم.
قوله تعالى: ﴿قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم
الفاسقين﴾ السياق يدل على أن قوله: ﴿إني لا أملك إلا نفسي وأخي﴾ كناية عن
نفي القدرة على حمل غير نفسه وأخيه على ما أتاهم به من الدعوة.
فإنه إنما كان في مقدرته حمل نفسه على إمضاء ما دعا إليه وحمل أخيه هارون
وقد كان نبيا مرسلا وخليفة له في حياته لا يتمرد عن أمر الله سبحانه.
أو إن المراد أنه ليس له قدرة إلا على نفسه ولا لأخيه قدرة إلا كذلك.
وليس مراده نفي مطلق القدرة حتى من حيث إجابة المسئول لإيمان ونحوه حتى
ينافي ظاهر سياق الآية أن الرجلين من الذين يخافون وآخرين غيرهما كانوا
مؤمنين به مستجيبين لدعوته فإنه لم يذكر فيمن يملكه حتى أهله وأهل أخيه مع
أن الظاهر أنهم ما كانوا ليتخلفوا عن أوامره.
وذلك أن المقام لا يقتضي إلا ذلك فإنه دعاهم إلى خطب مشروع فأبلغ وأعذر فرد
عليه المجتمع الإسرائيلي دعوته أشنع رد وأقبحه، فكان مقتضى هذا الحال أن
يقول: رب إني أبلغت وأعذرت ولا أملك في إقامة أمرك إلا نفسي وكذلك أخي، وقد
قمنا بما علينا من واجب التكليف ولكن القوم واجهونا بأشد الامتناع، ونحن
الآن آيسان منهم، والسبيل منقطع فاحلل أنت هذه العقدة ومهد بربوبيتك السبيل
إلى نيل ما وعدته لهم من تمام النعمة وإيراثهم الأرض واستخلافهم فيها،
واحكم وافصل بيننا وبين هؤلاء الفاسقين.
وهذا المورد على خلاف جميع الموارد التي عصوا فيها أمر موسى كمسألة الرؤية
وعبادة العجل ودخول الباب وقول حطة وغيرها يختص بالرد الصريح من المجتمع
الإسرائيلي لأمره من غير أي رفق وملاءمة، ولو تركهم موسى على حالهم، وأغمض
عن أمره لبطلت الدعوة من أصلها، ولم يتمش له بعد ذلك أمر ولا نهي وتلاشت
بينهم أركان ما أوجده من الوحدة.
ويتبين بهذا البيان أولا: أن مقتضى هذا الحال أن يتعرض موسى (عليه السلام)
في شكواه إلى ربه لحال نفسه وأخيه، وهما المبلغان عن الله تعالى، ولا يتعرض
لحال غيرهما من المؤمنين وإن كانوا غير متمردين.
إذ لا شأن لهم في التبليغ والدعوة، والمقام إنما يقتضي التعرض لحال مبلغ الحكم لا العامل الآخذ به المستجيب له.
وثانيا: أن المقام كان يقتضي رجوع موسى (عليه السلام) إلى ربه بالشكوى وهو في الحقيقة استنصار منه في إجراء الأمر الإلهي.
وثالثا: أن قوله: ﴿وأخي﴾ معطوف على الياء في قوله: ﴿إني﴾ والمعنى: وأخي
مثلي لا يملك إلا نفسه لا على قوله: ﴿نفسي﴾ فإنه خلاف ما يقتضيه السياق وإن
كان المعنى صحيحا على جميع التقادير فإن موسى وهارون كما كانا يملك كل
منهما من نفسه الطاعة والامتثال كان موسى يملك من نفس هارون الطاعة لكونه
خليفته في حياته، وكذا كانا يملكان ممن أخلص لله من المؤمنين السمع
والطاعة.
ورابعا: أن قوله: ﴿فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين﴾ ليس دعاء منه على بني
إسرائيل بالحكم الفصل المستعقب لنزول العذاب عليهم أو بالتفريق بينهما
وبينهم بإخراجهما من بينهم أو بتوفيهما فإنه (عليه السلام) كان يدعوهم إلى
ما كتب الله لهم من تمام النعمة، وكان هو الذي كتب الله المن على بني
إسرائيل بإنجائهم واستخلافهم في الأرض بيده كما قال تعالى: ﴿ونريد أن نمن
على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين﴾: القصص: 5.
وكان بنو إسرائيل يعلمون ذلك منه كما يستفاد من قولهم على ما حكى الله:
﴿قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا﴾ الآية: الأعراف: 192.
ويشهد بذلك أيضا قوله تعالى: ﴿فلا تأس على القوم الفاسقين﴾ فإنه يكشف عن أن
موسى (عليه السلام) كان يشفق عليهم من نزول السخط الإلهي، وكان من المترقب
أن يحزن بسبب حلول نقمة التيه بهم: ﴿قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم
أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين﴾ الضمير في قوله:
﴿فإنها﴾ راجعة إلى الأرض المقدسة، والمراد بالتحريم التحريم التكويني وهو
القضاء، والتيه التحير، واللام في ﴿الأرض﴾ للعهد، وقوله ﴿فلا تأس﴾ نهي من
الأسى وهو الحزن، وقد أمضى الله تعالى قول موسى (عليه السلام) حيث وصفهم في
دعائه بالفاسقين.
والمعنى: أن الأرض المقدسة أي دخولها وتملكها محرمة عليهم، أي قضينا أن لا
يوفقوا لدخولها أربعين سنة يسيرون فيها في الأرض متحيرين لا هم مدنيون
يستريحون إلى بلد من البلاد، ولا هم بدويون يعيشون عيشة القبائل والبدويين،
فلا تحزن على القوم الفاسقين من نزول هذه النقمة عليهم لأنهم فاسقون لا
ينبغي أن يحزن عليهم إذا أذيقوا وبال أمرهم.
بحث روائي:
في الدر المنثور، أخرج ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله (صلى
الله عليه وآله وسلم) قال: كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم دابة
وامرأة كتب ملكا. وفيه: أخرج أبو داود في مراسله عن زيد بن أسلم: في قوله:
﴿وجعلكم ملوكا﴾ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): زوجة ومسكن
وخادم. أقول: وروي غير هاتين الروايتين روايات أخرى في هذا المعنى غير أن
الآية في سياقها لا تلائم هذا التفسير، فإنه وإن كان من الممكن أن يكون من
دأب بني إسرائيل أن يسموا كل من كان له بيت وامرأة وخادم ملكا أو يكتبوه
ملكا إلا أن من البديهي أنهم لم يكونوا كلهم حتى الخوادم على هذا النعت ذوي
بيوت ونساء وخدام فالكائن منهم على هذه الصفة بعضهم ويماثلهم في ذلك سائر
الأمم والأجيال فاتخاذ البيوت والنساء والخدام عادة جارية في جميع الأمم لا
يخلو عن ذلك أمة عن الأمم، وإذا كان كذلك لم يكن أمرا يخص بني إسرائيل حتى
يمتن الله عليهم في كلامه بأنه جعلهم ملوكا، والآية في مقام الامتنان.
ولعل التنبه على ذلك أوجب وقوع ما وقع في بعض الروايات كما عن قتادة: أنهم أول من ملك الخدم، والتاريخ لا يصدقه.
وفي أمالي المفيد، بإسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لما
انتهى لهم موسى إلى الأرض المقدسة قال لهم: ﴿ادخلوا الأرض المقدسة التي
كتب الله لكم - ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين﴾ وقد كتبها الله
لهم ﴿قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها -
فإن يخرجوا منها فإنا داخلون - قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما
ادخلوا عليهم الباب - فإذا دخلتموه فإنكم غالبون - وعلى الله فتوكلوا إن
كنتم مؤمنين - قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها - فاذهب أنت
وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون - قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي - فافرق
بيننا وبين القوم الفاسقين﴾ فلما أبوا أن يدخلوها حرمها الله عليهم فتاهوا
في أربع فراسخ أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.
قال أبو عبد الله (عليه السلام): كانوا إذا أمسوا نادى مناديهم: الرحيل
فيرتحلون بالحداء والزجر حتى إذا أسحروا أمر الله الأرض فدارت بهم فيصبحوا
في منزلهم الذي ارتحلوا منه فيقولون: قد أخطأتم الطريق فمكثوا بهذا أربعين
سنة، ونزل عليهم المن والسلوى حتى هلكوا جميعا إلا رجلان: يوشع بن نون
وكالب بن يوفنا وأبناؤهم وكانوا يتيهون في نحو أربع فراسخ فإذا أرادوا أن
يرتحلوا يبست ثيابهم عليهم وخفافهم. قال: وكان معهم حجر إذا نزلوا ضربه
موسى بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا لكل سبط عين، فإذا ارتحلوا رجع
الماء إلى الحجر ووضع الحجر على الدابة، الحديث.
أقول: والروايات فيما يقرب من هذه المعاني كثيرة من طرق الشيعة وأهل السنة
وقوله في الرواية: وقال أبو عبد الله إلخ رواية أخرى، وهذه الروايات وإن
اشتملت في معنى التيه وغيره على أمور لا يوجد في كلامه تعالى ما تتأيد به
لكنها مع ذلك لا تشتمل على شيء مما يخالف الكتاب، وأمر بني إسرائيل في زمن
موسى (عليه السلام) كان عجيبا تحتف بحياتهم خوارق العادة من كل ناحية فلا
ضير في أن يكون تيههم على هذا النحو المذكور في الروايات.
وفي
تفسير العياشي، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن
قول: ﴿ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم﴾ قال: كتبها لهم ثم محاها ثم
كتبها لأبنائهم فدخلوها والله يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
أقول وروي هذا المعنى أيضا عن إسماعيل الجعفي عنه (عليه السلام) وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام).
وقد قاس (عليه السلام) الكتابة بالنسبة إلى السامعين لخطاب موسى (عليه
السلام) بدخول الأرض، وإلى الداخلين فيها فأنتج البداء في خصوص المكتوب لهم
فلا ينافي ذلك ظاهر سياق الآية أن المكتوب لهم هم الداخلون، وإنما حرموا
الدخول أربعين سنة ورزقوه بعدها فإن الخطاب في الآية متوجه بحسب المعنى إلى
المجتمع الإسرائيلي فيتحد عليه المكتوب لهم الدخول مع الداخلين لكونهم
جميعا أمة واحدة كتب لها الدخول إجمالا ثم حرمت الدخول مدة ورزقته بعدها
ولا بداء على هذا وإن كان بالنظر إلى خصوص الأشخاص بداء.
وفي الكافي، بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): مات داود النبي يوم السبت
مفجوا فأظلته الطير بأجنحتها، ومات موسى كليم الله في التيه فصاح صائح من
السماء مات موسى وأي نفس لا تموت.