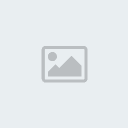•
الآيات 27-32
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا
قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ
قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ
الْمُتَّقِينَ ﴿27﴾ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ
بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ
الْعَالَمِينَ ﴿28﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ
فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِينَ ﴿29﴾
فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ﴿30﴾ فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ
لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا
أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ
أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿31﴾ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا
عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاء تْهُمْ
رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي
الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿32﴾
بيان:
الآيات تنبىء عن قصة ابني آدم، وتبين أن الحسد ربما يبلغ بابن آدم إلى حيث
يقتل أخاه ظالما فيصبح من الخاسرين ويندم ندامة لا يستتبع نفعا، وهي بهذا
المعنى ترتبط بما قبلها من الكلام على بني إسرائيل واستنكافهم عن الإيمان
برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فإن إباءهم عن قبول الدعوة الحقة لم
يكن إلا حسدا وبغيا، وهذا شأن الحسد يبعث الإنسان إلى قتل أخيه ثم يوقعه في
ندامة وحسرة لا مخلص عنها أبدا، فليعتبروا بالقصة ولا يلحوا في حسدهم ثم
في كفرهم ذاك الإلحاح.
قوله تعالى: ﴿واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق﴾ الآية التلاوة من التلو وهي
القراءة سميت بها لأن القارىء للنبأ يأتي ببعض أجزائه في تلو بعض آخر.
والنبأ هو الخبر إذا كان ذا جدوى ونفع.
والقربان ما يتقرب به إلى الله سبحانه أو إلى غيره، وهو في الأصل مصدر لا يثنى ولا يجمع.
والتقبل هو القبول بزيادة عناية واهتمام بالمقبول والضمير في قوله ﴿عليهم﴾ لأهل الكتاب لما مر من كونهم هم المقصودين في سرد الكلام.
والمراد بهذا المسمى بآدم هو آدم الذي يذكر
القرآن أنه أبو البشر، وقد ذكر بعض المفسرين أنه كان رجلا من بني إسرائيل تنازع
ابناه في قربان قرباه فقتل أحدهما الآخر، وهو قابيل أو قايين قتل هابيل
ولذلك قال تعالى بعد سرد القصة: ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل﴾.
وهو فاسد أما أولا: فلأن
القرآن لم يذكر ممن سمي بآدم إلا الذي يذكر أنه أبو البشر، ولو كان المراد بما
في الآية غيره لكان من اللازم نصب القرينة على ذلك لئلا يبهم أمر القصة.
وأما ثانيا فلأن بعض ما ذكر من خصوصيات القصة كقوله: ﴿فبعث الله غرابا﴾
إنما يلائم حال الإنسان الأولي الذي كان يعيش على سذاجة من الفكر وبساطة من
الإدراك، يأخذ باستعداده الجبلي في ادخار المعلومات بالتجارب الحاصلة من
وقوع الحوادث الجزئية حادثة بعد حادثة، فالآية ظاهرة في أن القاتل ما كان
يدري أن الميت يمكن أن يستر جسده بمواراته في الأرض، وهذه الخاصة إنما
تناسب حال ابن آدم أبي البشر لا حال رجل من بني إسرائيل، وقد كانوا أهل
حضارة ومدنية بحسب حالهم في قوميتهم لا يخفى على أحدهم أمثال هذه الأمور
قطعا.
وأما ثالثا فلأن قوله: ولذلك قال تعالى بعد تمام القصة - من أجل ذلك كتبنا
على بني إسرائيل، يريد به الجواب عن سؤال أورد على الآية، وهو أنه ما وجه
اختصاص الكتابة ببني إسرائيل مع أن الذي تقتضيه القصة - وهو الذي كتبه الله
- يعم حال جميع البشر، من قتل منهم نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحيا
منهم نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا.
فأجاب القائل بقوله ولذلك قال تعالى إلخ إن القاتل والمقتول لم يكونا ابني
آدم أبي البشر حتى تكون قصتهما مشتملة على حادثة من الحوادث الأولية بين
النوع الإنساني فيكون عبرة يعتبر بها كل من جاء بعدهما، وإنما هما ابنا رجل
من بني إسرائيل وكان نبأهما من الأخبار القومية الخاصة ولذلك أخذ عبرة
مكتوبة لخصوص بني إسرائيل.
لكن ذلك لا يحسم مادة الإشكال فإن السؤال بعد باق على حاله فإن كون قتل
الواحد بمنزلة قتل الجميع وإحياء الواحد بمنزلة إحياء الجميع معنى يرتبط
بكل قتل وقع بين هذا النوع من غير اختصاصه ببعض دون بعض، وقد وقع ما لا
يحصى من القتل قبل بني إسرائيل، وقبل هذا القتل الذي يشير إليه، فما باله
رتب على قتل خاص وكتب على قوم خاص؟.
على أن الأمر لو كان كما يقول كان الأحسن أن يقال: من قتل منكم نفسا إلخ
ليكون خاصا بهم، ثم يعود السؤال في هذا التخصيص مع عدم استقامته في نفسه.
والجواب عن أصل الإشكال أن الذي يشتمل عليه قوله: ﴿إنه من قتل نفسا بغير
نفس﴾ الآية حكمة بالغة وليس بحكم مشرع فالمراد بالكتابة عليهم بيان هذه
الحكمة لهم مع عموم فائدتها لهم ولغيرهم كالحكم والمواعظ التي بينت في
القرآن لأمة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مع عدم انحصار فائدتها فيهم.
وإنما ذكر في الآية أنه بينه لهم لأن
الآيات مسوقة لعظتهم وتنبيههم وتوبيخهم على ما حسدوا النبي (صلى الله عليه وآله
وسلم) وأصروا في العناد وإشعال نار الفتن والتسبيب إلى القتال ومباشرة
الحروب على المسلمين، ولذلك ذيل قوله: ﴿من قتل نفسا﴾ إلخ بقوله: ﴿ولقد
جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون﴾ على أن
أصل القصة على النحو الذي ذكره لا مأخذ له رواية ولا تاريخا.
فتبين أن قوله: ﴿نبأ ابني آدم بالحق﴾ يراد به قصة ابني آدم أبي البشر،
وتقييد الكلام بقوله: ﴿بالحق﴾ - وهو متعلق بالنبأ أو بقوله ﴿واتل﴾ - لا
يخلو عن إشعار أو دلالة على أن المعروف الدائر بينهم من النبإ لا يخلو من
تحريف وسقط، وهو كذلك فإن القصة موجودة في الفصل الرابع من سفر التكوين من
التوراة، وليس فيها خبر بعث الغراب وبحثه في الأرض، والقصة مع ذلك صريحة في
تجسم الرب تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
وقوله: ﴿إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر﴾ ظاهر السياق
أن كل واحد منهما قدم إلى الرب تعالى شيئا يتقرب به وإنما لم يثن لفظ
القربان لكونه في الأصل مصدرا لا يثنى ولا يجمع.
وقوله: ﴿قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين﴾ القائل الأول هو
القاتل والثاني هو المقتول، وسياق الكلام يدل على أنهما علما تقبل قربان
أحدهما وعدم تقبله من الآخر، وأما أنهما من أين علما ذلك؟ أو بأي طريق
استدلوا عليه؟ فالآية ساكتة عن ذلك.
غير أنه ذكر في موضع من كلامه تعالى: أنه كان من المعهود عند الأمم السابقة
أو عند بني إسرائيل خاصة تقبل القربان المتقرب به بأكل النار إياه قال
تعالى: ﴿الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان
تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم
إن كنتم صادقين﴾: آل عمران: 138 والقربان معروف عند أهل الكتاب إلى هذا
اليوم فمن الممكن أن يكون التقبل للقربان في هذه القصة أيضا على ذلك النحو،
وخاصة بالنظر إلى إلقاء القصة إلى أهل الكتاب المعتقدين لذلك، وكيف كان
فالقاتل والمقتول جميعا كانا يعلمان قبوله من أحدهما ورده من الآخر.
ثم السياق يدل أيضا على أن القائل ﴿لأقتلنك﴾ هو الذي لم يتقبل قربانه، وأنه
إنما قال ذلك حسدا من نفسه إذ لم يكن هناك سبب آخر، ولا أن المقتول كان قد
أجرم إجراما باختيار منه حتى يواجه بمثل هذا القول ويهدد بالقتل.
فقول القاتل: ﴿لأقتلنك﴾ تهديد بالقتل حسدا لقبول قربان المقتول دون القاتل
فقول المقتول: ﴿إنما يتقبل الله من المتقين﴾ إلى آخر ما حكى الله تعالى عنه
جواب عما قاله القاتل فيذكر له أولا: أن مسألة قبول القربان وعدم قبوله لا
صنع له في ذلك ولا إجرام، وإنما الإجرام من قبل القاتل حيث لم يتق الله
فجازاه الله بعدم قبول قربانه.
وثانيا: أن القاتل لو أراد قتله وبسط إليه يده لذلك ما هو بباسط يده إليه
ليقتله لتقواه وخوفه من الله سبحانه، وإنما يريد على هذا التقدير أن يرجع
القاتل وهو يحمل إثم المقتول وإثم نفسه فيكون من أصحاب النار وذلك جزاء
الظالمين.
فقوله: ﴿إنما يتقبل الله من المتقين﴾ مسوق لقصر الإفراد للدلالة على أن
التقبل لا يشمل قربان التقي وغير التقي جميعا، أو لقصر القلب كأن القاتل
كان يزعم أنه سيتقبل قربانه دون قربان المقتول زعما منه أن الأمر لا يدور
مدار التقوى أو أن الله سبحانه غير عالم بحقيقة الحال، يمكن أن يشتبه عليه
الأمر كما ربما يشتبه على الإنسان.
وفي الكلام بيان لحقيقة الأمر في تقبل العبادات والقرابين، وموعظة وبلاغ في
أمر القتل والظلم والحسد، وثبوت المجازاة الإلهية وأن ذلك من لوازم ربوبية
رب العالمين فإن الربوبية لا تتم إلا بنظام متقن بين أجزاء العالم يؤدي
إلى تقدير الأعمال بميزان العدل وجزاء الظلم بالعذاب الأليم ليرتدع الظالم
عن ظلمه أو يجزى بجزائه الذي أعده لنفسه وهو النار.
قوله تعالى: ﴿لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك﴾ إلخ اللام
للقسم، وبسط اليد إليه كناية عن الأخذ بمقدمات القتل وإعمال أسبابه، وقد
أتى في جواب الشرط بالنفي الوارد على الجملة الإسمية، وبالصفة بباسط دون
الفعل وأكد النفي بالباء ثم الكلام بالقسم، كل ذلك للدلالة على أنه بمراحل
من البعد من إرادة قتل أخيه، لا يهم به ولا يخطر بباله.
وأكد ذلك كله بتعليل ما ادعاه من قوله: ﴿ما أنا بباسط يدي﴾ إلخ: ﴿بقوله إني
أخاف الله رب العالمين﴾ فإن ذكر المتقين لربهم وهو الله رب العالمين الذي
يجازي في كل إثم بما يتعقبه من العذاب ينبه في نفوسهم غريزة الخوف من الله
تعالى، ولا يخليهم وإن يرتكبوا ظلما يوردهم مورد الهلكة.
ثم ذكر تأويل قوله: ﴿لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي﴾ إلخ بمعنى
حقيقة هذا الذي أخبر به، ومحصله أن الأمر على هذا التقدير يدور بين أن
يقتل هو أخاه فيكون هو الظالم الحامل للإثم الداخل في النار، أو يقتله أخوه
فيكون هو كذلك، وليس يختار قتل أخيه الظالم على سعادة نفسه وليس بظالم، بل
يختار أن يشقى أخوه الظالم بقتله ويسعد هو وليس بظالم، وهذا هو المراد
بقوله: ﴿إني أريد، إلخ﴾ كنى بالإرادة عن الاختيار على تقدير دوران الأمر.
فالآية في كونها تأويلا لقوله: ﴿لئن بسطت إلي يدك﴾ إلخ كالذي وقع في قصة
موسى وصاحبه حين قتل غلاما لقياه فاعترض عليه موسى بقوله: ﴿أ قتلت نفسا
زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا﴾ فنبأه صاحبه بتأويل ما فعل بقوله: ﴿وأما
الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن
يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما﴾: الكهف: 81.
فقد أراد المقتول أي اختار الموت مع السعادة وإن استلزم شقاء أخيه بسوء
اختياره على الحياة مع الشقاء والدخول في حزب الظالمين، كما اختار صاحب
موسى موت الغلام مع السعادة وإن استلزم الحزن والأسى من أبويه على حياته
وصيرورته طاغيا كافرا يضل بنفسه ويضل أبويه، والله يعوضهما منه من هو خير
منه زكاة وأقرب رحما.
والرجل أعني ابن آدم المقتول من المتقين العلماء بالله، أما كونه من
المتقين فلقوله: ﴿إنما يتقبل الله من المتقين﴾ المتضمن لدعوى التقوى، وقد
أمضاها الله تعالى بنقله من غير رد، وأما كونه من العلماء بالله فلقوله:
﴿إني أخاف الله رب العالمين﴾ فقد ادعى مخافة الله وأمضاها الله سبحانه منه،
وقد قال تعالى: ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾: فاطر: 28 فحكايته
تعالى قوله: ﴿إني أخاف الله رب العالمين﴾ وإمضاؤه له توصيف له بالعلم كما
وصف صاحب موسى أيضا بالعلم إذ قال: ﴿وعلمناه من لدنا علما﴾: الكهف: 65.
وكفى له علما ما خاطب به أخاه الباغي عليه من الحكمة البالغة والموعظة
الحسنة فإنه بين عن طهارة طينته وصفاء فطرته: أن البشر ستكثر عدتهم ثم
تختلف بحسب الطبع البشري جماعتهم فيكون منهم متقون وآخرون ظالمون، وأن لهم
جميعا ولجميع العالمين ربا واحدا يملكهم ويدبر أمرهم، وأن من التدبير
المتقن أن يحب ويرتضي العدل والإحسان، ويكره ويسخط الظلم والعدوان ولازمه
وجوب التقوى ومخافة الله على الإنسان وهو الدين، فهناك طاعات وقربات ومعاصي
ومظالم، وأن الطاعات والقربات إنما تتقبل إذا كانت عن تقوى، وأن المعاصي
والمظالم آثام يحملها الظالم، ومن لوازمه أن تكون هناك نشأة أخرى فيها
الجزاء، وجزاء الظالمين النار.
وهذه - كما ترى - أصول المعارف الدينية ومجامع علوم المبدأ والمعاد أفاضها
هذا العبد الصالح إفاضة ضافية لأخيه الجاهل الذي لم يكن يعرف أن الشيء يمكن
أن يتوارى عن الأنظار بالدفن حتى تعلمه من الغراب، وهو لم يقل لأخيه حينما
كلمه: إنك إن أردت أن تقتلني ألقيت نفسي بين يديك ولم أدافع عن نفسي ولا
أتقي القتل، وإنما قال: ما كنت لأقتلك.
ولم يقل: إني أريد أن أقتل بيدك على أي تقدير لتكون ظالما فتكون من أصحاب
النار فإن التسبيب إلى ضلال أحد وشقائه في حياته ظلم وضلال في شريعة الفطرة
من غير اختصاص بشرع دون شرع، وإنما قال: إني أريد ذلك وأختاره على تقدير
بسطك يدك لقتلي.
ومن هنا يظهر اندفاع ما أورد على القصة: أنه كما أن القاتل منهما أفرط
بالظلم والتعدي كذلك المقتول قصر بالتفريط والانظلام حيث لم يخاطبه ولم
يقابله بالدفاع عن نفسه بل سلم له أمر نفسه وطاوعه في إرادة قتله حيث قال
له: ﴿لئن بسطت إلي يدك﴾ إلخ.
وجه الاندفاع أنه، لم يقل: إني لا أدافع عن نفسي وأدعك وما تريد مني وإنما
قال: لست أريد قتلك، ولم يذكر في الآية أنه قتل ولم يدافع عن نفسه على علم
منه بالأمر فلعله قتله غيلة أو قتله وهو يدافع أو يحترز.
وكذا ما أورد عليها أنه ذكر إرادته تمكين أخيه من قتله ليشقى بالعذاب
الخالد ليكون هو بذلك سعيدا حيث قال: ﴿إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون
من أصحاب النار﴾ كبعض المتقشفين من أهل العبادة والورع حيث يرى أن الذي
عليه هو التزهد والتعبد، وإن ظلمه ظالم أو تعدى عليه متعد حمل الظالم وزر
ظلمه، وليس عليه من الدفاع عن حقه إلا الصبر والاحتساب.
وهذا من الجهل، فإنه من الإعانة على الإثم، وهي توجب اشتراك المعين والمعان في الإثم جميعا لا انفراد الظالم بحمل الاثنين معا.
وجه الاندفاع: أن قوله: ﴿إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك﴾، قول على تقدير بالمعنى الذي تقدم بيانه.
وقد أجيب عن الإشكالين ببعض وجوه سخيفة لا جدوى في ذكرها.
قوله تعالى: ﴿إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار﴾، أي ترجع
بإثمي وإثمك كما فسره بعضهم، وقال الراغب في مفرداته: أصل البواء مساواة
الأجزاء في المكان خلاف النبوة الذي هو منافاة الأجزاء يقال: مكان بواء إذا
لم يكن نابئا بنازلة، وبوأت له مكانا: سويته فتبوء - إلى أن قال - وقوله:
إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك أي تقيم بهذه الحالة.
قال: أنكرت باطلها وبؤت بحقها.
انتهى وعلى هذا فتفسيره بالرجوع
تفسير بلازم المعنى.
والمراد بقوله: ﴿أن تبوء بإثمي وإثمك﴾ أن ينتقل إثم المقتول ظلما إلى قاتله
على إثمه الذي كان له فيجتمع عليه الإثمان، والمقتول يلقى الله سبحانه ولا
إثم عليه، فهذا ظاهر قوله: ﴿أن تبوء بإثمي وإثمك﴾ وقد ورد بذلك الروايات
والاعتبار العقلي يساعد عليه.
وقد تقدم شطر من البحث فيه في الكلام على أحكام الأعمال في الجزء الثاني من الكتاب.
والإشكال عليه بأن لازمه جواز مؤاخذة الإنسان بذنب غيره، والعقل يحكم
بخلافه، وقد قال تعالى: ﴿لا تزر وازرة وزر أخرى﴾: النجم: 38. مدفوع بأن ذلك
ليس من أحكام العقل النظري حتى يختم عليه باستحالة الوقوع، بل من أحكام
العقل العملي التي تتبع مصالح المجتمع الإنساني في ثبوتها وتغيرها، ومن
الجائز أن يعتبر المجتمع الفعل الصادر عن أحد فعلا صادرا عن غيره ويكتبه
عليه ويؤاخذه به، أو الفعل الصادر عنه غير صادر عنه كما إذا قتل إنسانا
وللمجتمع على المقتول حقوق كان يجب أن يستوفيها منه، فمن الجائز أن يستوفي
المجتمع حقوقه من القاتل، وكما إذا بغى على المجتمع بالخروج والإفساد
والإخلال بالأمن العام فإن للمجتمع أن يعتبر جميع الحسنات الباغي كأن لم
تكن، إلى غير ذلك.
ففي هذه الموارد وأمثالها لا يرى المجتمع السيئات التي صدرت من المظلوم إلا
أوزارا للظالم، وإنما تزر وازرته وزر نفسها لا وزر غيرها، لأنها تملكتها
من الغير بما أوقعته عليه من الظلم والشر نظير ما يبتاع الإنسان ما يملكه
غيره بثمن، فكما أن تصرفات المالك الجديد لا تمنع لكون المالك الأول مالكا
للعين زمانا لانتقالها إلى غيره ملكا، كذلك لا يمنع قوله: ﴿لا تزر وازرة
وزر أخرى﴾ مؤاخذة النفس القاتلة بسيئة بمجرد أن النفس الوازرة كانت غيرها
زمانا، ولا أن قوله: ﴿لا تزر وازرة وزر أخرى﴾ يبقى بلا فائدة ولا أثر بسبب
جواز انتقال الوزر بسبب جديد كما لا يبقى قوله (عليه السلام): ﴿لا يحل مال
امرىء مسلم إلا بطيب نفسه﴾ بلا فائدة بتجويز انتقال الملك ببيع ونحوه
وقد ذكر بعض المفسرين: أن المراد بقوله: ﴿بإثمي وإثمك﴾ بإثم قتلي إن قتلتني
وإثمك الذي كنت أثمته قبل ذلك كما نقل عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما، أو
أن المراد بإثم قتلي وإثمك الذي لم يتقبل من أجله قربانك كما نقل عن
الجبائي والزجاج، أو أن معناه بإثم قتلي وإثمك الذي هو قتل جميع الناس كما
نقل عن آخرين.
وهذه وجوه ذكروها ليس على شيء منها من جهة اللفظ دليل، ولا يساعد عليه اعتبار.
على أن المقابلة بين الإثمين مع كونهما جميعا للقاتل ثم تسمية أحدهما بإثم المقتول وغيره بإثم القاتل خالية عن الوجه.
قوله تعالى: ﴿فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين﴾ قال الراغب
في مفرداته: الطوع الانقياد ويضاده الكره، والطاعة مثله لكن أكثر ما يقال
في الايتمار لما أمر والارتسام فيما رسم، وقوله: فطوعت له نفسه نحو أسمحت
له قرينته وانقادت له وسولت، وطوعت أبلغ من أطاعت وطوعت له نفسه بإزاء
قولهم: تابت عن كذا نفسه.
انتهى ملخصا.
وليس مراده أن طوعت مضمن معنى انقادت أو سولت بل يريد أن التطويع يدل على
التدريج كالإطاعة على الدفعة، كما هو الغالب في بابي الإفعال والتفعيل
فالتطويع في الآية اقتراب تدريجي للنفس من الفعل بوسوسة بعد وسوسة وهمامة
بعد همامة تنقاد لها حتى تتم لها الطاعة الكاملة فالمعنى: انقادت له نفسه
وأطاعت أمره إياها بقتل أخيه طاعة تدريجية، فقوله: ﴿قتل أخيه﴾ من وضع
المأمور به موضع الأمر كقولهم: أطاع كذا في موضع: أطاع الأمر بكذا.
وربما قيل: إن قوله: طوعت بمعنى زينت فقوله: ﴿قتل أخيه﴾ مفعول به، وقيل:
بمعنى طاوعت أي طاوعت له نفسه في قتل أخيه، فالقتل منصوب بنزع الخافض،
ومعنى الآية ظاهر.
وربما استفيد من قوله: ﴿فأصبح من الخاسرين﴾ أنه إنما قتله ليلا، وفيه كما
قيل: إن أصبح - وهو مقابل أمسى - وإن كان بحسب أصل معناه يفيد ذلك لكن عرف
العرب يستعمله بمعنى صار من غير رعاية أصل اشتقاقه، وفي
القرآن شيء كثير من هذا القبيل كقوله: ﴿فأصبحتم بنعمته إخوانا﴾: آل عمران: 130
وقوله: ﴿فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين﴾: المائدة: 52 فلا سبيل إلى
إثبات إرادة المعنى الأصلي في المقام.
قوله تعالى: ﴿فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه﴾
البحث طلب الشيء في التراب ثم يقال: بحثت عن الأمر بحثا كذا في المجمع، .
والمواراة: الستر، ومنه التواري للتستر، والوراء لما خلف الشيء.
والسوأة ما يتكرهه الإنسان.
والويل الهلاك.
ويا ويلتا كلمة تقال عند الهلكة، والعجز مقابل الاستطاعة.
والآية بسياقها تدل على أن القاتل قد كان بقي زمانا على تحير من أمره، وكان
يحذر أن يعلم به غيره، ولا يدري كيف الحيلة إلى أن لا يظفروا بجسده حتى
بعث الله الغراب، ولو كان بعث الغراب وبحثه وقتله أخاه متقاربين لم يكن وجه
لقوله: ﴿يا ويلتا أ عجزت أن أكون مثل هذا الغراب﴾. وكذا المستفاد من
السياق أن الغراب دفن شيئا في الأرض بعد البحث فإن ظاهر الكلام أن الغراب
أراد إراءة كيفية المواراة لا كيفية البحث، ومجرد البحث ما كان يعلمه كيفية
المواراة وهو في سذاجة الفهم بحيث لم ينتقل ذهنه بعد إلى معنى البحث، فكيف
كان ينتقل من البحث إلى المواراة ولا تلازم بينهما بوجه؟ فإنما انتقل إلى
معنى المواراة بما رأى أن الغراب بحث في الأرض ثم دفن فيها شيئا.
والغراب من بين الطير من عادته أنه يدخر بعض ما اصطاده لنفسه بدفنه في
الأرض وبعض ما يقتات بالحب ونحوه من الطير وإن كان ربما بحث في الأرض لكنه
للحصول على مثل الحبوب والديدان لا للدفن والإدخار.
وما تقدم من إرجاع ضمير الفاعل في ﴿ليريه﴾ إلى الغراب هو الظاهر من الكلام
لكونه هو المرجع القريب، وربما قيل: إن الضمير راجع إلى الله سبحانه، ولا
بأس به لكنه لا يخلو عن شيء من البعد، والمعنى صحيح على التقديرين، وأما
قوله: ﴿قال يا ويلتا أ عجزت أن أكون مثل هذا الغراب﴾، فإنما قاله لأنه
استسهل ما رأى من حيلة الغراب للمواراة فإنه وجد نفسه تقدر على إتيان مثل
ما أتى به الغراب من البحث ثم التوسل به إلى المواراة لظهور الرابطة بين
البحث والمواراة، وعند ذلك تأسف على ما فاته من الفائدة، وندم على إهماله
في التفكر في التوسل إلى المواراة حتى يستبين له أن البحث هو الوسيلة
القريبة إليه، فأظهر هذه الندامة بقوله: ﴿يا ويلتا أ عجزت أن أكون مثل هذا
الغراب فأواري سوأة أخي﴾ وهو تخاطب جار بينه وبين نفسه على طريق الاستفهام
الإنكاري، والتقدير أن يستفهم منكرا: أ عجزت أن تكون مثل هذا الغراب فتواري
سوأة أخيك؟ فيجاب: لا.
ثم يستفهم ثانيا استفهاما إنكاريا فيقال: فلم غفلت عن ذلك ولم تتوسل إليها
بهذه الوسيلة على ظهورها وأشقيت نفسك في هذه المدة من غير سبب؟ ولا جواب عن
هذه المسألة، وفيه الندامة فإن الندامة تأثر روحي خاص من الإنسان وتألم
باطني يعرضه من مشاهدته إهماله شيئا من الأسباب المؤدية إلى فوت منفعة أو
حدوث مضرة، وإن شئت فقل هي تأثر الإنسان العارض له من تذكره إهماله في
الاستفادة من إمكان من الإمكانات.
وهذا حال الإنسان إذا أتى من المظالم بما يكره أن يطلع عليه الناس فإن هذه
أمور لا يقبلها المجتمع بنظامه الجاري فيه، المرتبط بعض أجزائه ببعض فلا بد
أن يظهر أثر هذه الأمور المنافية له وإن خفيت على الناس في أول حدوثها،
والإنسان الظالم المجرم يريد أن يجبر النظام على قبوله وليس بقابل نظير أن
يأكل الإنسان أو يشرب شيئا من السم وهو يريد أن يهضمه جهاز هضمه وليس
بهاضم، فهو وإن أمكن وروده في باطنه لكن له موعدا لن يخلفه ومرصدا لن
يتجاوزه، وإن ربك لبالمرصاد.
وعند ذلك يظهر للإنسان نقص تدبيره في بعض ما كان يجب عليه مراقبته ورعايته
فيندم لذلك، ولو عاد فأصلح هذا الواحد فسد آخر ولا يزال الأمر على ذلك حتى
يفضحه الله على رءوس الأشهاد.
وقد اتضح بما تقدم من البيان: أن قوله: ﴿فأصبح من النادمين﴾ إشارة إلى
ندامته على عدم مواراته سوأة أخيه، وربما أمكن أن يقال: إن المراد به ندمه
على أصل القتل وليس ببعيد.
كلام في معنى الإحساس والتفكير:
هذا الشطر من قصة ابني آدم أعني قوله تعالى: ﴿فبعث الله غرابا يبحث في
الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه قال يا ويلتا أ عجزت أن أكون مثل هذا
الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين﴾ آية واحدة في
القرآن لا نظيرة لها من نوعها وهي تمثل حال الإنسان في الانتفاع بالحس، وأنه
يحصل خواص الأشياء من ناحية الحس، ثم يتوسل بالتفكر فيها إلى أغراضه
ومقاصده في الحياة على نحو ما يقضي به البحث العلمي أن علوم الإنسان
ومعارفه تنتهي إلى الحس خلافا للقائلين بالتذكر والعلم الفطري.
وتوضيحه أنك إذا راجعت الإنسان فيما عنده من الصور العلمية من تصور أو
تصديق جزئي أو كلي وبأي صفة كانت علومه وإدراكاته وجدت عنده وإن كان من
أجهل الناس وأضعفهم فهما وفكرا صورا كثيرة وعلوما جمة لا تكاد تنالها يد
الإحصاء بل لا يحصيها إلا رب العالمين.
ومن المشهود من أمرها على كثرتها وخروجها عن طور الإحصاء والتعديد أنها لا
تزال تزيد وتنمو مدة الحياة الإنسانية في الدنيا، ولو تراجعنا القهقرى
وجدناها تنقص ثم تنقص حتى تنتهي إلى الصفر، وعاد الإنسان وما عنده شيء من
العلم بالفعل قال تعالى: ﴿علم الإنسان ما لم يعلم﴾: العلق: 5.
وليس المراد بالآية أنه تعالى يعلمه ما لم يعلم وأما ما علمه فهو فيه في
غنى عن تعليم ربه فإن من الضروري أن العلم في الإنسان أيا ما كان هو
لهدايته إلى ما يستكمل به في وجوده وينتفع به في حياته، والذي تسير إليه
أقسام الأشياء غير الحية بالانبعاثات الطبيعية تسير وتهتدي أقسام الموجودات
الحية - ومنها الإنسان - إليه بنور العلم فالعلم من مصاديق الهدى.
وقد نسب الله سبحانه مطلق الهداية إلى نفسه حيث قال: ﴿الذي أعطى كل شيء
خلقه ثم هدى﴾: طه: 50 وقال: ﴿الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى﴾: الأعلى: 3
وقال وهو بوجه من الهداية بالحس والفكر: ﴿أمن يهديكم في ظلمات البر
والبحر﴾: النمل: 63 وقد مر شطر من الكلام في معنى الهداية في بعض المباحث
السابقة، وبالجملة لما كان كل علم هداية وكل هداية فهي من الله كان كل علم
للإنسان بتعليمه تعالى.
ويقرب من قوله: ﴿علم الإنسان ما لم يعلم﴾ قوله: ﴿والله أخرجكم من بطون
أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة﴾: النحل: 78.
والتأمل في حال الإنسان والتدبر في
الآيات الكريمة يفيدان أن علم الإنسان النظري أعني العلم بخواص الأشياء وما
يستتبعه من المعارف العقلية يبتدىء من الحس فيعلمه الله من طريقه خواص
الأشياء كما يدل عليه قوله: ﴿فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف
يواري سوأة أخيه﴾ الآية.
فنسبة بعث الغراب لإراءة كيفية المواراة إلى الله سبحانه نسبة تعليم كيفية
المواراة إليه تعالى بعينه فالغراب وإن كان لا يشعر بأن الله سبحانه هو
الذي بعثه، وكذلك ابن آدم لم يكن يدري أن هناك مدبرا يدبر أمر تفكيره
وتعلمه، وكانت سببية الغراب وبحثه بالنسبة إلى تعلمه بحسب النظر الظاهري
سببية اتفاقية كسائر الأسباب الاتفاقية التي تعلم الإنسان طرق تدبير المعاش
والمعاد، لكن الله سبحانه هو الذي خلق الإنسان وساقه إلى كمال العلم لغاية
حياته، ونظم الكون نوع نظم يؤديه إلى الاستكمال بالعلم بأنواع من التماس
والتصاك تقع بينه وبين أجزاء الكون، فيتعلم بها الإنسان ما يتوسل به إلى
أغراضه ومقاصده من الحياة فالله سبحانه هو الذي يبعث الغراب وغيره إلى عمل
يتعلم به الإنسان شيئا فهو المعلم للإنسان.
ولهذا المعنى نظائر في
القرآن كقوله تعالى: ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله﴾:
المائدة: 4 عد ما علموه وعلموه مما علمهم الله وإنما تعلموه من سائر الناس
أو ابتكروه بأفكار أنفسهم، وقوله: ﴿واتقوا الله ويعلمكم الله﴾: البقرة: 228
وإنما كانوا يتعلمونه من الرسول، وقوله: ﴿ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه
الله﴾: البقرة: 228 وإنما تعلم الكاتب ما علمه بالتعلم من كاتب آخر مثله
إلا أن جميع ذلك أمور مقصودة في الخلق والتدبير فما حصل من هذه الأسباب من
فائدة العلم الذي يستكمل به الإنسان فالله سبحانه هو معلمه بهذه الأسباب
كما أن المعلم من الإنسان يعلم بالقول والتلقين، والكاتب من الإنسان يعلم
غيره بالقول والقلم مثلا.
وهذا هو السبيل في جميع ما يسند إليه تعالى في عالم الأسباب فالله تعالى هو
خالقه وبينه وبين مخلوقة أسباب هي الأسباب بحسب الظاهر وهي أدوات وآلات
لوجود الشيء، وإن شئت فقل: هي من شرائط وجود الشيء الذي تعلق وجوده من جميع
جهاته وأطرافه بالأسباب، فمن شرائط وجود زيد ﴿الذي ولده عمرو وهند﴾ أن
يتقدمه عمرو وهند وازدواج وتناكح بينهما، وإلا لم يوجد زيد المفروض، ومن
شرائط ﴿الإبصار بالعين الباصرة﴾ أن تكون قبله عين باصرة، وهكذا.
فمن زعم أنه يوحد الله سبحانه بنفي الأسباب وإلغائها، وقدر أن ذلك أبلغ في
إثبات قدرته المطلقة ونفي العجز عنه، وزعم أن إثبات ضرورة تخلل الأسباب قول
بكونه تعالى مجبرا على سلوك سبيل خاص في الإيجاد فاقدا للاختيار فقد ناقض
نفسه من حيث لا يشعر.
وبالجملة فالله سبحانه هو الذي علم الإنسان خواص الأشياء التي تنالها حواسه
نوعا من النيل، علمه إياها من طريق الحواس، ثم سخر له ما في الأرض والسماء
جميعا، قال تعالى: ﴿وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه﴾:
الجاثية: 13.
وليس هذا التسخير إلا لأن يتوسل بنوع من التصرف فيها إلى بلوغ أغراضه
وأمانيه في الحياة أي أنه جعلها مرتبطة بوجوده لينتفع بها، وجعله متفكرا
يهتدي إلى كيفية التصرف والاستعمال والتوسل، ومن الدليل على ذلك قوله
تعالى: ﴿أ لم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره﴾:
الحج: 65، وقوله تعالى: ﴿وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون﴾: الزخرف:
12، وقوله تعالى: ﴿عليها وعلى الفلك تحملون﴾: غافر: 80 وغير ذلك من
الآيات المشابهة لها فانظر إلى لسان
الآيات كيف نسبت جعل الفلك إلى الله سبحانه وهو من صنع الإنسان، ثم نسب الحمل
إليه تعالى وهو من صنع الفلك والأنعام ونسب جريانها في البحر إلى أمره وهو
مستند إلى جريان البحر أو هبوب الريح أو البخار ونحوه، وسمي ذلك كله تسخيرا
منه للإنسان لما أن لإرادته نوع حكومة في الفلك وما يناظرها من الأنعام
وفي الأرض والسماء تسوقها إلى الغايات المطلوبة له.
وبالجملة هو سبحانه أعطاه الفكر على الحس ليتوسل به إلى كماله المقدر له
بسبب علومه الفكرية الجارية في التكوينيات أعني العلوم النظرية.
قال تعالى: ﴿وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون﴾: النحل: 78
وأما العلوم العملية وهي التي تجري فيما ينبغي أن يعمل وما لا ينبغي فإنما
هي بإلهام من الله سبحانه من غير أن يوجدها حس أو عقل نظري، قال تعالى:
﴿ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من
دساها﴾: الشمس: 10 وقال: ﴿فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس
عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم﴾: الروم: 30 فعد العلم بما ينبغي
فعله وهو الحسنة وما لا ينبغي فعله وهو السيئة مما يحصل له بالإلهام
الإلهي وهو القذف في القلب.
فجميع ما يحصل للإنسان من العلم إنما هي هداية إلهية وبهداية إلهية، غير
أنها مختلفة بحسب النوع: فما كان من خواص الأشياء الخارجية فالطريق الذي
يهدي به الله سبحانه الإنسان هو طريق الحس، وما كان من العلوم الكلية
الفكرية فإنما هي بإعطاء وتسخير إلهي من غير أن يبطله وجود الحس أو يستغني
الإنسان عنها في حال من الأحوال، وما كان من العلوم العملية المتعلقة بصلاح
الأعمال وفسادها وما هو تقوى أو فجور فإنما هي بإلهام إلهي بالقذف في
القلوب وقرع باب الفطرة.
والقسم الثالث الذي يرجع بحسب الأصل إلى إلهام إلهي إنما ينجح في عمله ويتم
في أثره إذا صلح القسم الثاني ونشأ على صحة واستقامة كما أن العقل أيضا
إنما يستقيم في عمله إذا استقام الإنسان في تقواه ودينه الفطري، قال تعالى:
﴿وما يذكر إلا أولوا الألباب: آل عمران: 7 وقال تعالى: ﴿وما يتذكر إلا من
ينيب﴾: غافر: 13 وقال تعالى: ﴿ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول
مرة﴾: الأنعام: 101 وقال تعالى: ﴿ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه
نفسه﴾: البقرة: 103 أي لا يترك مقتضيات الفطرة إلا من فسد عقله فسلك غير
سبيله.
والاعتبار يساعد هذا التلازم الذي بين العقل والتقوى، فإن الإنسان إذا أصيب
في قوته النظرية فلم يدرك الحق حقا أو لم يدرك الباطل باطلا فكيف يلهم
بلزوم هذا أو اجتناب ذاك؟ كمن يرى أن ليس وراء الحياة المادية المعجلة شيء
فإنه لا يلهم التقوى الديني الذي هو خير زاد للعيشة الآخرة.
وكذلك الإنسان إذا فسد دينه الفطري ولم يتزود من التقوى الديني لم تعتدل
قواه الداخلية المحسة من شهوة أو غضب أو محبة أو كراهة وغيرها، ومع اختلال
أمر هذه القوى لا تعمل قوة الإدراك النظرية عملها عملا مرضيا.
والبيانات القرآنية تجري في بث المعارف الدينية وتعليم الناس العلم النافع
هذا المجرى، وتراعي الطرق المتقدمة التي عينتها للحصول على المعلومات، فما
كان من الجزئيات التي لها خواص تقبل الإحساس فإنها تصريح فيها إلى الحواس
كالآيات المشتملة على قوله: ﴿أ لم تر أ فلا يرون أ فرأيتم، أ فلا تبصرون﴾
وغير ذلك وما كان من الكليات العقلية مما يتعلق بالأمور الكلية المادية أو
التي هي وراء عالم الشهادة فإنها تعتبر فيها العقل اعتبارا جازما وإن كانت
غائبة عن الحس خارجة عن محيط المادة والماديات، كغالب
الآيات الراجعة إلى المبدأ والمعاد المشتملة على أمثال قوله: ﴿لقوم يعقلون، لقوم
يتفكرون، لقوم يتذكرون، يفقهون، وغيرها، وما كان من القضايا العملية التي
لها مساس بالخير والشر والنافع والضار في العمل والتقوى والفجور فإنها
تستند فيها إلى الإلهام الإلهي بذكر ما بتذكره يشعر الإنسان بإلهامه
الباطني كالآيات المشتملة على مثل قوله: ﴿ذلكم خير لكم، فإنه آثم قلبه،
فيهما إثم، والإثم والبغي بغير الحق، إن الله لا يهدي﴾ وغيرها، وعليك
بالتدبر فيها.
ومن هنا يظهر أولا: أن
القرآن الكريم يخطىء طريق الحسيين وهم المعتمدون على الحس والتجربة، النافون
للأحكام العقلية الصرفة في الأبحاث العلمية، وذلك أن أول ما يهتم
القرآن به في بيانه هو أمر توحيد الله عز اسمه، ثم يرجع إليه ويبتنى عليه جميع المعارف الحقيقية التي يبينها ويدعو إليها.
ومن المعلوم أن التوحيد أشد المسائل ابتعادا من الحس، وبينونة للمادة وارتباطا بالأحكام العقلية الصرفة.
والقرآن يبين أن هذه المعارف الحقيقية من الفطرة قال: ﴿فأقم وجهك للدين
حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله﴾: الروم: 30 أي
إن الخلقة الإنسانية نوع من الإيجاد يستتبع هذه العلوم والإدراكات، ولا
معنى لتبديل خلق إلا أن يكون نفس التبديل أيضا من الخلق والإيجاد، وأما
تبديل الإيجاد المطلق أي إبطال حكم الواقع فلا يتصور له معنى فلن يستطيع
الإنسان، وحاشا ذلك أن يبطل علومه الفطرية، ويسلك في الحياة سبيلا آخر غير
سبيلها البتة، وأما الانحراف المشهود عن أحكام الفطرة فليس إبطالا لحكمها
بل استعمالا لها في غير ما ينبغي من نحو الاستعمال نظير ما ربما يتفق أن
الرامي لا يصيب الهدف في رميته فإن آلة الرمي وسائر شرائطه موضوعة بالطبع
للإصابة إلا أن الاستعمال يوقعها في الغلط، والسكاكين والمناشير والمثاقب
والإبر وأمثالها إذا عبئت في الماكينات تعبئة معوجة تعمل عملها الذي فطرت
عليه بعينه من قطع أو نشر أو ثقب وغير ذلك لكن لا على الوجه المقصود، وأما
الانحراف عن العمل الفطري كان يخاط بنشر المنشار، بأن يعوض المنشار فعل
الإبرة من فعل نفسه، فيضع الخياطة موضع النشر، فمن المحال ذلك.
وهذا ظاهر لمن تأمل عامة ما استدل به القوم على صحة طريقهم كقولهم: إن
الأبحاث العقلية المحضة، والقياسات المؤلفة من مقدمات بعيدة من الحس يكثر
وقوع الخطإ فيها كما يدل عليه كثرة الاختلافات في المسائل العقلية المحضة
فلا ينبغي الاعتماد عليها لعدم اطمينان النفس إليها.
وقولهم في الاستدلال على صحة طريق الحس والتجربة: أن الحس آلة لنيل خواص
الأشياء بالضرورة وإذا أحس بأثر في موضوع من الموضوعات على شرائط مخصوصة ثم
تكرر مشاهدة الأثر معه مع حفظ تلك الشرائط بعينها من غير تخلف واختلاف كشف
ذلك عن أن هذا الأثر خاصة الموضوع من غير اتفاق لأن الاتفاق لا يدوم
البتة.
والدليلان كما ترى سيقا لإثبات وجوب الاعتماد على الحس والتجربة ورفض
السلوك العقلي المحض مع كون المقدمات المأخوذة فيهما جميعا مقدمات عقلية
خارجة عن الحس والتجربة ثم أريد بالأخذ بهذه المقدمات العقلية إبطال الأخذ
بها، وهذا هو الذي تقدم أن الفطرة لن تبطل البتة وإنما يغلط الإنسان في
كيفية استعمالها!.
وأفحش من ذلك استعمال التجربة في تشخيص الأحكام المشرعة والقوانين الموضوعة
كأن يوضع حكم ثم يجري بين الناس يختبر بذلك حسن أثره بإحصاء ونحوه فإن غلب
على موارد جريانه حسن النتيجة أخذ حكما ثابتا جاريا وإلا ألقى في جانب
وأخذ آخر كذلك وهكذا، ونظيره فيه جعل الحكم بقياس أو استحسان.
والقرآن يبطل ذلك كله بإثبات أن الأحكام المشرعة فطرية بينة، والتقوى
والفجور العامين إلهاميان علميان، وأن تفاصيلها مما يجب أخذه من ناحية
الوحي، قال تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾: إسراء: 36 وقال: ﴿ولا
تتبعوا خطوات الشيطان﴾: البقرة: 186 والقرآن يسمى الشريعة المشرعة حقا قال
تعالى: ﴿أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه﴾:
البقرة: 231 وقال: ﴿وإن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾: النجم: 28 وكيف يغني
وفي اتباعه مخافة الوقوع في خطر الباطل وهو الضلال؟ قال: ﴿فما ذا بعد الحق
إلا الضلال﴾: يونس: 32 وقال: ﴿فإن الله لا يهدي من يضل﴾: النحل: 37 أي إن
الضلال لا يصلح طريقا يوصل الإنسان إلى خير وسعادة فمن أراد أن يتوسل بباطل
إلى حق أو بظلم إلى عدل أو بسيئة إلى حسنة أو بفجور إلى تقوى فقد أخطأ
الطريق، وطمع من الصنع والإيجاد الذي هو الأصل للشرائع والقوانين فيما لا
يسمح له بذلك البتة، ولو أمكن ذلك لجرى في خواص الأشياء المتضادة، وتكفل
أحد الضدين ما هو من شأن الآخر من العمل والأثر.
وكذلك
القرآن يبطل طريق التذكر الذي فيه إبطال السلوك العلمي الفكري وعزل منطق الفطرة، وقد تقدم الكلام في ذلك.
وكذلك
القرآن يحظر على الناس التفكر من غير مصاحبة تقوى الله سبحانه، وقد تقدم الكلام فيه أيضا في الجملة، ولذلك ترى
القرآن فيما يعلم من شرائع الدين يشفع الحكم الذي يبينه بفضائل أخلاقية وخصال
حميدة تستيقظ بتذكرها في الإنسان غريزة تقواه، فيقوى على فهم الحكم وفقهه،
واعتبر ذلك في أمثال قوله تعالى: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان
منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا
تعلمون﴾: البقرة: 223 وقوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين
لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين﴾: البقرة: 139 وقوله تعالى:
﴿وأقم الصلوة إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله
يعلم ما تصنعون﴾: العنكبوت: 45.
قوله تعالى: ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس
أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس
جميعا﴾ في المجمع:، الأجل في اللغة الجناية، انتهى.
وقال الراغب في المفردات:، الأجل الجناية التي يخاف منها آجلا، فكل أجل جناية وليس كل جناية أجلا.
يقال: فعلت ذلك من أجله، انتهى.
ثم استعمل للتعليل، يقال: فعلته من أجل كذا أي إن كذا سبب فعلي، ولعل
استعمال الكلمة في التعليل ابتدأ أولا في مورد الجناية والجريرة كقولنا:
أساء فلان ومن أجل ذلك أدبته بالضرب أي إن ضربي ناش من جنايته وجريرته التي
هي إساءته أو من جناية هي إساءته، ثم أرسلت كلمة تعليل فقيل: أزورك من أجل
حبي لك ولأجل حبي لك.
وظاهر السياق أن الإشارة بقوله: ﴿من أجل ذلك﴾ إلى نبأ ابني آدم المذكور في
الآيات السابقة أي إن وقوع تلك الحادثة الفجيعة كان سببا لكتابتنا على بني
إسرائيل كذا وكذا، وربما قيل: إن قوله: ﴿من أجل ذلك﴾ متعلق بقوله في الآية
السابقة: ﴿فأصبح من النادمين﴾ أي كان ذلك سببا لندامته، وهذا القول وإن كان
في نفسه غير بعيد كما في قوله تعالى: ﴿كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم
تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى﴾ الآية: البقرة: 202 إلا أن
لازم ذلك كون قوله: ﴿كتبنا على بني إسرائيل﴾ إلخ مفتتح الكلام والمعهود من
السياقات القرآنية أن يؤتى في مثل ذلك بواو الاستيناف كما في آية البقرة
المذكورة آنفا وغيرها.
وأما وجه الإشارة في قوله: ﴿من أجل ذلك﴾ إلى قصة ابني آدم فهو أن القصة تدل
على أن من طباع هذا النوع الإنساني أن يحمله اتباع الهوى والحسد الذي هو
الحنق للناس بما ليس في اختيارهم أن يحمله أوهن شيء على منازعة الربوبية
وإبطال غرض الخلقة بقتل أحدهم أخاه من نوعه وحتى شقيقه لأبيه وأمه.
فأشخاص الإنسان إنما هم أفراد نوع واحد وأشخاص حقيقة فاردة، يحمل الواحد
منهم من الإنسانية ما يحمله الكثيرون، ويحمل الكل ما يحمله البعض وإنما
أراد الله سبحانه بخلق الأفراد وتكثير النسل أن تبقى هذه الحقيقة التي ليس
من شأنها أن تعيش إلا زمانا يسيرا، ويدوم بقاؤها فيخلف اللاحق السابق ويعبد
الله سبحانه في أرضه، فإفناء الفرد بالقتل إفساد في الخلقة وإبطال لغرض
الله سبحانه في الإنسانية المستبقاة بتكثير الأفراد بطريق الاستخلاف كما
أشار إليه ابن آدم المقتول فيما خاطب أخاه: ﴿ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك
إني أخاف الله رب العالمين﴾ فأشار إلى أن القتل بغير الحق منازعة الربوبية.
فلأجل أن من طباع الإنسان أن يحمله أي سبب واه على ارتكاب ظلم يئول بحسب
الحقيقة إلى إبطال حكم الربوبية وغرض الخلقة في الإنسانية العامة، وكان من
شأن بني إسرائيل ما ذكره الله سبحانه قبل هذه
الآيات من الحسد والكبر واتباع الهوى وإدحاض الحق وقد قص قصصهم بين الله لهم
حقيقة هذا الظلم الفجيع ومنزلته بحسب الدقة، وأخبرهم بأن قتل الواحد عنده
بمنزلة قتل الجميع، وبالمقابلة إحياء نفس واحدة عنده بمنزلة إحياء الجميع.
وهذه الكتابة وإن لم تشتمل على حكم تكليفي لكنها مع ذلك لا تخلو عن تشديد
بحسب المنزلة والاعتبار، وله تأثير في إثارة الغضب والسخط الإلهي في دنيا
أو آخرة.
وبعبارة مختصرة: معنى الجملة أنه لما كان من طباع الإنسان أن يندفع بأي سبب
واه إلى ارتكاب هذا الظلم العظيم، وكان من أمر بني إسرائيل ما كان، بينا
لهم منزلة قتل النفس لعلهم يكفون عن الإسراف ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم
إنهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
وأما قوله: ﴿إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس
جميعا﴾ استثنى سبحانه قتل النفس بالنفس وهو القود والقصاص وهو قوله تعالى:
﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾: البقرة: 187 وقتل النفس بالفساد في الأرض،
وذلك قوله في الآية التالية: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون
في الأرض فسادا﴾ الآية.
وأما المنزلة التي يدل عليها قوله: ﴿فكأنما﴾ إلخ فقد تقدم بيانه أن الفرد
من الإنسان من حيث حقيقته المحمولة له التي تحيا وتموت إنما يحمل الإنسانية
التي هي حقيقة واحدة في جميع الأفراد والبعض والكل، والفرد الواحد
والأفراد