ويرد عليه ثالثا: أن الوقوع في الخطإ واقع بل غالب في طريق التذكر الذي
ذكروه فإن التذكر كما زعموه هو الطريق الذي كان يسلكه السلف الصالح دون
طريق المنطق، وقد نقل الاختلاف والخطإ فيما بينهم بما ليس باليسير كعدة من
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ممن اتفق المسلمون على علمه واتباعه
الكتاب والسنة، أو اتفق الجمهور على فقهه وعدالته، وكعدة من أصحاب الأئمة
على هذه النعوت كأبي حمزة وزرارة وأبان وأبي خالد والهشامين ومؤمن الطاق
والصفوانين وغيرهم، فالاختلافات الأساسية بينهم مشهورة معروفة ومن البين أن
المختلفين لا ينال الحق إلا أحدهما، وكذلك الفقهاء والمحدثون من القدماء
كالكليني والصدوق وشيخ الطائفة والمفيد والمرتضى وغيرهم رضوان الله عليهم،
فما هو مزية التذكر على التفكر المنطقي؟ فكان من الواجب حينئذ التماس مميز
آخر غير التذكر يميز بين الحق والباطل، وليس إلا التفكر المنطقي فهو المرجع
والموئل.
ويرد عليه رابعا: أن محصل الاستدلال أن الإنسان إذا تمسك بذيل أهل العصمة
والطهارة لم يقع في خطإ، ولازمه ما تقدم أن الرأي المأخوذ من المعصوم فيما
سمعه منه سمعا يقينيا وعلم بمراده علما يقينيا لا يقع فيه خطأ، وهذا مما لا
كلام فيه لأحد.
وفي الحقيقة المسموع من المعصوم أو المأخوذ منه مادة ليس هو عين التذكر ولا
الفكر المنطقي ثم يعقبه هو أن: هذا ما يراه المعصوم، وكل ما يراه حق فهذا
حق وهذا برهان قطعي النتيجة، وأما غير هذه الصورة من مؤديات أخبار الآحاد
أو ما يماثلها مما لا يفيد إلا الظن فإن ذلك لا يفيد شيئا ولا يوجد دليل
على حجية الآحاد في غير الأحكام إلا مع موافقة الكتاب ولا الظن يحصل على
شيء مع فرض العلم على خلافه من دليل علمي.
9 - وقول بعضهم: ﴿إن الله سبحانه خاطبنا في كلامه بما نألفه من الكلام
الدائر بيننا، والنظم والتأليف الذي يعرفه أهل اللسان، وظاهر البيانات
المشتملة على الأمر والنهي والوعد والوعيد والقصص والحكمة والموعظة والجدال
بالتي هي أحسن، وهذه أمور لا حاجة في فهمها وتعقلها إلى تعلم المنطق
والفلسفة وسائر ما هو تراث الكفار والمشركين وسبيل الظالمين، وقد نهانا عن
ولايتهم والركون إليهم واتخاذ دئوبهم واتباع سبلهم، فليس على من يؤمن بالله
ورسوله إلا أن يأخذ بظواهر البيانات الدينية، ويقف على ما يتلقاه الفهم
العادي من تلك الظواهر من غير أن يأولها أو يتعداها إلى غيرها﴾ وهذا ما
يراه الحشوية والمشبهة وعدة من أصحاب الحديث.
وهو فاسد أما من حيث الهيئة فقد استعمل فيه الأصول المنطقية وقد أريد بذلك المنع عن استعمالها بعينها، ولم يقل القائل بأن
القرآن يهدي إلى استعمال أصول المنطق: أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم المنطق، لكن
نفس الاستعمال مما لا محيص عنه، فما مثل هؤلاء في قولهم هذا إلا مثل من
يقول: إن
القرآن إنما يريد أن يهدينا إلى مقاصد الدين فلا حاجة لنا إلى تعلم اللسان الذي
هو تراث أهل الجاهلية، فكما أنه لا وقع لهذا الكلام بعد كون اللسان طريقا
يحتاج إليه الإنسان في مرحلة التخاطب بحسب الطبع وقد استعمله الله سبحانه
في كتابه والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في سنته كذلك لا معنى لما اعترض
به على المنطق بعد كونه طريقا معنويا يحتاج إليه الإنسان في مرحلة التعقل
بحسب الطبع وقد استعمله الله سبحانه في كتابه والنبي (صلى الله عليه وآله
وسلم) في سنته.
وأما بحسب المادة فقد أخذت فيه مواد عقلية، غير أنه غولط فيه من حيث
التسوية بين المعنى الظاهر من الكلام والمصاديق التي تنطبق عليها المعاني
والمفاهيم، فالذي على المسلم المؤمن بكتاب الله أن يفهمه من مثل العلم
والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام والمشيئة والإرادة مثلا أن يفهم
معاني تقابل الجهل والعجز والممات والصمم والعمى ونحوها، وأما أن يثبت لله
سبحانه علما كعلمنا وقدرة كقدرتنا وحياة كحياتنا وسمعا وبصرا وكلاما ومشيئة
وإرادة كذلك فليس له ذلك لا كتابا ولا سنة ولا عقلا، وقد تقدم شطر من
الكلام المتعلق بهذا الباب في بحث المحكم والمتشابه في الجزء الثالث من
الكتاب.
10 - وقول بعضهم: ﴿إن الدليل على حجية المقدمات التي قامت عليها الحجج
العقلية ليس إلا المقدمة العقلية القائلة بوجوب اتباع الحكم العقلي،
وبعبارة أخرى لا حجة على حكم العقل إلا نفس العقل وهذا دور مصرح فلا محيص
في المسائل الخلافية عن الرجوع إلى قول المعصوم من نبي أو إمام من غير
تقليد﴾.
هذا، وهو أسخف تشكيك أورد في هذا الباب وإنما أريد به تشييد بنيان فأنتج
هدمه، فإن القائل أبطل به حكم العقل بالدور المصرح على زعمه ثم لما عاد إلى
حكم الشرع لزمه إما أن يستدل عليه بحكم العقل وهو الدور، أو بحكم الشرع
وهو الدور فلم يزل حائرا يدور بين دورين.
إلا أن يرجع إلى التقليد وهو حيرة ثانية.
وقد اشتبه عليه الأمر في تحصيل معنى وجوب متابعة حكم العقل﴾ فإن أريد بوجوب
متابعة حكم العقل ما يقابل الحظر والإباحة ويستتبع مخالفته ذما أو عقابا
نظير وجوب متابعة الناصح المشفق، ووجوب العدل في الحكم ونحو ذلك فهو حكم
العقل العملي ولا كلام لنا فيه، وإن أريد بوجوب المتابعة أن الإنسان مضطر
على تصديق النتيجة إذا استدل عليه بمقدمات علمية وشكل صحيح علمي مع التصور
التام لأطراف القضايا فهذا أمر يشاهده الإنسان بالوجدان، ولا معنى عندئذ
لأن يسأل العقل عن الحجة، لحجية حجته لبداهة حجيته.
وهذا نظير سائر البديهيات، فإن الحجة على كل بديهي إنما هي نفسه، ومعناه أنه مستغن عن الحجة.
11 - وقول بعضهم: ﴿إن غاية ما يرومه المنطق هو الحصول على الماهيات الثابتة
للأشياء، والحصول على النتائج بالمقدمات الكلية الدائمة الثابتة، وقد ثبت
بالأبحاث العلمية اليوم أن لا كلي ولا دائم ولا ثابت في خارج ولا ذهن وإنما
هي الأشياء تجري تحت قانون التحول العام من غير أن يثبت شيء بعينه على حال
ثابتة أو دائمة أو كلية﴾.
وهذا فاسد من جهة أنه استعمل فيه الأصول المنطقية هيئة ومادة كما هو ظاهر لمن تأمل فيه.
على أن المعترض يريد بهذا الاعتراض بعينه أن يستنتج أن المنطق القديم غير
صحيح البتة، وهي نتيجة كلية دائمة ثابتة مشتملة على مفاهيم ثابتة، وإلا لم
يفده شيئا فالاعتراض يبطل نفسه.
ولعلنا خرجنا عما هو شريطة هذا الكتاب من إيثار الاختصار مهما أمكن فلنرجع إلى ما كنا فيه أولا:
القرآن الكريم يهدي العقول إلى استعمال ما فطرت على استعماله وسلوك ما تألفه
وتعرفه بحسب طبعها وهو ترتيب المعلومات لاستنتاج المجهولات، والذي فطرت
العقول عليه هو أن تستعمل مقدمات حقيقية يقينية لاستنتاج المعلومات
التصديقية الواقعية وهو البرهان، وأن تستعمل فيما له تعلق بالعمل من سعادة
وشقاوة وخير وشر ونفع وضرر وما ينبغي أن يختار ويؤثر وما لا ينبغي، وهي
الأمور الاعتبارية، المقدمات المشهورة أو المسلمة، وهو الجدل، وأن تستعمل
في موارد الخير والشر المظنونين مقدمات ظنية لإنتاج الإرشاد والهداية إلى
خير مظنون، أو الردع عن شر مظنون، وهي العظة قال تعالى: ﴿ادع إلى سبيل ربك
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن﴾: النحل: 152 والظاهر أن
المراد بالحكمة هو البرهان كما ترشد إلى ذلك مقابلته الموعظة الحسنة
والجدال.
فإن قلت: طريق التفكر المنطقي مما يقوى عليه الكافر والمؤمن، ويتأتى من
الفاسق والمتقي، فما معنى نفيه تعالى العلم المرضي والتذكر الصحيح عن غير
أهل التقوى والاتباع كما في قوله تعالى: ﴿وما يتذكر إلا من ينيب﴾: غافر:
13، وقوله: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجا﴾: الطلاق: 2، وقوله: ﴿فأعرض عمن
تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحيوة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو
أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى﴾: النجم: 30 والروايات الناطقة
بأن العلم النافع لا ينال إلا بالعمل الصالح كثيرة مستفيضة.
قلت: اعتبار الكتاب والسنة التقوى في جانب العلم مما لا ريب فيه، غير أن
ذلك ليس لجعل التقوى أو التقوى الذي معه التذكر طريقا مستقلا لنيل الحقائق
وراء الطريق الفكري الفطري الذي يتعاطاه الإنسان تعاطيا لا مخلص له منه، إذ
لو كان الأمر على ذلك لغت جميع الاحتجاجات الواردة في الكتاب على الكفار
والمشركين وأهل الفسق والفجور ممن لا يتبع الحق، ولا يدري ما هو التقوى
والتذكر فإنهم لا سبيل لهم على هذا الفرض إلى إدراك المطلوب وحالهم هذا
الحال، ومع فرض تبدل الحال يلغو الاحتجاج معهم، ونظيرها ما ورد في السنة من
الاحتجاج مع شتى الفرق والطوائف الضالة.
بل اعتبار التقوى لرد النفس الإنسانية المدركة إلى استقامتها الفطرية،
توضيح ذلك: أن الإنسان بحسب جسميته مؤلف من قوى متضادة بهيمية وسبعية
محتدها البدن العنصري، وكل واحدة منها تعمل عملها الشعوري الخاص بها من غير
أن ترتبط بغيرها من القوى ارتباطا تراعي به حالها في عملها إلا بنحو
الممانعة والمضادة فشهوة الغذاء تبعث الإنسان إلى الأكل والشرب من غير أن
يحد بحد أو يقدر بقدر من ناحية هذه القوة إلا أن يمتنع منهما المعدة مثلا
لأنها لا تسع إلا مقدارا محدودا، أو يمتنع الفك مثلا لتعب وكلال يصيب عضلته
من المضغ إذا أكثر من الأكل وأمثال ذلك، فهذه أمور نشاهدها من أنفسنا
دائما.
وإذا كان كذلك كان تمايل الإنسان إلى قوة من القوى، واسترساله في طاعة
أوامرها، والانبعاث إلى ما تبعث إليه يوجب طغيان القوة المطاعة، واضطهاد
القوة المضادة لها اضطهادا ربما بلغ بها إلى حد البطلان أو كاد يبلغ،
فالاسترسال في شهوة الطعام أو شهوة النكاح يصرف الإنسان عن جميع مهمات
الحياة من كسب وعشرة وتنظيم أمر منزل وتربية أولاد وسائر الواجبات الفردية
والاجتماعية التي يجب القيام بها، ونظيره الاسترسال في طاعة سائر القوى
الشهوية والقوى الغضبية، وهذا أيضا مما لا نزال نشاهدها من أنفسنا ومن
غيرنا خلال أيام الحياة.
وفي هذا الإفراط والتفريط هلاك الإنسانية فإن الإنسان هو النفس المسخرة
لهذه القوى المختلفة، ولا شأن له إلا سوق المجموع من القوى بأعمالها في
طريق سعادته في الحياة الدنيا والآخرة، وليست إلا حياة علمية كمالية، فلا
محيص له عن أن يعطي كلا من القوى من حظها ما لا تزاحم به القوى الأخرى ولا
تبطل من رأس.
فالإنسان لا يتم له معنى الإنسانية إلا إذا عدل قواه المختلفة تعديلا يورد
كلا منها وسط الطريق المشروع لها، وملكة الاعتدال في كل واحدة من القوى هي
التي نسميها بخلقها الفاضل كالحكمة والشجاعة والعفة وغيرها، ويجمع الجميع
العدالة.
ولا ريب أن الإنسان إنما يحصل على هذه الأفكار الموجودة عنده ويتوسع في
معارفه وعلومه الإنسانية باقتراح هذه القوى الشعورية أعمالها ومقتضياتها،
بمعنى أن الإنسان في أول كينونته صفر الكف من هذه العلوم والمعارف الوسيعة
حتى تشعر قواه الداخلة بحوائجها، وتقترح عليه ما تشتهيها وتطلبها، وهذه
الشعورات الابتدائية هي مبادىء علوم الإنسان ثم لا يزال الإنسان يعمم ويخصص
ويركب ويفصل حتى يتم له أمر الأفكار الإنسانية.
ومن هنا يحدس اللبيب أن توغل الإنسان في طاعة قوة من قواه المتضادة وإسرافه
في إجابة ما تقترح عليه يوجب انحرافه في أفكاره ومعارفه بتحكيم جميع ما
تصدقه هذه القوة على ما يعطيه غيرها من التصديقات والأفكار، وغفلته عما
يقتضيه غيرها.
والتجربة تصدق ذلك فإن هذا الانحراف هو الذي نشاهده في الأفراد المسرفين
المترفين من حلفاء الشهوة، وفي البغاة الطغاة الظلمة المفسدين أمر الحياة
في المجتمع الإنساني فإن هؤلاء الخائضين في لجج الشهوات، العاكفين على
لذائذ الشرب والسماع والوصال لا يكادون يستطيعون التفكر في واجبات
الإنسانية، ومهام الأمور التي يتنافس فيها أبطال الرجال وقد تسربت روح
الشهوة في قعودهم وقيامهم واجتماعهم وافتراقهم وغير ذلك وكذلك الطغاة
المستكبرون أقسياء القلوب لا يتأتى لهم أن يتصوروا رأفة وشفقة ورحمة وخضوعا
وتذللا حتى فيما يجب فيه ذلك، وحياتهم تمثل حالهم الخبيث الذي هم عليه في
جميع مظاهرها من تكلم وسكوت ونظر وغض وإقبال وإدبار، فهؤلاء جميعا سالكوا
طريق الخطإ في علومهم، كل طائفة منهم مكبة على ما تناله من العلوم والأفكار
المحرفة المنحرفة المتعلقة بما عنده، غافلون عما وراءه وفيما وراءه،
العلوم النافعة والمعارف الحقة الإنسانية فالمعارف الحقة والعلوم النافعة
لا تتم للإنسان إلا إذا صلحت أخلاقه وتمت له الفضائل الإنسانية القيمة وهو
التقوى.
فقد تحصل أن الأعمال الصالحة هي التي تحفظ الأخلاق الحسنة، والأخلاق الحسنة
هي التي تحفظ المعارف الحقة والعلوم النافعة والأفكار الصحيحة، ولا خير في
علم لا عمل معه.
وهذا البحث وإن سقناه سوقا علميا أخلاقيا لمسيس الحاجة إلى التوضيح إلا أنه
هو الذي جمعه الله تعالى في كلمة حيث قال: ﴿واقصد في مشيك﴾: لقمان: 19
فإنه كناية عن أخذ وسط الاعتدال في مسير الحياة، وقال: ﴿إن تتقوا الله يجعل
لكم فرقانا﴾: الأنفال: 29 وقال: ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا
أولي الألباب﴾: البقرة: 179، أي لأنكم أولوا الألباب تحتاجون في عمل لبكم
إلى التقوى والله أعلم، وقال تعالى: ﴿ونفس وما سواها فألهمها فجورها
وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها﴾: الشمس: 10 وقال: ﴿واتقوا الله
لعلكم تفلحون﴾: آل عمران: 103.
ومن طريق آخر: قال تعالى: ﴿فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوة واتبعوا
الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وءامن وعمل صالحا﴾: مريم: 60 فذكر أن
اتباع الشهوات يسوق إلى الغي، وقال تعالى: ﴿سأصرف عن ءاياتي الذين يتكبرون
في الأرض بغير الحق وإن يروا كل ءاية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا
يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا
وكانوا عنها غافلين﴾: الأعراف: 164 فذكر أن أسراء القوى الغضبية ممنوعون من
اتباع الحق مسوقون إلى سبيل الغي، ثم ذكر أن ذلك بسبب غفلتهم عن الحق،
وقال تعالى: ﴿ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون
بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم ءاذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل
هم أضل أولئك هم الغافلون﴾: الأعراف: 197 فذكر أن هؤلاء الغافلين إنما هم
غافلون عن حقائق المعارف التي للإنسان، فقلوبهم وأعينهم وآذانهم بمعزل عن
نيل ما يناله الإنسان، السعيد في إنسانيته، وإنما ينالون بها ما تناله
الأنعام أو ما هو أضل من الأنعام وهي الأفكار التي إنما تصوبها وتميل إليها
وتألف بها البهائم السائمة والسباع الضارية.
فظهر من جميع ما تقدم أن
القرآن الكريم إنما اشترط التقوى في التفكر والتذكر والتعقل، وقارن العلم بالعمل
للحصول على استقامة الفكر وإصابة العلم وخلوصه من شوائب الأوهام الحيوانية
والإلقاءات الشيطانية.
نعم هاهنا حقيقة قرآنية لا مجال لإنكارها، وهو أن دخول الإنسان في حظيرة
الولاية الإلهية، وتقربه إلى ساحة القدس والكبرياء يفتح له بابا إلى ملكوت
السماوات والأرض يشاهد منه ما خفي على غيره من آيات الله الكبرى، وأنوار
جبروته التي لا تطفأ، قال الصادق (عليه السلام): لو لا أن الشياطين يحومون
حول قلوب بني آدم لرأوا ملكوت السماوات والأرض، وفيما رواه الجمهور عن
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: لو لا تكثير في كلامكم وتمريج في
قلوبكم لرأيتم ما أرى ولسمعتم ما أسمع، وقد قال تعالى: ﴿والذين جاهدوا فينا
لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين﴾: العنكبوت: 69 ويدل على ذلك ظاهر
قوله تعالى: ﴿واعبد ربك حتى يأتيك اليقين﴾: الحجر: 99 حيث فرع اليقين على
العبادة، وقال تعالى: ﴿وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من
الموقنين﴾: الأنعام: 75 فربط وصف الإيقان بمشاهدة الملكوت، وقال تعالى:
﴿كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين﴾: التكاثر: 7
وقال تعالى: ﴿إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم
يشهده المقربون﴾: المطففين: 21 وليطلب البحث المستوفى في هذا المعنى مما
سيجيء من الكلام في قوله تعالى: ﴿إنما وليكم الله ورسوله﴾ الآية: المائدة:
55 وفي قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين ءامنوا عليكم أنفسكم﴾ الآية: المائدة:
150.
ولا ينافي ثبوت هذه الحقيقة ما قدمناه أن
القرآن الكريم يؤيد طريق التفكر الفطري الذي فطر عليه الإنسان وبني عليه بنية
الحياة الإنسانية، فإن هذا طريق غير فكري، وموهبة إلهية يختص بها من يشاء
من عباده والعاقبة للمتقين.
بحث تاريخي:
ننظر فيه نظرا إجماليا في تاريخ التفكير الإسلامي والطريق الذي سلكته الأمة
الإسلامية على اختلاف طوائفها ومذاهبها، ولا نلوي فيه إلى مذهب من المذاهب
بإحقاق أو إبطال، وإنما نعرض الحوادث الواقعة على منطق
القرآن ونحكمه في الموافقة والمخالفة، وأما ما باهى به موافق وما اعتذر به مخالف
فلا شأن لنا في الغور في أصوله وجذوره، فإنما ذلك طريق آخر من البحث مذهبي
أو غيره.
القرآن الكريم يتعرض بمنطقه في سنته المشروعة لجميع شئون الحياة الإنسانية
من غير أن تتقيد بقيد أو تشترط بشرط، يحكم على الإنسان منفردا أو مجتمعا،
صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، على الأبيض والأسود، والعربي والعجمي،
والحاضر والبادي، والعالم والجاهل، والشاهد والغائب، في أي زمان كان وفي أي
مكان كان ويداخل كل شأن من شئونه من اعتقاد أو خلق أو عمل من غير شك.
فللقرآن اصطكاك مع جميع العلوم والصناعات المتعلقة بأطراف الحياة الإنسانية
ومن الواضح اللائح من خلال آياته النادبة إلى التدبر والتفكر والتذكر
والتعقل أنه يحث حثا بالغا على تعاطي العلم ورفض الجهل في جميع ما يتعلق
بالسماويات والأرضيات والنبات والحيوان والإنسان، من أجزاء عالمنا وما
وراءه من الملائكة والشياطين واللوح والقلم وغير ذلك ليكون ذريعة إلى معرفة
الله سبحانه، وما يتعلق نحوا من التعلق بسعادة الحياة الإنسانية
الاجتماعية من الأخلاق والشرائع والحقوق وأحكام الاجتماع.
وقد عرفت أنه يؤيد الطريق الفطري من التفكر الذي تدعو إليه الفطرة دعوة
اضطرارية لا معدل عنها على حق ما تدعو إليه الفطرة من السير المنطقي.
والقرآن نفسه يستعمل هذه الصناعات المنطقية من برهان وجدل وموعظة، ويدعو
الأمة التي يهديها إلى أن يتبعوه في ذلك فيتعاطوا البرهان فيما كان من
الواقعيات الخارجة من باب العمل ويستدلوا بالمسلمات في غير ذلك أو بما
يعتبر به.
وقد اعتبر
القرآن في بيان مقاصده السنة النبوية، وعين لهم الأسوة في رسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم) فكانوا يحفظون عنه، ويقلدون مشيته العلمية تقليد المتعلم
معلمه في السلوك العلمي.
كان القوم في عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ونعني به أيام إقامته
بالمدينة حديثي عهد بالتعليم الإسلامي، حالهم أشبه بحال الإنسان القديم في
تدوين العلوم والصناعات، يشتغلون بالأبحاث العلمية اشتغالا ساذجا غير فني
على عناية منهم بالتحصيل والتحرير، وقد اهتموا أولا بحفظ
القرآن وقراءته، وحفظ الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من غير كتابة،
ونقله، وكان لهم بعض المطارحات الكلامية فيما بينهم أنفسهم، واحتجاجات مع
بعض أرباب الملل الأجنبية ولا سيما اليهود والنصارى لوجود أجيال منهم في
الجزيرة والحبشة والشام، ومن هنا يبتدىء ظهور علم الكلام وكانوا، يشتغلون
برواية الشعر وقد كانت سنة عربية لم يهتم بأمرها الإسلام ولم يمدح الكتاب
الشعر والشعراء بكلمة، ولا السنة بالغت في أمره.
ثم لما ارتحل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان من أمر الخلافة ما هو
معروف وزاد الاختلاف الحادث عند ذلك بابا على الأبواب الموجودة.
وجمع
القرآن في زمن الخليفة الأول بعد غزوة يمامة وشهادة جماعة من القراء فيها.
وكان الأمر على هذا في عهد خلافته - وهي سنتان تقريبا - ثم في عهد الخليفة الثاني.
والإسلام وإن انتشر صيته واتسع نطاقه بما رزق المسلمون من الفتوحات العظيمة
في عهده لكن الاشتغال بها كان يعوقهم عن التعمق في إجالة النظر في روابط
العلوم والتماس الارتقاء في مدارجها، أو إنهم ما كانوا يرون لما عندهم من
المستوى العلمي حاجة إلى التوسع والتبسط.
وليس العلم وفضله أمرا محسوسا يعرفه أمة من أمة أخرى إلا أن يرتبط بالصنعة فيظهر أثره على الحس فيعرفه العامة.
وقد أيقظت هذه الفتوحات المتوالية الغزيرة العرب الجاهلية من الغرور
والنخوة بعد ما كانت في سكن بالتربية النبوية، فكانت تتسرب فيهم روح الأمم
المستعلية الجبارة، وتتمكن منهم رويدا، يشهد به شيوع تقسيم الأمة المسلمة
يومئذ إلى العرب والموالي، وسير معاوية - وهو والي الشام يومذاك - بين
المسلمين بسيرة ملوكية قيصرية، وأمور أخرى كثيرة ذكرها التاريخ عن جيوش
المسلمين، وهذه نفسيات لها تأثير في السير العلمي ولا سيما التعليمات
القرآنية.
وأما الذي كان عندهم من حاضر السير العلمي فالاشتغال بالقرآن كان على حاله
وقد صار مصاحف متعددة تنسب إلى زيد وأبي وابن مسعود وغيرهم.
وأما الحديث فقد راج رواجا بينا وكثر النقل والضبط إلى حيث نهى عمر بعض
الصحابة عن التحديث لكثرة ما روى، وقد كان عدة من أهل الكتاب دخلوا في
الإسلام وأخذ عنهم المحدثون شيئا كثيرا من أخبار كتبهم وقصص أنبيائهم
وأممهم، فخلطوها بما كان عندهم من الأحاديث المحفوظة عن النبي (صلى الله
عليه وآله وسلم)، وأخذ الوضع والدس يدوران في الأحاديث، ويوجد اليوم في
الأحاديث المقطوعة المنقولة عن الصحابة ورواتهم في الصدر الأول شيء كثير من
ذلك يدفعه
القرآن بظاهر لفظه.
وجملة السبب في ذلك أمور ثلاثة:
1 - المكانة الرفيعة التي كانت تعتقدها الناس لصحبة النبي وحفظ الحديث عنه،
وكرامة الصحابة وأصحابهم النقلة عنهم على الناس، وتعظيمهم لأمرهم، فدعا
ذلك الناس إلى الأخذ والإكثار حتى عن مسلمي أهل الكتاب والرقابة الشديدة
بين حملة الحديث في حيازة التقدم والفخر.
2 - إن الحرص الشديد منهم على حفظ الحديث ونقله منعهم عن تمحيصه والتدبر في
معناه وخاصة في عرضه على كتاب الله وهو الأصل الذي تبتني عليه بنية الدين
وتستمد منه فروعه، وقد وصاهم بذلك النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيما صح
من قوله: ﴿ستكثر علي القالة﴾ الحديث، وغيره.
وحصلت بذلك فرصة لأن تدور بينهم أحاديث موضوعة في صفات الله وأسمائه
وأفعاله، وزلات منسوبة إلى الأنبياء الكرام، ومساوىء مشوهة تنسب إلى النبي
(صلى الله عليه وآله وسلم) وخرافات في الخلق والإيجاد، وقصص الأمم الماضية،
وتحريف
القرآن وغير ذلك مما لا تقصر عما تتضمنه التوراة والإنجيل من هذا القبيل.
واقتسم
القرآن والحديث عند ذلك التقدم والعمل: فالتقدم الصوري للقرآن والأخذ والعمل بالحديث فلم يلبث
القرآن دون أن هجر عملا، ولم تزل تجري هذه السيرة وهي الصفح عن عرض الحديث على
القرآن مستمرة بين الأمة عملا حتى اليوم وإن كانت تنكرها قولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا
القرآن مهجورا﴾ اللهم إلا آحاد بعد آحاد.
وهذا التساهل بعينه هو أحد الأسباب في بقاء كثير من الخرافات القومية
القديمة بين الأمم الإسلامية بعد دخولهم في الإسلام والداء يجر الداء.
3 - إن ما جرى في أمر الخلافة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
أوجب اختلاف آراء عامة المسلمين في أهل بيته فمن عاكف عليهم هائم بهم، ومن
معرض عنهم لا يعبأ بأمرهم ومكانتهم من علم
القرآن أو مبغض شانىء لهم، وقد وصاهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بما لا
يرتاب في صحته ودلالته مسلم أن يتعلموا منهم ولا يعلموهم وهم أعلم منهم
بكتاب الله، وذكر لهم أنهم لن يغلطوا في تفسيره ولن يخطئوا في فهمه قال في
حديث الثقلين المتواتر: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ولن يفترقا
حتى يردا علي الحوض الحديث.
وفي بعض طرقه: لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. وقال في المستفيض من كلامه: ﴿من فسر
القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار﴾ وقد تقدم في أبحاث المحكم والمتشابه في الجزء الثالث من الكتاب.
وهذا أعظم ثلمة انثلم بها علم
القرآن وطريق التفكر الذي يندب إليه.
ومن الشاهد على هذا الإعراض قلة الأحاديث المنقولة عنهم (عليهم السلام)
فإنك إذا تأملت ما عليه علم الحديث في عهد الخلفاء من المكانة والكرامة،
وما كان عليه الناس من الولع والحرص الشديد على أخذه ثم أحصيت ما نقل في
ذلك عن علي والحسن والحسين، وخاصة ما نقل من ذلك في
تفسير القرآن لرأيت عجبا: أما الصحابة فلم ينقلوا عن علي (عليه السلام) شيئا يذكر،
وأما التابعون فلا يبلغ ما نقلوا عنه - إن أحصي - مائة رواية في تمام
القرآن وأما الحسن (عليه السلام) فلعل المنقول عنه لا يبلغ عشرا، وأما الحسين
فلم ينقل عنه شيء يذكر، وقد أنهى بعضهم الروايات الواردة في التفسير إلى
سبعة عشر ألف حديث من طريق الجمهور وحده، وهذه النسبة موجودة في روايات
الفقه أيضا.
فهل هذا لأنهم هجروا أهل البيت وأعرضوا عن حديثهم؟ أو لأنهم أخذوا عنهم
وأكثروا ثم أخفيت ونسيت في الدولة الأموية لانحراف الأمويين عنهم؟ ما أدري.
غير أن عزلة علي وعدم اشتراكه في جمع
القرآن أولا وأخيرا وتاريخ حياة الحسن والحسين (عليهما السلام) يؤيد أول الاحتمالين.
وقد آل أمر حديثه إلى أن أنكر بعض كون ما اشتمل عليه كتاب نهج البلاغة من
غرر خطبه من كلامه، وأما أمثال الخطبة البتراء لزياد بن أبيه وخمريات يزيد
فلا يكاد يختلف فيها اثنان!.
ولم يزل أهل البيت مضطهدين، مهجورا حديثهم إلى أن انتهض الإمامان: محمد بن
علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) في برهة كالهدنة بين الدولة
الأموية والدولة العباسية فبينا ما ضاعت من أحاديث آبائهم، وجددا ما
اندرست وعفيت من آثارهم.
غير أن حديثهما وغيرهما من آبائهما وأبنائهما من أئمة أهل البيت أيضا لم
يسلم من الدخيل ولم يخلص من الدس والوضع كحديث رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم)، وقد ذكرا ذلك في الصريح من كلامهما، وعدا رجالا من الوضاعين
كمغيرة بن سعيد وابن أبي الخطاب وغيرهما، وأنكر بعض الأئمة روايات كثيرة
مروية عنهم وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأمروا أصحابهم وشيعتهم
بعرض الأحاديث المنقولة عنهم على
القرآن وأخذ ما وافقه وترك ما خالفه.
ولكن القوم إلا آحاد منهم لم يجروا عليها عملا في أحاديث أهل البيت (عليهم
السلام) وخاصة في غير الفقه، وكان السبيل الذي سلكوه في ذلك هو السبيل الذي
سلكه الجمهور في أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
وقد أفرط في الأمر إلى حيث ذهب جمع إلى عدم حجية ظواهر الكتاب وحجية مثل
مصباح الشريعة وفقه الرضا وجامع الأخبار! وبلغ الإفراط إلى حيث ذكر بعضهم
أن الحديث يفسر
القرآن مع مخالفته لصريح دلالته، وهذا يوازن ما ذكره بعض الجمهور: أن الخبر ينسخ الكتاب.
ولعل المتراءى من أمر الأمة لغيرهم من الباحثين كما ذكره بعضهم: (أن أهل
السنة أخذوا بالكتاب وتركوا العترة، فآل ذلك إلى ترك الكتاب لقول النبي
(صلى الله عليه وآله وسلم): ﴿إنهما لن يفترقا﴾ وأن الشيعة أخذوا بالعترة
وتركوا الكتاب، فآل ذلك منهم إلى ترك العترة لقوله (صلى الله عليه وآله
وسلم): ﴿إنهما لن يفترقا﴾ فقد تركت الأمة
القرآن والعترة الكتاب والسنة معا).
وهذه الطريقة المسلوكة في الحديث أحد العوامل التي عملت في انقطاع رابطة العلوم الإسلامية وهي العلوم الدينية والأدبية عن
القرآن مع أن الجميع كالفروع والثمرات من هذه الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت
وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وذلك أنك إن تبصرت في أمر
هذه العلوم وجدت أنها نظمت تنظيما لا حاجة لها إلى
القرآن أصلا حتى أنه يمكن لمتعلم أن يتعلمها جميعا: الصرف والنحو والبيان واللغة
والحديث والرجال والدراية والفقه والأصول فيأتي آخرها، ثم يتضلع بها ثم
يجتهد ويتمهر فيها وهو لم يقرأ القرآن، ولم يمس مصحفا قط، فلم يبق للقرآن
بحسب الحقيقة إلا التلاوة لكسب الثواب أو اتخاذه تميمة للأولاد تحفظهم عن
طوراق الحدثان! فاعتبر إن كنت من أهله.
ولنرجع إلى ما كنا فيه: كان حال البحث عن
القرآن والحديث في عهد عمر ما سمعته، وقد اتسع نطاق المباحث الكلامية في هذا
العهد لما أن الفتوحات الوسيعة أفضت بالطبع إلى اختلاط المسلمين بغيرهم من
الأمم وأرباب الملل والنحل وفيهم العلماء والأحبار والأساقفة والبطارقة
الباحثون في الأديان والمذاهب فارتفع منار الكلام لكن لم يدون بعد تدوينا،
فإن ما عد من التآليف فيه إنما ذكر في ترجمات من هو بعد هذا العصر.
ثم كان الأمر على ذلك في عهد عثمان على ما فيه من انقلاب الناس على الخلافة، وإنما وفق لجمع المصاحف، والاتفاق على مصحف واحد.
ثم كان الأمر على ذلك في خلافة علي (عليه السلام) وشغله إصلاح ما فسد من
مجتمع المسلمين بالاختلافات الداخلية ووقع حروب متوالية في إثر ذلك.
غير أنه (عليه السلام) وضع علم النحو وأملأ كلياته أبا الأسود الدئلي من
أصحابه وأمره بجمع جزئيات قواعده، ولم يتأت له وراء ذلك إلا أن ألقى بيانات
من خطب وأحاديث فيها جوامع مواد المعارف الدينية وأنفس الأسرار القرآنية،
وله مع ذلك احتجاجات كلامية مضبوطة في جوامع الحديث.
ثم كان الأمر على ذلك في خصوص
القرآن والحديث في عهد معاوية ومن بعده من الأمويين والعباسيين إلى أوائل القرن
الرابع من الهجرة تقريبا وهو آخر عهد الأئمة الاثني عشر عند الشيعة، فلم
يحدث في طريق البحث عن
القرآن والحديث أمر مهم غير ما كان في عهد معاوية من بذل الجهد في إماتة ذكر أهل
البيت (عليهم السلام) وإعفاء أثرهم ووضع الأحاديث، وقد انقلبت الحكومة
الدينية إلى سلطنة استبدادية، وتغيرت السنة الإسلامية إلى سيطرة
إمبراطورية، وما كان في عهد عمر بن عبد العزيز من أمره بكتابة الحديث، وقد
كان المحدثون يتعاطون الحديث إلى هذه الغاية بالأخذ والحفظ من غير تقييد
بالكتابة.
وفي هذه البرهة راج الأدب العربي غاية رواجه، شرع ذلك من زمن معاوية فقد
كان يبالغ في ترويج الشعر ثم الذين يلونه من الأمويين ثم العباسيين، وكان
ربما يبذل بإزاء بيت من الشعر أو نكتة أدبية المئات والألوف من الدنانير،
وانكب الناس على الشعر وروايته، وأخبار العرب وأيامهم، وكانوا يكتسبون بذلك
الأموال الخطيرة، وكانت الأمويون ينتفعون برواجه وبذل الأموال بحذائه
لتحكيم موقعهم تجاه بني هاشم ثم العباسيون تجاه بني فاطمة كما كانوا
يبالغون في إكرام العلماء ليظهروا بهم على الناس، ويحملوهم ما شاءوا
وتحكموا.
وبلغ من نفوذ الشعر والأدب في المجتمع العلمي أنك ترى كثيرا من العلماء
يتمثلون بشعر شاعر أو مثل سائر في مسائل عقلية أو أبحاث علمية ثم يكون له
القضاء، وكثيرا ما يبنون المقاصد النظرية على مسائل لغوية ولا أقل من البحث
اللغوي في اسم الموضوع أولا ثم الورود في البحث ثانيا، وهذه كلها أمور لها
آثار عميقة في منطق الباحثين وسيرهم العلمي.
وفي تلك الأيام راج البحث الكلامي، وكتب فيه الكتب والرسائل، ولم يلبثوا أن
تفرقوا فرقتين عظيمتين وهما الأشاعرة والمعتزلة، وكانت أصول أقوالهم
موجودة في زمن الخلفاء بل في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يدل على
ذلك ما روي من احتجاجات علي (عليه السلام) في الجبر والتفويض والقدر
والاستطاعة وغيرها، وما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في ذلك
وإنما امتازت الطائفتان في هذا الأوان بامتياز المسلكين وهو تحكيم المعتزلة
ما يستقل به العقل على الظواهر الدينية كالقول بالحسن والقبح العقليين،
وقبح الترجيح من غير مرجح، وقبح التكليف بما لا يطاق، والاستطاعة،
والتفويض، وغير ذلك، وتحكيم الأشاعرة الظواهر على حكم العقل بالقول بنفي
الحسن والقبح، وجواز الترجيح من غير مرجح، ونفي الاستطاعة، والقول بالجبر،
وقدم كلام الله، وغير ذلك مما هو مذكور في كتبهم.
ثم رتبوا الفن واصطلحوا الاصطلاحات وزادوا مسائل قابلوا بها الفلاسفة في
المباحث المعنوية بالأمور العامة، وذلك بعد نقل كتب الفلسفة إلى العربية
وانتشار دراستها بين المسلمين، وليس الأمر على ما ذكره بعضهم: أن التكلم
ظهر أو انشعب في الإسلام إلى الاعتزال والأشعرية بعد انتقال الفلسفة إلى
العرب، يدل على ذلك وجود معظم مسائلهم وآرائهم في الروايات قبل ذلك.
ولم تزل المعتزلة تتكثر جماعتهم وتزداد شوكتهم وأبهتهم منذ أول الظهور إلى
أوائل العهد العباسي أوائل القرن الثالث الهجري ثم رجعوا يسلكون سبيل
الانحطاط والسقوط حتى أبادتهم الملوك من بني أيوب فانقرضوا وقد قتل في
عهدهم وبعدهم لجرم الاعتزال من الناس ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وعند ذلك
صفا جو البحث الكلامي للأشاعرة من غير معارض فتوغلوا فيه بعد ما كان
فقهاؤهم يتأثمون بذلك أولا، ولم يزل الأشعرية رائجة عندهم إلى اليوم.
وكان للشيعة قدم في التكلم، كان أول طلوعهم بالتكلم بعد رحلة النبي (صلى
الله عليه وآله وسلم) وكان جلهم من الصحابة كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار
وعمرو بن الحمق وغيرهم ومن التابعين كرشيد وكميل وميثم وسائر العلويين
أبادتهم أيدي الأمويين، ثم تأصلوا وقوي أمرهم ثانيا في زمن الإمامين:
الباقر والصادق (عليهما السلام) وأخذوا بالبحث وتأليف الكتب والرسائل، ولم
يزالوا يجدون الجد تحت قهر الحكومات واضطهادها حتى رزقوا بعض الأمن في
الدولة البويهية ثم أخنقوا ثانيا حتى صفا لهم الأمر بظهور الدولة الصفوية
في إيران، ثم لم يزالوا على ذلك حتى اليوم.
وكانت سيماء بحثهم في الكلام أشبه بالمعتزلة منها بالأشاعرة، ولذلك ربما
اختلط بعض الآراء كالقول بالحسن والقبح ومسألة الترجيح من غير مرجح ومسألة
القدر ومسألة التفويض، ولذلك أيضا اشتبه الأمر على بعض الناس فعد الطائفتين
أعني الشيعة والمعتزلة ذواتي طريقة واحدة في البحث الكلامي، كفرسي رهان،
وقد أخطأ، فإن الأصول المروية عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وهي
المعتبرة عند القوم لا تلائم مذاق المعتزلة في شيء.
وعلى الجملة فن الكلام فن شريف يذب عن المعارف الحقة الدينية غير أن
المتكلمين من المسلمين أساءوا في طريق البحث فلم يميزوا بين الأحكام
العقلية واختلط عندهم الحق بالمقبول على ما سيجيء إيضاحه بعض الإيضاح.
وفي هذه البرهة من الزمن نقلت علوم الأوائل من المنطق والرياضيات
والطبيعيات والإلهيات والطب والحكمة العملية إلى العربية، نقل شطر منها في
عهد الأمويين ثم أكمل في أوائل عهد العباسيين، فقد ترجموا مئات من الكتب من
اليونانية والرومية والهندية والفارسية والسريانية إلى العربية، وأقبل
الناس يتدارسون مختلف العلوم ولم يلبثوا كثيرا حتى استقلوا بالنظر، وصنفوا
فيها كتبا ورسائل، وكان ذلك يغيظ علماء الوقت، ولا سيما ما كانوا يشاهدونه
من تظاهر الملاحدة من الدهرية والطبيعية والمانوية وغيرهم على المسائل
المسلمة في الدين، وما كان عليه المتفلسفون من المسلمين من الوقيعة في
الدين وأهله، وتلقي أصول الإسلام ومعالم الشرع الطاهرة بالإهانة والإزراء
ولا داء كالجهل ومن أشد ما كان يغيظهم ما كانوا يسمعونه منهم من القول في
المسائل المبتنية على أصول موضوعة مأخوذة من الهيئة والطبيعيات كوضع
الأفلاك البطليموسية، وكونها طبيعة خامسة، واستحالة الخرق والالتيام فيها،
وقدم الأفلاك والفلكيات بالشخص وقدم العناصر بالنوع، وقدم الأنواع ونحو ذلك
فإنها مسائل مبنية على أصول موضوعة لم يبرهن عليها في الفلسفة لكن الجهلة
من المتفلسفين كانوا يظهرونها في زي المسائل المبرهن عليها، وكانت الدهرية
وأمثالهم وهم يومئذ منتحلون إليها يضيفون إلى ذلك أمورا أخرى من أباطيلهم
كالقول بالتناسخ ونفي المعاد ولا سيما المعاد الجسماني، ويطعنون بذلك كله
في ظواهر الدين وربما قال القائل منهم: إن الدين مجموع وظائف تقليدية أتى
بها الأنبياء لتربية العقول الساذجة البسيطة وتكميلها، وأما الفيلسوف
المتعاطي للعلوم الحقيقية فهو في غنى عنهم وعما أتوا به، وكانوا ذوي أقدام
في طرق الاستدلال.
فدعا ذلك الفقهاء والمتكلمين وحملهم على تجبيههم بالإنكار والتدمير عليهم
بأي وسيلة تيسرت لهم من محاجة ودعوة عليهم وبراءة منهم وتكفير لهم حتى
كسروا سورتهم وفرقوا جمعهم وأفنوا كتبهم في زمن المتوكل، وكادت الفلسفة
تنقرض بعده حتى جدده ثانيا المعلم الثاني أبو نصر الفارابي المتوفى سنة 393
ثم بعده الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا المتوفى سنة 482
ثم غيرهما من معاريف الفلسفة كأبي علي بن مسكويه وابن رشد الأندلسي
وغيرهما، ثم لم تزل الفلسفة تعيش على قلة من متعاطيها وتجول بين ضعف وقوة.
وهي وإن انتقلت ابتداء إلى العرب لكن لم يشتهر بها منهم إلا الشاذ النادر
كالكندي وابن رشد، وقد استقرت أخيرا في إيران، والمتكلمون من المسلمين وإن
خالفوا الفلسفة وأنكروا على أهلها أشد الإنكار لكن جمهورهم تلقوا المنطق
بالقبول فألفوا فيها الرسائل والكتب لما وجدوه موافقا لطريق الاستدلال
الفطري.
غير أنهم - كما سمعت - أخطئوا في استعماله فجعلوا حكم الحدود الحقيقية
وأجزائها مطردا في المفاهيم الاعتبارية، واستعملوا البرهان في القضايا
الاعتبارية التي لا مجرى فيها إلا للقياس الجدلي فتراهم يتكلمون في
الموضوعات الكلامية كالحسن والقبح والثواب والعقاب والحبط والفضل في
أجناسها وفصولها وحدودها، وأين هي من الحد؟ ويستدلون في المسائل الأصولية
والمسائل الكلامية من فروع الدين بالضرورة والامتناع.
وذلك من استخدام الحقائق في الأمور الاعتبارية ويبرهنون في أمور ترجع إلى
الواجب تعالى بأنه يجب عليه كذا ويقبح منه كذا فيحكمون الاعتبارات على
الحقائق، ويعدونه برهانا، وليس بحسب الحقيقة إلا من القياس الشعري.
وبلغ الإفراط في هذا الباب إلى حد قال قائلهم: إن الله سبحانه أنزه ساحة من
أن يدب في حكمه وفعله الاعتبار الذي حقيقته الوهم فكل ما كونه تكوينا أو
شرعه تشريعا أمور حقيقية واقعية، وقال آخر: إن الله سبحانه أقدر من أن يحكم
بحكم ثم لا يستطاع من إقامة البرهان عليه، فالبرهان يشمل التكوينيات
والتشريعيات جميعا.
إلى غير ذلك من الأقاويل التي هي لعمري من مصائب العلم وأهله، ثم الاضطرار إلى وضعها والبحث عنها في المسفورات العلمية أشد مصيبة.
وفي هذه البرهة ظهر التصوف بين المسلمين، وقد كان له أصل في عهد الخلفاء
يظهر في لباس الزهد، ثم بان الأمر بتظاهر المتصوفة في أوائل عهد بني العباس
بظهور رجال منهم كأبي يزيد والجنيد والشبلي ومعروف وغيرهم.
يرى القوم أن السبيل إلى حقيقة الكمال الإنساني والحصول على حقائق المعارف
هو الورود في الطريقة، وهي نحو ارتياض بالشريعة للحصول على الحقيقة، وينتسب
المعظم منهم من الخاصة والعامة إلى علي (عليه السلام).
وإذا كان القوم يدعون أمورا من الكرامات، ويتكلمون بأمور تناقض ظواهر الدين
وحكم العقل مدعين أن لها معاني صحيحة لا ينالها فهم أهل الظاهر ثقل على
الفقهاء وعامة المسلمين سماعها فأنكروا ذلك عليهم وقابلوهم بالتبري
والتكفير، فربما أخذوا بالحبس أو الجلد أو القتل أو الصلب أو الطرد أو
النفي كل ذلك لخلاعتهم واسترسالهم في أقوال يسمونها أسرار الشريعة، ولو كان
الأمر على ما يدعون وكانت هي لب الحقيقة وكانت الظواهر الدينية كالقشر
عليها وكان ينبغي إظهارها والجهر بها لكان مشرع الشرع أحق برعاية حالها
وإعلان أمرها كما يعلنون، وإن لم تكن هي الحق فما ذا بعد الحق إلا الضلال؟.
والقوم لم يدلوا في أول أمرهم على آرائهم في الطريقة إلا باللفظ ثم زادوا
على ذلك بعد أن أخذوا موضعهم من القلوب قليلا بإنشاء كتب ورسائل بعد القرن
الثالث الهجري، ثم زادوا على ذلك بأن صرحوا بآرائهم في الحقيقة والطريقة
جميعا بعد ذلك فانتشر منهم ما أنشئوه نظما ونثرا في أقطار الأرض.
ولم يزالوا يزيدون عدة وعدة ووقوعا في قلوب العامة ووجاهة حتى بلغوا غاية
أوجهم في القرنين السادس والسابع ثم انتكسوا في المسير وضعف أمرهم وأعرض
عامة الناس عنهم.
وكان السبب في انحطاطهم أولا أن شأنا من الشئون الحيوية التي لها مساس بحال
عامة الناس إذا اشتد إقبال النفوس عليه وتولع القلوب إليه تاقت إلى
الاستدرار من طريقه نفوس وجمع من أرباب المطامع فتزيوا بزيه وظهروا في صورة
أهله وخاصته فأفسدوا فيه وتعقب ذلك تنفر الناس عنه.
وثانيا: أن جماعة من مشايخهم ذكروا أن طريقة معرفة النفس طريقة مبتدعة لم
يذكرها مشرع الشريعة فيما شرعه إلا أنها طريقة مرضية ارتضاها الله سبحانه
كما ارتضى الرهبانية المبتدعة بين النصارى قال تعالى: ﴿ورهبانية ابتدعوها
ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها﴾: الحديد:
27.
وتلقاه الجمهور منهم بالقبول فأباح ذلك لهم أن يحدثوا للسلوك رسوما وآدابا
لم تعهد في الشريعة، فلم تزل تبتدع سنة جديدة وتترك أخرى شرعية، حتى آل إلى
أن صارت الشريعة في جانب، والطريقة في جانب، وآل بالطبع إلى انهماك
المحرمات وترك الواجبات من شعائر الدين ورفع التكاليف، وظهور أمثال
القلندرية ولم يبق من التصوف إلا التكدي واستعمال الأفيون والبنج وهو
الفناء.
والذي يقضي به في ذلك الكتاب والسنة - وهما يهديان إلى حكم العقل - هو أن
القول بأن تحت ظواهر الشريعة حقائق هي باطنها حق، والقول بأن للإنسان طريقا
إلى نيلها حق، ولكن الطريق إنما هو استعمال الظواهر الدينية على ما ينبغي
من الاستعمال لا غير، وحاشا أن يكون هناك باطن لا يهدي إليه ظاهر، والظاهر
عنوان الباطن وطريقه، وحاشا أن يكون هناك شيء آخر أقرب مما دل عليه شارع
الدين غفل عنه أو تساهل في أمره أو أضرب عنه لوجه من الوجوه بالمرة وهو
القائل عز من قائل: ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء﴾: النحل: 89
وبالجملة فهذه طرق ثلاثة في البحث عن الحقائق والكشف عنها: الظواهر الدينية
وطريق البحث العقلي وطريق تصفية النفس، أخذ بكل منها طائفة من المسلمين
على ما بين الطوائف الثلاث من التنازع والتدافع، وجمعهم في ذلك كزوايا
المثلث كلما زدت في مقدار واحدة منها نقصت من الأخريين وبالعكس.
وكان الكلام في التفسير يختلف اختلافا فاحشا بحسب اختلاف مشرب المفسرين بمعنى أن الن







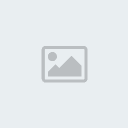

 نا
نا

