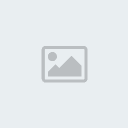•
الآيات 51-54
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ
وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم
مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴿51﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ
فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللّهُ أَن
يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا
أَسَرُّواْ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴿52﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُواْ
أَهَؤُلاء الَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ
لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَاسِرِينَ ﴿53﴾ يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ
يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ
اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ
مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿54﴾
بيان:
السير الإجمالي في هذه
الآيات يوجب التوقف في اتصال هذه
الآيات بما قبلها، و كذا في اتصال ما بعدها كقوله تعالى: ﴿إنما وليكم الله و
رسوله﴾ إلى آخر الآيتين ثم اتصال قوله بعدهما: ﴿يا أيها الذين ءامنوا لا
تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا﴾ إلى تمام عدة آيات ثم في اتصال قوله: ﴿يا
أيها الرسول بلغ﴾ الآية.
أما هذه
الآيات الأربع فإنها تذكر اليهود و النصارى، و
القرآن لم يكن ليذكر أمرهم في آياته المكية لعدم مسيس الحاجة إليه يومئذ بل إنما
يتعرض لحالهم في المدينة من الآيات، و لا فيما نزلت منها في أوائل الهجرة
فإن المسلمين إنما كانوا مبتلين يومئذ بمخالطة اليهود و معاشرتهم أو
موادعتهم أو دفع كيدهم و مكرهم خاصة دون النصارى إلا في النصف الأخير من
زمن إقامة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمدينة فلعل
الآيات الأربع نزلت فيه، و لعل المراد بالفتح فيها فتح مكة.
لكن تقدم أن الاعتماد على نزول سورة
المائدة في سنة حجة الوداع و قد فتحت مكة فهل المراد بالفتح فتح آخر غير فتح مكة؟ أو أن هذه
الآيات نزلت قبل فتح مكة و قبل نزول السورة جميعا؟.
ثم إن الآية الأخيرة أعني قوله: ﴿يا أيها الذين ءامنوا من يرتد منكم﴾ الآية
هل هي متصلة بالآيات الثلاث المتقدمة عليها؟ و من المراد بهؤلاء القوم
الذين تتوقع ردتهم؟ و من هؤلاء الآخرون الذين وعد الله أنه سيأتي بهم؟ كل
واحد منها أمر يزيد إبهاما على إبهام، و قد تشتت ما ورد من أسباب النزول و
ليست إلا أنظار المفسرين من السلف كغالب أسباب النزول المنقولة في الآيات، و
هذا الاختلاف الفاحش أيضا مما يشوش الذهن في تفهم المعنى، أضف إلى ذلك كله
مخالطة التعصبات المذهبية الأنظار القاضية فيها كما سيمر بك شواهد تشهد
على ذلك من الروايات و أقوال المفسرين من السلف و الخلف.
والذي يعطيه التدبر في
الآيات أن هذه
الآيات الأربع على ما نقلناها متصلة الأجزاء منقطعة عما قبلها و ما بعدها، و أن
الآية الرابعة من متممات الغرض المقصود بيانه فيها غير أنه يجب التحرز في
فهم معناها عن المساهلات و المسامحات التي جوزتها أنظار الباحثين من
المفسرين في
الآيات و خاصة فيما ذكر فيها من الأوصاف و النعوت على ما سيجيء.
وإجمال ما يتحصل من
الآيات أن الله سبحانه يحذر المؤمنين فيها اتخاذ اليهود و النصارى أولياء، و
يهددهم في ذلك أشد التهديد، و يشير في ملحمة قرآنية إلى ما يئول إليه أمر
هذه الموالاة من انهدام بنية السيرة الدينية، و أن الله سيبعث قوما يقومون
بالأمر، و يعيدون بنية الدين إلى عمارتها الأصلية.
قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين ءامنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى أولياء
بعضهم أولياء بعض﴾ قال في المجمع:، الاتخاذ هو الاعتماد على الشيء لإعداده
لأمر، و هو افتعال من الأخذ، و أصله الائتخاذ فأبدلت الهمزة تاء، و أدغمتها
في التاء التي بعدها و مثله الاتعاد من الوعد، و الأخذ يكون على وجوه
تقول: أخذ الكتاب إذا تناوله، و أخذ القربان إذا تقبله، و أخذه الله من
مأمنه إذا أهلكه، و أصله جواز الشيء من جهة إلى جهة من الجهات. انتهى.
وقال الراغب في المفردات:، الولاء و التوالي أن يحصل شيئان فصاعدا حصولا
ليس بينهما ما ليس منهما، و يستعار ذلك للقرب من حيث المكان، و من حيث
النسبة و من حيث الدين، و من حيث الصداقة و النصرة و الاعتقاد انتهى موضع
الحاجة و سيأتي استيفاء البحث في معنى الولاية.
وبالجملة الولاية نوع اقتراب من الشيء يوجب ارتفاع الموانع و الحجب بينهما
من حيث ما اقترب منه لأجله فإن كان من جهة التقوى و الانتصار فالولي هو
الناصر الذي لا يمنعه عن نصرة من اقترب منه شيء، و إن كان من جهة الالتيام
في المعاشرة و المحبة التي هي الانجذاب الروحي فالولي هو المحبوب الذي لا
يملك الإنسان نفسه دون أن ينفعل عن إرادته، و يعطيه فيما يهواه و إن كان من
جهة النسب فالولي هو الذي يرثه مثلا من غير مانع يمنعه، و إن كان من جهة
الطاعة فالولي هو الذي يحكم في أمره بما يشاء.
ولم يقيد الله سبحانه في قوله: ﴿لا تتخذوا اليهود و النصارى أولياء﴾
الولاية بشيء من الخصوصيات و القيود فهي مطلقة غير أن قوله تعالى في الآية
التالية: ﴿فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا
دائرة﴾، يدل على أن المراد بالولاية نوع من القرب و الاتصال يناسب هذا الذي
اعتذروا به بقولهم: ﴿نخشى أن تصيبنا دائرة﴾ و هي الدولة تدور عليهم، و كما
أن الدائرة من الجائز أن تصيبهم من غير اليهود و النصارى فيتأيدوا بنصرة
الطائفتين بأخذهما أولياء النصرة كذلك يجوز أن تصيبهم من نفس اليهود و
النصارى فينجو منها باتخاذهما أولياء المحبة و الخلطة.
والولاية بمعنى قرب المحبة و الخلطة تجمع الفائدتين جميعا أعني فائدة
النصرة و الامتزاج الروحي فهو المراد بالآية، و سيجيء ما في القيود و
الصفات المأخوذة في الآية الأخيرة: ﴿يا أيها الذين ءامنوا من يرتد منكم عن
دينه﴾، من الدلالة على أن المراد بالولاية هاهنا ولاية المحبة لا غير.
وقد أصر بعض المفسرين على أن المراد بالولاية ولاية النصرة و هي التي تجري
بين إنسانين أو قومين من الحلف أو العهد على نصرة أحد الوليين الآخر عند
الحاجة، و استدل على ذلك بما محصله أن
الآيات - كما يلوح من ظاهرها - منزلة قبل حجة الوداع في أوائل الهجرة أيام كان
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و المسلمون لم يفرغوا من أمر يهود المدينة
و من حولهم من يهود فدك و خيبر و غيرهم، و من ورائهم النصارى و كان بين
طوائف من العرب و بينهم عقود من ولاية النصرة و الحلف، و ربما انطبق على ما
ورد في أسباب النزول أن عبادة بن الصامت من بني عوف بن الخزرج تبرأ من بني
قينقاع لما حاربت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و كان بينه و بينهم
ولاية حلف، لكن عبد الله بن أبي رأس المنافقين لم يتبرأ منهم و سارع فيهم
قائلا: نخشى أن تصيبنا دائرة.
أو ما ورد في قصة أبي لبابة لما أرسله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
ليخرج بني قريظة من حصنهم و ينزلهم على حكمه، فأشار أبو لبابة بيده إلى
حلقه: أنه الذبح.
أو ما ورد أن بعضهم كان يكاتب نصارى الشام بأخبار المدينة، و بعضهم كان يكاتب يهود المدينة لينتفعوا بمالهم و لو بالقرض.
أو ما ورد أن بعضهم قال: إنه يلحق بفلان اليهودي أو بفلان النصراني إثر ما نزل بهم يوم أحد من القتل و الهزيمة.
وهؤلاء الروايات كالمتفقة في أن القائلين: ﴿نخشى أن تصيبنا دائرة﴾ كانوا هم
المنافقين، و بالجملة فالآيات إنما تنهى عن المحالفة و ولاية النصرة بين
المسلمين و بين اليهود و النصارى.
وقد أكد ذلك بعضهم حتى ادعى أن كون الولاية في الآية بمعنى ولاية المحبة و
الاعتماد مما تتبرأ منه لغة الآية في مفرداتها و سياقها كما يتبرأ منه سبب
النزول و الحالة العامة التي كان عليها المسلمون و الكتابيون في عصر
التنزيل.
وكيف يصح حمل الآية على النهي عن معاشرتهم و الاختلاط بهم و إن كانوا ذوي
ذمة أو عهد، و قد كان اليهود يقيمون مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و
مع الصحابة في المدينة، و كانوا يعاملونهم بالمساواة التامة انتهى ما ذكره
ملخصا.
وهذا كله من التساهل في تحصيل معنى الآية أما ما ذكروه من كون
الآيات نازلة قبل عام حجة الوداع و هي سنة نزول سورة
المائدة فمما ليس فيه كثير إشكال لكنه لا يوجب كون الولاية بمعنى المحالفة دون ولاية المحبة.
وأما ما ذكروه من أسباب النزول و دلالتها على كون
الآيات نازلة في خصوص المحالفة و ولاية النصرة التي كانت بين أقوام من العرب و بين اليهود و النصارى.
ففيه أولا أن أسباب النزول في نفسها متعارضة لا ترجع إلى معنى واحد يوثق و
يعتمد عليه، و ثانيا أنها لا توجه ولاية النصارى و إن وجهت ولاية اليهود
بوجه إذ لم يكن بين العرب من المسلمين و بين النصارى ولاية الحلف يومئذ، و
ثالثا أنا نصدق أسباب النزول فيما تقتضيها إلا أنك قد عرفت فيما مر أن جل
الروايات الواردة في أسباب النزول على ضعفها متضمنة لتطبيق الحوادث
المنقولة تاريخا على
الآيات القرآنية المناسبة لها، و هذا أيضا لا بأس به.
وأما الحكم بأن الوقائع المذكورة فيها تخصص عموم آية من
الآيات القرآنية أو تقيد إطلاقها بحسب اللفظ فمما لا ينبغي التفوه به، و لا أن الظاهر المتفاهم يساعده.
ولو تخصص أو تقيد ظاهر
الآيات بخصوصية في سبب النزول غير مأخوذة في لفظ الآية لمات
القرآن بموت من نزل فيهم، و انقطع الحجاج به في واقعة من الوقائع التي بعد عصر التنزيل، و لا يوافقه كتاب و لا سنة و لا عقل سليم.
وأما ما ذكره بعضهم: ﴿أن أخذ الولاية بمعنى المحبة و الاعتماد خطأ تتبرأ
منه لغة الآية في مفرداتها و سياقها كما يتبرأ منه أسباب النزول و الحالة
العامة التي كان عليها المسلمون و الكتابيون في عصر التنزيل﴾ فمما لا يرجع
إلى معنى محصل بعد التأمل فيه فإن ما ذكره من تبري أسباب النزول و ما ذكره
من الحالة العامة أن تشمل
الآيات ذلك و تصدق عليه إذا لم يأب ظهور الآية من الانطباق عليه، و أما قصر
الدلالة على مورد النزول و الحالة العامة الموجودة وقتئذ فقد عرفت أنه لا
دليل عليه بل الدليل - و هو حجية الآية في ظهورها المطلق - على خلافه فقد
عرفت أن الآية مطلقة من غير دليل على تقييدها فتكون حجة في المعنى المطلق، و
هو الولاية بمعنى المحبة.
وما ذكره من تبري الآية بمفرداتها و سياقها من ذلك من عجيب الكلام، و ليت
شعري ما الذي قصده من هذا التبري الذي وصفه و حمله على مفردات الآية و لم
يقنع بذلك دون أن عطف عليها سياقها.
وكيف تتبرأ من ذلك مفردات الآية أو سياقها و قد وقع فيها بعد قوله: ﴿لا
تتخذوا اليهود و النصارى أولياء﴾ قوله تعالى: ﴿بعضهم أولياء بعض﴾ و لا ريب
في أن المراد بهذه الولاية ولاية المحبة و الاتحاد و المودة، دون ولاية
الحلف إذ لا معنى لأن يقال: لا تحالفوا اليهود و النصارى بعضهم حلفاء بعض، و
إنما كان ما يكون الوحدة بين اليهود و يرد بعضهم إلى بعض هو ولاية المحبة
القومية، و كذا بين النصارى من دون تحالف بينهم أو عهد إلا مجرد المحبة و
المودة من جهة الدين؟.
وكذا قوله تعالى بعد ذلك: ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾ فإن الاعتبار الذي
يوجب كون موالي جماعة من تلك الجماعة هو أن المحبة و المودة تجمع المتفرقات
و توحد الأرواح المختلفة و تتوحد بذلك الإدراكات، و ترتبط به الأخلاق، و
تتشابه الأفعال، و ترى المتحابين بعد استقرار ولاية المحبة كأنهما شخص واحد
ذو نفسية واحدة، و إرادة واحدة، و فعل واحد لا يخطىء أحدهما الآخر في مسير
الحياة، و مستوى العشرة.
فهذا هو الذي يوجب كون من تولى قوما منهم و لحوقه بهم، و قد قيل: من أحب
قوما فهو منهم، و المرء مع من أحب، و قد قال تعالى في نظيره نهيا عن موالاة
المشركين: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي و عدوكم أولياء تلقون
إليهم بالمودة و قد كفروا بما جاءكم من الحق - إلى أن قال بعد عدة آيات - و
من يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون﴾: الممتحنة: 9 و قال تعالى: ﴿لا تجد
قوما يؤمنون بالله و اليوم الآخر يوادون من حاد الله و رسوله و لو كانوا
آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم﴾: المجادلة: 22، و قال تعالى في
تولي الكافرين - و اللفظ عام يشمل اليهود و النصارى و المشركين جميعا -:
﴿لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين و من يفعل ذلك فليس من
الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة و يحذركم الله نفسه﴾: آل عمران: 28 و
الآية صريحة في ولاية المودة و المحبة دون الحلف و العهد، و قد كان بين
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و بين اليهود، و كذا بينه و بين المشركين
يومئذ أعني زمان نزول سورة آل عمران معاهدات و موادعات.
وبالجملة الولاية التي تقتضي بحسب الاعتبار لحوق قوم بقوم هي ولاية المحبة و
المودة دون الحلف و النصرة و هو ظاهر، و لو كان المراد بقوله: ﴿ومن يتولهم
منكم فإنه منهم﴾ أن من حالفهم على النصرة بعد هذا النهي فإنه لمعصيته
النهي ظالم ملحق بأولئك الظالمين في الظلم كان معنى - على ابتذاله - بعيدا
من اللفظ يحتاج إلى قيود زائدة في الكلام.
ومن دأب
القرآن في كل ما ينهى عن أمر كان جائزا سائغا قبل النهي أن يشير إليه رعاية
لجانب الحكم المشروع سابقا، و احتراما للسيرة النبوية الجارية قبله كقوله:
﴿إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾: التوبة: 28 و
قوله: فالآن باشروهن و ابتغوا ما كتب الله لكم و كلوا و اشربوا﴾ الآية:
البقرة: 178 و قوله: ﴿لا يحل لك النساء من بعد و لا أن تبدل بهن من أزواج﴾:
الأحزاب: 52 إلى غير ذلك.
فقد تبين أن لغة الآية في مفرداتها و سياقها لا تتبرأ من كون المراد
بالولاية ولاية المحبة و المودة، بل إن تبرأت فإنما تتبرأ من غيرها.
وأما قولهم: إن المراد بالذين في قلوبهم مرض المنافقون فسيجيء أن السياق لا
يساعده فالمراد بقوله: ﴿لا تتخذوا اليهود و النصارى أولياء﴾ النهي عن
موادتهم الموجب لتجاذب الأرواح و النفوس الذي يفضي إلى التأثير و التأثر
الأخلاقيين فإن ذلك يقلب حال مجتمعهم من السيرة الدينية المبنية على سعادة
اتباع الحق إلى سيرة الكفر المبنية على اتباع الهوى و عبادة الشيطان و
الخروج عن صراط الحياة الفطرية.
وإنما عبر عنهم باليهود و النصارى، و لم يعبر بأهل الكتاب كما عبر بمثله في
الآية الآتية لما في التعبير بأهل الكتاب من الإشعار بقربهم من المسلمين
نوعا من القرب يوجب إثارة المحبة فلا يناسب النهي عن اتخاذهم أولياء، و أما
ما في الآية الآتية: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم
هزوا و لعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم و الكفار أولياء﴾ من وصفهم
بإيتائهم الكتاب مع النهي عن اتخاذهم أولياء فتوصيفهم باتخاذ دين الله هزوا
و لعبا يقلب حال ذلك الوصف - أعني كونهم ذوي كتاب - من المدح إلى الذم فإن
من أوتي الكتاب الداعي إلى الحق و المبين له ثم جعل يستهزء بدين الحق و
يلعب به أحق و أحرى به أن لا يتخذ وليا، و تجتنب معاشرته و مخالطته و
موادته.
وأما قوله تعالى: ﴿بعضهم أولياء بعض﴾ فالمراد بالولاية - كما تقدم - ولاية
المحبة المستلزمة لتقارب نفوسهم، و تجاذب أرواحهم المستوجب لاجتماع آرائهم
على اتباع الهوى، و الاستكبار عن الحق و قبوله، و اتحادهم على إطفاء نور
الله سبحانه، و تناصرهم على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و المسلمين
كأنهم نفس واحدة ذات ملة واحدة، و ليسوا على وحدة من الملية لكن يبعث القوم
على الاتفاق، و يجعلهم يدا واحدة على المسلمين أن الإسلام يدعوهم إلى
الحق، و يخالف أعز المقاصد عندهم و هو اتباع الهوى، و الاسترسال في مشتهيات
النفس و ملاذ الدنيا.
فهذا هو الذي جعل الطائفتين: اليهود و النصارى - على ما بينهما من الشقاق و
العداوة الشديدة - مجتمعا واحدا يقترب بعضه من بعض، و يرتد بعضه إلى بعض،
يتولى اليهود النصارى و بالعكس، و يتولى بعض اليهود بعضا، و بعض النصارى
بعضا، و هذا معنى إبهام الجملة: ﴿بعضهم أولياء بعض﴾ في مفرداتها، و الجملة
في موضع التعليل لقوله: ﴿لا تتخذوا اليهود و النصارى أولياء﴾ و المعنى لا
تتخذوهم أولياء لأنهم على تفرقهم و شقاقهم فيما بينهم يد واحدة عليكم لا
نفع لكم في الاقتراب منهم بالمودة و المحبة.
وربما أمكن أن يستفاد من قوله: ﴿بعضهم أولياء بعض﴾ معنى آخر، و هو أن لا
تتخذوهم أولياء لأنكم إنما تتخذونهم أولياء لتنتصروا ببعضهم الذي هم
أولياؤكم على البعض الآخر، و لا ينفعكم ذلك فإن بعضهم أولياء بعض فليسوا
ينصرونكم على أنفسهم.
قوله تعالى: ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين﴾
التولي اتخاذ الولي، و ﴿من﴾ تبعيضية و المعنى أن من يتخذهم منكم أولياء
فإنه بعضهم، و هذا إلحاق تنزيلي يصير به بعض المؤمنين بعضا من اليهود و
النصارى، و يئول الأمر إلى أن الإيمان حقيقة ذات مراتب مختلفة من حيث الشوب
و الخلوص، و الكدورة و الصفاء كما يستفاد ذلك من
الآيات القرآنية قال تعالى: ﴿وما يؤمن أكثرهم بالله إلا و هم مشركون﴾: يوسف: 160
و هذا الشوب و الكدر هو الذي يعبر تعالى عنه بمرض القلوب فيما سيأتي من
قوله: ﴿فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم﴾.
فهؤلاء الموالون لأولئك أقوام عدهم الله تعالى من اليهود و النصارى و إن
كانوا من المؤمنين ظاهرا، و أقل ما في ذلك أنهم غير سالكين سبيل الهداية
الذي هو الإيمان بل سالكو سبيل اتخذه أولئك سبيلا يسوقه إلى حيث يسوقهم و
ينتهي به إلى حيث ينتهي بهم.
ولذلك علل الله سبحانه لحوقه بهم بقوله: ﴿إن الله لا يهدي القوم الظالمين﴾
فالكلام في معنى: أن هذا الذي يتولاهم منكم هو منهم غير سالك سبيلكم لأن
سبيل الإيمان هو سبيل الهداية الإلهية، و هذا المتولي لهم ظالم مثلهم، و
الله لا يهدي القوم الظالمين.
والآية - كما ترى - تشتمل على أصل التنزيل أعني تنزيل من تولاهم من
المؤمنين منزلتهم من غير تعرض لشيء من آثاره الفرعية، و اللفظ و إن لم
يتقيد بقيد لكنه لما كان من قبيل بيان الملاك - نظير قوله: ﴿وأن تصوموا خير
لكم﴾: البقرة: 148 و قوله: ﴿إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر و لذكر
الله أكبر﴾: العنكبوت: 45 إلى غير ذلك - لم يكن إلا مهملا يحتاج التمسك به
في إثبات حكم فرعي إلى بيان السنة، و المرجع في البحث عن ذلك فن الفقه.
قوله تعالى: ﴿فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم﴾ تفريع على قوله في
الآية السابقة: ﴿إن الله لا يهدي القوم الظالمين﴾ فمن عدم شمول الهداية
الإلهية لحالهم - و هو الضلال - مسارعتهم فيهم و اعتذارهم في ذلك بما لا
يسمع من القول، و قد قال تعالى: ﴿يسارعون فيهم﴾ و لم يقل يسارعون إليهم،
فهم منهم و حالون في الضلال محلهم، فهؤلاء يسارعون فيهم لا لخشية إصابة
دائرة عليهم فليسوا يخافون ذلك، و إنما هي معذرة يختلقونها لأنفسهم لدفع ما
يتوجه إليهم من ناحية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و المؤمنين من
اللوم و التوبيخ بل إنما يحملهم على تلك المسارعة توليهم أولئك اليهود و
النصارى.
ولما كان من شأن كل ظلم و باطل أن يزهق يوما و يظهر للملأ فضيحته، و ينقطع
رجاء من توسل إلى أغراض باطلة بوسائل صورتها صورة الحق كما قال تعالى: ﴿إن
الله لا يهدي القوم الظالمين﴾ كان من المرجو قطعا أن يأتي الله بفتح أو أمر
من عنده فيندموا على فعالهم، و يظهر للمؤمنين كذبهم فيما كانوا يظهرونه.
وبهذا البيان يظهر وجه تفرع قوله: ﴿فترى الذين﴾ إلخ على قوله: ﴿إن الله لا
يهدي القوم الظالمين﴾ و قد تقدم كلام في معنى عدم اهتداء الظالمين في
ظلمهم.
فهؤلاء القوم منافقون من جهة إظهارهم للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و
المؤمنين ما ليس في قلوبهم حيث يعنونون مسارعتهم في اليهود و النصارى
بعنوان الخشية من إصابة الدائرة، و عنوانه الحقيقي الموافق لما في قلوبهم
هو تولي أعداء الله فهذا هو وجه نفاقهم، و أما كونهم منافقين بمعنى
الكافرين المظهرين للإيمان فسياق
الآيات لا يوافقه.
وقد ذكر جماعة من المفسرين أنهم المنافقون كعبد الله بن أبي و أصحابه على
ما يؤيده أسباب النزول الواردة فإن هؤلاء المنافقين كانوا يشاركون المؤمنين
في مجتمعهم و يجاملونهم من جانب، و من الجانب الآخر كانوا يتولون اليهود و
النصارى بالحلف و العهد على النصرة استدرارا للفئتين، و أخذا بالاحتياط في
رعاية مصالح أنفسهم ليغتبطوا على أي حال، و يكونوا في مأمن من إصابة
الدائرة على أي واحدة من الفئتين المتخاصمتين دارت.
وما ذكروه لا يلائم سياق
الآيات فإنها تتضمن رجاء أن يندموا بفتح أو أمر من عنده، و الفتح فتح مكة أو فتح
قلاع اليهود و بلاد النصارى أو نحو ذلك على ما قالوا و لا وجه لندمهم على
هذا التقدير فإنهم احتاطوا في أمرهم بحفظ الجانبين، و لا ندامة في
الاحتياط، و إنما كان يصح الندم لو انقطعوا من المؤمنين بالمرة و اتصلوا
باليهود و النصارى ثم دارت الدائرة عليهم، و كذا ما ذكره الله تعالى من حبط
أعمالهم و صيرورتهم خاسرين بقوله: ﴿حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين﴾ لا يلائم
كونهم هم المنافقين الآخذين بالحائطة لمنافعهم و مطالبهم إذ لا معنى
لخسران من احتاط بحائطة اتقاء من مكروه يخافه على نفسه ثم صادف إن لم يقع
ما كان يخاف وقوعه، و الاحتياط في العمل من الطرق العقلائية التي لا تستتبع
لوما و لا ذما.
إلا أن يقال: إن الذم إنما لحقهم لأنهم عصوا النهي الإلهي و لم تطمئن
قلوبهم بما وعده الله من الفتح، و هذا و إن كان لا بأس به في نفسه لكن لا
دليل عليه من جهة لفظ الآية.
قوله تعالى: ﴿فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما
أسروا في أنفسهم نادمين﴾ لفظة ﴿عسى﴾ و إن كان في كلامه تعالى للترجي كسائر
الكلام - على ما قدمنا أنه للترجي العائد إلى السامع أو إلى المقام - لكن
القرينة قائمة على أنه مما سيقع قطعا فإن الكلام مسوق لتقرير ما ذكره
بقوله: ﴿إن الله لا يهدي القوم الظالمين﴾ و تثبيت صدقه، فما يشتمل عليه
واقع لا محالة.
والذي ذكره الله تعالى من الفتح - و قد ردد بينه و بين أمر من عنده غير بين
المصداق بل الترديد بينه و بين أمر مجهول لنا - لعله يؤيد كون اللام في
﴿الفتح﴾ للجنس لا للعهد حتى يكون المراد به فتح مكة المعهود بوعد وقوعه في
مثل قوله تعالى: ﴿إن الذي فرض عليك القرءان لرادك إلى معاد﴾: القصص: 85 و
قوله: ﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله﴾: الفتح: 27 و غير ذلك.
والفتح الواقع في
القرآن و إن كان المراد به في أكثر موارده هو فتح مكة لكن بعض الموارد لا يقبل
الحمل على ذلك كقوله تعالى: ﴿ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صاد