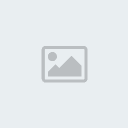أو أن المراد باليوم هو يوم عرفة من حجة الوداع كما ذكره كثير من المفسرين
وبه ورد بعض الروايات؟ فما المراد من يأس الذين كفروا يومئذ من دين
المسلمين فإن كان المراد باليأس من الدين يأس مشركي قريش من الظهور على دين
المسلمين فقد كان ذلك يوم الفتح عام ثمانية لا يوم عرفة من السنة العاشرة،
وإن كان المراد يأس مشركي العرب من ذلك فقد كان ذلك عند نزول البراءة وهو
في السنة التاسعة من الهجرة، وإن كان المراد به يأس جميع الكفار الشامل
لليهود والنصارى والمجوس وغيرهم - وذلك الذي يقتضيه إطلاق قوله: ﴿الذين
كفروا﴾ - فهؤلاء لم يكونوا آيسين من الظهور على المسلمين بعد، ولما يظهر
للإسلام قوة وشوكة وغلبة في خارج جزيرة العرب اليوم.
ومن جهة أخرى يجب أن نتأمل فيما لهذا اليوم - وهو يوم عرفة تاسع ذي الحجة
سنة عشر من الهجرة - من الشأن الذي يناسب قوله: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم نعمتي﴾ في الآية.
فربما أمكن أن يقال: إن المراد به إكمال أمر الحج بحضور النبي (صلى الله
عليه وآله وسلم) بنفسه فيه، وتعليمه الناس تعليما عمليا مشفوعا بالقول.
لكن فيه أن مجرد تعليمه الناس مناسك حجهم - وقد أمرهم بحج التمتع ولم يلبث
دون أن صار مهجورا، وقد تقدمه تشريع أركان الدين من صلاة وصوم وحج وزكاة
وجهاد وغير ذلك - لا يصح أن يسمى إكمالا للدين، وكيف يصح أن يسمى تعليم شيء
من واجبات الدين إكمالا لذلك الواجب فضلا عن أن يسمى تعليم واجب من واجبات
الدين لمجموع الدين.
على أن هذا الاحتمال يوجب انقطاع رابطة الفقرة الأولى أعني قوله: ﴿اليوم
يئس الذين كفروا من دينكم﴾ بهذه الفقرة أعني قوله: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾
وأي ربط ليأس الكفار عن الدين بتعليم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
حج التمتع للناس.
وربما أمكن أن يقال إن المراد به إكمال الدين بنزول بقايا الحلال والحرام
في هذا اليوم في سورة المائدة، فلا حلال بعده ولا حرام، وبإكمال الدين
استولى اليأس على قلوب الكفار، ولاحت آثاره على وجوههم.
لكن يجب أن نتبصر في تمييز هؤلاء الكفار الذين عبر عنهم في الآية بقوله:
﴿الذين كفروا﴾ على هذا التقدير وأنهم من هم؟ فإن أريد بهم كفار العرب فقد
كان الإسلام عمهم يومئذ ولم يكن فيهم من يتظاهر بغير الإسلام وهو الإسلام
حقيقة، فمن هم الكفار الآيسون؟.
وإن أريد بهم الكفار من غيرهم كسائر العرب من الأمم والأجيال فقد عرفت آنفا أنهم لم يكونوا آيسين يومئذ من الظهور على المسلمين.
ثم نتبصر في أمر انسداد باب التشريع بنزول سورة
المائدة وانقضاء يوم عرفة فقد وردت روايات كثيرة لا يستهان بها عددا بنزول أحكام
وفرائض بعد اليوم كما في آية الصيف وآيات الربا، حتى أنه روي عن عمر أنه
قال في خطبة خطبها: من آخر
القرآن نزولا آية الربا، وإنه مات رسول الله ولم يبينه لنا، فدعوا ما يريبكم إلى
ما لا يريبكم، الحديث وروى البخاري في الصحيح، عن ابن عباس قال: آخر آية
نزلت على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) آية الربا، إلى غير ذلك من
الروايات.
وليس للباحث أن يضعف الروايات فيقدم الآية عليها، لأن الآية ليست بصريحة
ولا ظاهرة في كون المراد باليوم فيها هذا اليوم بعينه وإنما هو وجه محتمل
يتوقف في تعينه على انتفاء كل احتمال ينافيه، وهذه الأخبار لا تقصر عن
الاحتمال المجرد عن السند.
أو يقال: إن المراد بإكمال الدين خلوص البيت الحرام لهم، وإجلاء المشركين عنه حتى حجه المسلمون وهم لا يخالطهم المشركون.
وفيه: أنه قد كان صفا الأمر للمسلمين فيما ذكر قبل ذلك بسنة، فما معنى
تقييده باليوم في قوله: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾؟ على أنه لو سلم كون هذا
الخلوص إتماما للنعمة لم يسلم كونه إكمالا للدين، وأي معنى لتسمية خلوص
البيت إكمالا للدين، وليس الدين إلا مجموعة من عقائد وأحكام، وليس إكماله
إلا أن يضاف إلى عدد أجزائها وأبعاضها عدد؟ وأما صفاء الجو لإجرائها،
وارتفاع الموانع والمزاحمات عن العمل بها فليس يسمى إكمالا للدين البتة.
على أن إشكال يأس الكفار عن الدين على حاله.
ويمكن أن يقال: إن المراد من إكمال الدين بيان هذه المحرمات بيانا تفصيليا
ليأخذ به المسلمون، ويجتنبوها ولا يخشوا الكفار في ذلك لأنهم قد يئسوا من
دينهم بإعزاز الله المسلمين، وإظهار دينهم وتغليبهم على الكفار.
توضيح ذلك أن حكمة الاكتفاء في صدر الإسلام بذكر المحرمات الأربعة أعني
الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الواقعة في بعض السور
المكية وترك تفصيل ما يندرج فيها مما كرهه الإسلام للمسلمين من سائر ما ذكر
في هذه الآية إلى ما بعد فتح مكة إنما هي التدرج في تحريم هذه الخبائث
والتشديد فيها كما كان التدريج في تحريم الخمر لئلا ينفر العرب من الإسلام،
ولا يروا فيه حرجا يرجون به رجوع من آمن من فقرائهم وهم أكثر السابقين
الأولين.
جاء هذا التفصيل للمحرمات بعد قوة الإسلام، وتوسعة الله على أهله وإعزازهم
وبعد أن يئس المشركون بذلك من نفور أهله منه، وزال طمعهم في الظهور عليهم،
وإزالة دينهم بالقوة القاهرة، فكان المؤمنون أجدر بهم أن لا يبالوهم
بالمداراة، ولا يخافوهم على دينهم وعلى أنفسهم.
فالمراد باليوم يوم عرفة من عام حجة الوداع، وهو اليوم الذي نزلت فيه هذه
الآية المبينة لما بقي من الأحكام التي أبطل بها الإسلام بقايا مهانة
الجاهلية وخبائثها وأوهامها، والمبشرة بظهور المسلمين على المشركين ظهورا
تاما لا مطمع لهم في زواله، ولا حاجة معه إلى شيء من مداراتهم أو الخوف من
عاقبة أمرهم.
فالله سبحانه يخبرهم في الآية أن الكفار أنفسهم قد يئسوا من زوال دينهم
وأنه ينبغي لهم - وقد بدلهم بضعفهم قوة، وبخوفهم أمنا، وبفقرهم غنى - أن لا
يخشوا غيره تعالى، وينتهوا عن تفاصيل ما نهى الله عنه في الآية ففيها كمال
دينهم.
كذا ذكره بعضهم بتلخيص ما في النقل.
وفيه: أن هذا القائل أراد الجمع بين عدة من الاحتمالات المذكورة ليدفع بكل
احتمال ما يتوجه إلى الاحتمال الآخر من الإشكال فتورط بين المحاذير برمتها
وأفسد لفظ الآية ومعناها جميعا.
فذهل عن أن المراد باليأس إن كان هو اليأس المستند إلى ظهور الإسلام وقوته
وهو ما كان بفتح مكة أو بنزول آيات البراءة لم يصح أن يقال يوم عرفة من
السنة العاشرة: ﴿اليوم يئس الذين كفروا من دينكم﴾ وقد كانوا يئسوا قبل ذلك
بسنة أو سنتين، وإنما اللفظ الوافي له أن يقال: قد يئسوا كما عبر به القائل
نفسه في كلامه في توضيح المعنى أو يقال: إنهم آيسون.
وذهل عن أن هذا التدرج الذي ذكره في محرمات الطعام، وقاس تحريمها بتحريم
الخمر إن أريد به التدرج من حيث تحريم بعض الأفراد بعد بعض فقد عرفت أن
الآية لا تشتمل على أزيد مما تشتمل عليه آيات التحريم السابقة نزولا على
هذه الآية أعني آيات البقرة والأنعام والنحل، وأن المنخنقة والموقوذة إلخ
من أفراد ما ذكر فيها.
وإن أريد به التدرج من حيث البيان الإجمالي والتفصيلي خوفا من امتناع الناس
من القبول ففي غير محله، فإن ما ذكر بالتصريح في السور السابقة على
المائدة أعني الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به أغلب مصداقا، وأكثر
ابتلاء، وأوقع في قلوب الناس من أمثال المنخنقة والموقوذة وغيرها، وهي أمور
نادرة التحقق وشاذة الوجود، فما بال تلك الأربعة وهي أهم وأوقع وأكثر يصرح
بتحريمها من غير خوف من ذلك ثم يتقي من ذكرها ما لا يعبأ بأمره بالإضافة
إليها فيتدرج في بيان حرمتها، ويخاف من التصريح بها.
على أن ذلك لو سلم لم يكن إكمالا للدين، وهل يصح أن يسمى تشريع الأحكام
دينا وإبلاغها وبيانها إكمالا للدين؟ ولو سلم فإنما ذلك إكمال لبعض الدين
وإتمام لبعض النعمة لا للكل والجميع، وقد قال تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم
دينكم وأتممت عليكم نعمتي﴾ فأطلق القول من غير تقييد.
على أنه تعالى قد بين أحكاما كثيرة في أيام كثيرة، فما بال هذا الحكم في
هذا اليوم خص بالمزية فسماه الله أو سمى بيانه تفصيلا بإشمال الدين وإتمام
النعمة.
أو أن المراد بإكمال الدين إكماله بسد باب التشريع بعد هذه الآية المبينة
لتفصيل محرمات الطعام، فما شأن الأحكام النازلة ما بين نزول
المائدة ورحلة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ بل ما شأن سائر الأحكام النازلة بعد هذه الآية في سورة المائدة؟ تأمل فيه.
وبعد ذلك كله ما معنى قوله تعالى: ﴿ورضيت لكم الإسلام دينا﴾ - وتقديره:
اليوم رضيت إلخ - لو كان المراد بالكلام الامتنان بما ذكر في الآية من
المحرمات يوم عرفة من السنة العاشرة؟ وما وجه اختصاص هذا اليوم بأن الله
سبحانه رضي فيه الإسلام دينا، ولا أمر يختص به اليوم مما يناسب هذا الرضا؟.
وبعد ذلك كله يرد على هذا الوجه أكثر الإشكالات الواردة على الوجوه السابقة أو ما يقرب منها مما تقدم بيانه ولا نطيل بالإعادة.
أو أن المراد باليوم واحد من الأيام التي بين عرفة وبين ورود النبي (صلى
الله عليه وآله وسلم) المدينة على بعض الوجوه المذكورة في معنى يأس الكفار
ومعنى إكمال الدين.
وفيه من الإشكال ما يرد على غيره على التفصيل المتقدم.
فهذا شطر من البحث عن الآية بحسب السير فيما قيل أو يمكن أن يقال في توجيه
معناها، ولنبحث عنها من طريق آخر يناسب طريق البحث الخاص بهذا الكتاب.
قوله: ﴿اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم﴾ - واليأس يقابل الرجاء،
والدين إنما نزل من عند الله تدريجا - يدل على أن الكفار قد كان لهم مطمع
في دين المسلمين وهو الإسلام، وكانوا يرجون زواله بنحو منذ عهد وزمان، وإن
أمرهم ذلك كان يهدد الإسلام حينا بعد حين، وكان الدين منهم على خطر يوما
بعد يوم، وإن ذلك كان من حقه أن يحذر منه ويخشاه المؤمنون.
فقوله: ﴿فلا تخشوهم﴾، تأمين منه سبحانه للمؤمنين مما كانوا منه على خطر،
ومن تسر به على خشية، قال تعالى: ﴿ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم﴾: آل
عمران: 69، وقال تعالى: ﴿ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم
كفارا حسدا من عند أنفسهم ومن بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى
يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير﴾: البقرة: 190.
والكفار لم يكونوا يتربصون الدوائر بالمسلمين إلا لدينهم، ولم يكن يضيق
صدورهم وينصدع قلوبهم إلا من جهة أن الدين كان يذهب بسؤددهم وشرفهم
واسترسالهم في اقتراف كل ما تهواه طباعهم، وتألفه وتعتاد به نفوسهم، ويختم
على تمتعهم بكل ما يشتهون بلا قيد وشرط.
فقد كان الدين هو المبغوض عندهم دون أهل الدين إلا من جهة دينهم الحق فلم
يكن في قصدهم إبادة المسلمين وإفناء جمعهم بل إطفاء نور الله وتحكيم أركان
الشرك المتزلزلة المضطربة به، ورد المؤمنين كفارا كما مر في قوله: ﴿لو
يردونكم من بعد إيمانكم كفارا﴾ الآية قال تعالى: ﴿يريدون ليطفئوا نور الله
بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون﴾: الصف: 9.
وقال تعالى: ﴿فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون﴾: المؤمن: 14.
ولذلك لم يكن لهم هم إلا أن يقطعوا هذه الشجرة الطيبة من أصلها، ويهدموا
هذا البنيان الرفيع من أسه بتفتين المؤمنين وتسرية النفاق في جماعتهم وبث
الشبه والخرافات بينهم لإفساد دينهم.
وقد كانوا يأخذون بادىء الأمر يفترون عزيمة النبي (صلى الله عليه وآله
وسلم) ويستمحقون همته في الدعوة الدينية بالمال والجاه، كما يشير إليه قوله
تعالى: ﴿وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء
يراد﴾: ص: 6 أو بمخالطة أو مداهنة، كما يشير إليه قوله: ﴿ودوا لو تدهن
فيدهنون﴾: القلم: 9، وقوله: ﴿ولو لا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا
قليلا﴾: إسراء: 74، وقوله: ﴿قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا
أنتم عابدون ما أعبد﴾: الكافرون: 3 على ما ورد في أسباب النزول.
وكان آخر ما يرجونه في زوال الدين، وموت الدعوة المحقة، أنه سيموت بموت هذا
القائم بأمره ولا عقب له، فإنهم كانوا يرون أنه ملك في صورة النبوة،
وسلطنة في لباس الدعوة والرسالة، فلو مات أو قتل لانقطع أثره ومات ذكره
وذكر دينه على ما هو المشهود عادة من حال السلاطين والجبابرة أنهم مهما بلغ
أمرهم من التعالي والتجبر وركوب رقاب الناس فإن ذكرهم يموت بموتهم، وسننهم
وقوانينهم الحاكمة بين الناس وعليهم تدفن معهم في قبورهم، يشير إلى رجائهم
هذا قوله تعالى: ﴿إن شانئك هو الأبتر: ﴾ الكوثر: 3 على ما ورد في أسباب
النزول.
فقد كان هذه وأمثالها أماني تمكن الرجاء من نفوسهم، وتطمعهم في إطفاء نور
الدين، وتزين لأوهامهم أن هذه الدعوة الطاهرة ليست إلا أحدوثة ستكذبه
المقادير ويقضي عليها ويعفو أثرها مرور الأيام والليالي، لكن ظهور الإسلام
تدريجا على كل ما نازله من دين وأهله، وانتشار صيته، واعتلاء كلمته بالشوكة
والقوة قضى على هذه الأماني فيئسوا من إفساد عزيمة النبي (صلى الله عليه
وآله وسلم)، وإيقاف همته عند بعض ما كان يريده، وتطميعه بمال أو جاه.
قوة الإسلام وشوكته أيأستهم من جميع تلك الأسباب أسباب: - الرجاء - إلا
واحدا، وهو أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) مقطوع العقب لا ولد له تخلفه في
أمره، ويقوم على ما قام عليه من الدعوة الدينية فسيموت دينه بموته، وذلك أن
من البديهي أن كمال الدين من جهة أحكامه ومعارفه - وإن بلغ ما بلغ - لا
يقوى بنفسه على حفظ نفسه، وأن سنة من السنن المحدثة والأديان المتبعة لا
تبقى على نضارتها وصفائها لا بنفسها ولا بانتشار صيتها ولا بكثرة المنتحلين
بها، كما أنها لا تنمحي ولا تنطمس بقهر أو جبر أو تهديد أو فتنة أو عذاب
أو غير ذلك إلا بموت حملتها وحفظتها والقائمين بتدبير أمرها.
ومن جميع ما تقدم يظهر أن تمام يأس الكفار إنما كان يتحقق عند الاعتبار
الصحيح بأن ينصب الله لهذا الدين من يقوم مقام النبي (صلى الله عليه وآله
وسلم) في حفظه وتدبير أمره، وإرشاد الأمة القائمة به فيتعقب ذلك يأس الذين
كفروا من دين المسلمين لما شاهدوا خروج الدين عن مرحلة القيام بالحامل
الشخصي إلى مرحلة القيام بالحامل النوعي، ويكون ذلك إكمالا للدين بتحويله
من صفة الحدوث إلى صفة البقاء، وإتماما لهذه النعمة، وليس يبعد أن يكون
قوله تعالى: ﴿ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا
من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره
إن الله على كل شيء قدير﴾: البقرة: 190 باشتماله على قوله: ﴿حتى يأتي﴾،
إشارة إلى هذا المعنى.
وهذا يؤيد ما ورد من الروايات أن الآية نزلت يوم غدير خم، وهو اليوم الثامن
عشر من ذي الحجة سنة عشر من الهجرة في أمر ولاية علي (عليه السلام)، وعلى
هذا فيرتبط الفقرتان أوضح الارتباط، ولا يرد عليه شيء من الإشكالات
المتقدمة.
ثم إنك بعد ما عرفت معنى اليأس في الآية تعرف أن اليوم: ﴿في قوله اليوم يئس
الذين كفروا من دينكم﴾ ظرف متعلق بقوله: ﴿يئس﴾ وإن التقديم للدلالة على
تفخيم أمر اليوم، وتعظيم شأنه، لما فيه من خروج الدين من مرحلة القيام
بالقيم الشخصي إلى مرحلة القيام بالقيم النوعي، ومن صفة الظهور والحدوث إلى
صفة البقاء والدوام.
ولا يقاس الآية بما سيأتي من قوله: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات﴾ الآية فإن سياق
الآيتين مختلف فقوله: ﴿اليوم يئس﴾، في سياق الاعتراض، وقوله: ﴿اليوم أحل﴾،
في سياق الاستيناف، والحكمان مختلفان: فحكم الآية الأولى تكويني مشتمل على
البشرى من وجه والتحذير من وجه آخر، وحكم الثانية تشريعي منبىء عن
الامتنان.
فقوله: ﴿اليوم يئس﴾، يدل على تعظيم أمر اليوم لاشتماله على خير عظيم الجدوى
وهو يأس الذين كفروا من دين المؤمنين، والمراد بالذين كفروا - كما تقدمت
الإشارة إليه - مطلق الكفار من الوثنيين واليهود والنصارى وغيرهم لمكان
الإطلاق.
وأما قوله: ﴿فلا تخشوهم واخشون﴾ فالنهي إرشادي لا مولوي، معناه أن لا موجب
للخشية بعد يأس الذين كنتم في معرض الخطر من قبلهم - ومن المعلوم أن
الإنسان لا يهم بأمر بعد تمام اليأس من الحصول عليه ولا يسعى إلى ما يعلم
ضلال سعيه فيه - فأنتم في أمن من ناحية الكفار، ولا ينبغي لكم مع ذلك
الخشية منهم على دينكم فلا تخشوهم واخشوني.
ومن هنا يظهر أن المراد بقوله: ﴿واخشون﴾ بمقتضى السياق أن اخشوني فيما كان
عليكم أن تخشوهم فيه لو لا يأسهم وهو الدين ونزعه من أيديكم، وهذا نوع
تهديد للمسلمين كما هو ظاهر، ولهذا لم نحمل الآية على الامتنان.
ويؤيد ما ذكرنا أن الخشية من الله سبحانه واجب على أي تقدير من غير أن
يتعلق بوضع دون وضع، وشرط دون شرط، فلا وجه للإضراب من قوله: ﴿فلا تخشوهم﴾
إلى قوله: ﴿واخشون﴾ لو لا أنها خشية خاصة في مورد خاص.
ولا تقاس الآية بقوله تعالى: ﴿فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين﴾: آل
عمران: 157 لأن الأمر بالخوف من الله في تلك الآية مشروط بالإيمان، والخطاب
مولوي، ومفاده أنه لا يجوز للمؤمنين أن يخافوا الكفار على أنفسهم بل يجب
أن يخافوا الله سبحانه وحده.
فالآية تنهاهم عما ليس لهم بحق وهو الخوف منهم على أنفسهم سواء أمروا
بالخوف من الله أم لا، ولذلك يعلل ثانيا الأمر بالخوف من الله بقيد مشعر
بالتعليل، وهو قوله: ﴿إن كنتم مؤمنين﴾ وهذا بخلاف قوله: ﴿فلا تخشوهم
واخشون﴾ فإن خشيتهم هذه خشية منهم على دينهم، وليست بمبغوضة لله سبحانه
لرجوعها إلى ابتغاء مرضاته بالحقيقة، بل إنما النهي عنها لكون السبب الداعي
إليها - وهو عدم يأس الكفار منه - قد ارتفع وسقط أثره فالنهي عنه إرشادي،
فكذا الأمر بخشية الله نفسه، ومفاد الكلام أن من الواجب أن تخشوا في أمر
الدين، لكن سبب الخشية كان إلى اليوم مع الكفار فكنتم تخشونهم لرجائهم في
دينكم وقد يئسوا اليوم وانتقل السبب إلى ما عند الله فاخشوه وحده فافهم
ذلك.
فالآية لمكان قوله: ﴿فلا تخشوهم واخشون﴾ لا تخلو عن تهديد وتحذير، لأن فيه
أمرا بخشية خاصة دون الخشية العامة التي تجب على المؤمن على كل تقدير وفي
جميع الأحوال فلننظر في خصوصية هذه الخشية، وأنه ما هو السبب الموجب
لوجوبها والأمر بها؟.
لا إشكال في أن الفقرتين أعني قوله: ﴿اليوم يئس﴾، وقوله: ﴿اليوم أكملت لكم
دينكم وأتممت عليكم نعمتي﴾، في الآية مرتبطان مسوقتان لغرض واحد، وقد تقدم
بيانه فالدين الذي أكمله الله اليوم، والنعمة التي أتمها اليوم - وهما أمر
واحد بحسب الحقيقة - هو الذي كان يطمع فيه الكفار ويخشاهم فيه المؤمنون
فأيأسهم الله منه وأكمله وأتمه ونهاهم عن أن يخشوهم فيه، فالذي أمرهم
بالخشية من نفسه فيه هو ذاك بعينه وهو أن ينزع الله الدين من أيديهم،
ويسلبهم هذه النعمة الموهوبة.
وقد بين الله سبحانه أن لا سبب لسلب النعمة إلا الكفر بها، وهدد الكفور أشد
التهديد، قال تعالى: ﴿ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى
يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم﴾: الأنفال: 53 وقال تعالى: ﴿ومن يبدل
نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب﴾: البقرة: 211 وضرب مثلا
كليا لنعمه وما يئول إليه أمر الكفر بها فقال و﴿ضرب الله مثلا قرية كانت
ءامنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله
لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون﴾: النحل: 121.
فالآية أعني قوله: ﴿اليوم يئس - إلى قوله - دينا﴾ تؤذن بأن دين المسلمين في
أمن من جهة الكفار، مصون من الخطر المتوجه من قبلهم، وأنه لا يتسرب إليه
شيء من طوارق الفساد والهلاك إلا من قبل المسلمين أنفسهم، وإن ذلك إنما
يكون بكفرهم بهذه النعمة التامة، ورفضهم هذا الدين الكامل المرضي، ويومئذ
يسلبهم الله نعمته ويغيرها إلى النقمة، ويذيقهم لباس الجوع والخوف، وقد
فعلوا وفعل.
ومن أراد الوقوف على مبلغ صدق هذه الآية في ملحمتها المستفادة من قوله:
﴿فلا تخشوهم واخشون﴾ فعليه أن يتأمل فيما استقر عليه حال العالم الإسلامي
اليوم ثم يرجع القهقرى بتحليل الحوادث التاريخية حتى يحصل على أصول القضايا
وأعراقها.
ولآيات الولاية في
القرآن ارتباط تام بما في هذه الآية من التحذير والإيعاد ولم يحذر الله العباد
عن نفسه في كتابه إلا في باب الولاية، فقال فيها مرة بعد مرة: ﴿ويحذركم
الله نفسه﴾: آل عمران: 0382 وتعقيب هذا البحث أزيد من هذا خروج عن طور
الكتاب.
قوله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام
دينا﴾ الإكمال والإتمام متقاربا المعنى، قال الراغب: كمال الشيء حصول ما هو
الغرض منه.
وقال: تمام الشيء انتهاؤه إلى حد لا يحتاج إلى شيء خارج عنه.
والناقص ما يحتاج إلى شيء خارج عنه.
ولك أن تحصل على تشخيص معنى اللفظين من طريق آخر، وهو أن آثار الأشياء التي لها آثار على ضربين.
فضرب منها ما يترتب على الشيء عند وجود جميع أجزائه - إن كان له أجزاء -
بحيث لو فقد شيئا من أجزائه أو شرائطه لم يترتب عليه ذلك الأمر كالصوم فإنه
يفسد إذا أخل بالإمساك في بعض النهار، ويسمى كون الشيء على هذا الوصف
بالتمام، قال تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾: البقرة: 178 وقال: ﴿وتمت
كلمة ربك صدقا وعدلا﴾: الأنعام: 151.
وضرب آخر: الأثر الذي يترتب على الشيء من غير توقف على حصول جميع أجزائه،
بل أثر المجموع كمجموع آثار الأجزاء، فكلما وجد جزء ترتب عليه من الأثر ما
هو بحسبه، ولو وجد الجميع ترتب عليه كل الأثر المطلوب منه، قال تعالى: ﴿فمن
لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة﴾:
البقرة: 169 وقال: ﴿ولتكملوا العدة﴾: البقرة: 158 فإن هذا العدد يترتب
الأثر على بعضه كما يترتب على كله، ويقال: تم لفلان أمره وكمل عقله: ولا
يقال تم عقله وكمل أمره.
وأما الفرق بين الإكمال والتكميل، وكذا بين الإتمام والتتميم فإنما هو
الفرق بين بابي الإفعال والتفعيل، وهو أن الإفعال بحسب الأصل يدل على
الدفعة والتفعيل على التدريج، وإن كان التوسع الكلامي أو التطور اللغوي
ربما يتصرف في البابين بتحويلهما إلى ما يبعد من مجرى المجرد أو من أصلهما
كالإحسان والتحسين، والإصداق والتصديق، والإمداد والتمديد والإفراط
والتفريط، وغير ذلك، فإنما هي معان طرأت بحسب خصوصيات الموارد ثم تمكنت في
اللفظ بالاستعمال.
وينتج ما تقدم أن قوله: ﴿أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي﴾ يفيد أن
المراد بالدين هو مجموع المعارف والأحكام المشرعة وقد أضيف إلى عددها اليوم
شيء وإن النعمة أيا ما كانت أمر معنوي واحد كأنه كان ناقصا غير ذي أثر
فتمم وترتب عليه الأثر المتوقع منه.
والنعمة بناء نوع وهي ما يلائم طبع الشيء من غير امتناعه منه، والأشياء وإن
كانت بحسب وقوعها في نظام التدبير متصلة مرتبطة متلائما بعضها مع بعض،
وأكثرها أو جميعها نعم إذا أضيفت إلى بعض آخر مفروض كما قال تعالى: ﴿وإن
تعدوا نعمة الله لا تحصوها﴾: إبراهيم: 34 وقال: ﴿وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة
وباطنة﴾: لقمان: 20.
إلا أنه تعالى وصف بعضها بالشر والخسة واللعب واللهو وأوصاف أخر غير ممدوحة
كما قال: ﴿ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم
ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين﴾: آل عمران: 187، وقال: ﴿وما هذه الحيوة
الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان﴾: العنكبوت: 64، وقال:
﴿لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس
المهاد﴾: آل عمران: 179 إلى غير ذلك.
والآيات تدل على أن هذه الأشياء المعدودة نعما إنما تكون نعمة إذا وافقت
الغرض الإلهي من خلقتها لأجل الإنسان فإنها إنما خلقت لتكون إمدادا إلهيا
للإنسان يتصرف فيها في سبيل سعادته الحقيقية، وهي القرب منه سبحانه
بالعبودية والخضوع للربوبية، قال تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون﴾: الذاريات: 56.
فكل ما تصرف فيه الإنسان للسلوك به إلى حضرة القرب من الله وابتغاء مرضاته
فهو نعمة، وإن انعكس الأمر عاد نقمة في حقه، فالأشياء في نفسها عزل، وإنما
هي نعمة لاشتمالها على روح العبودية، ودخولها من حيث التصرف المذكور تحت
ولاية الله التي هي تدبير الربوبية لشئون العبد، ولازمه أن النعمة بالحقيقة
هي الولاية الإلهية، وأن الشيء إنما يصير نعمة إذا كان مشتملا على شيء
منها، قال تعالى: ﴿الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور﴾:
البقرة: 275، وقال تعالى: ﴿ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا
مولى لهم﴾: محمد: 11 وقال في حق رسوله: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾:
النساء: 65 إلى غير ذلك.
فالإسلام وهو مجموع ما نزل من عند الله سبحانه ليعبده به عباده دين، وهو من
جهة اشتماله - من حيث العمل به - على ولاية الله وولاية رسوله وأولياء
الأمر بعده نعمة.
ولا يتم ولاية الله سبحانه أي تدبيره بالدين لأمور عباده إلا بولاية رسوله،
ولا ولاية رسوله إلا بولاية أولي الأمر من بعده، وهي تدبيرهم لأمور الأمة
الدينية بإذن من الله قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا
الرسول وأولي الأمر منكم﴾: النساء: 59 وقد مر الكلام في معنى الآية، وقال:
﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة
وهم راكعون﴾: المائدة: 55 وسيجيء الكلام في معنى الآية إن شاء الله تعالى.
فمحصل معنى الآية: اليوم - وهو اليوم الذي يئس فيه الذين كفروا من دينكم -
أكملت لكم مجموع المعارف الدينية التي أنزلتها إليكم بفرض الولاية، وأتممت
عليكم نعمتي وهي الولاية التي هي إدارة أمور الدين وتدبيرها تدبيرا إلهيا،
فإنها كانت إلى اليوم ولاية الله ورسوله، وهي أنما تكفي ما دام الوحي ينزل،
ولا تكفي لما بعد ذلك من زمان انقطاع الوحي، ولا رسول بين الناس يحمي دين
الله ويذب عنه بل من الواجب أن ينصب من يقوم بذلك، وهو ولي الأمر بعد رسول
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) القيم على أمور الدين والأمة.
فالولاية مشروعة واحدة، كانت ناقصة غير تامة حتى إذا تمت بنصب ولي الأمر بعد النبي.
وإذا كمل الدين في تشريعه، وتمت نعمة الولاية فقد رضيت لكم من حيث الدين
الإسلام الذي هو دين التوحيد الذي لا يعبد فيه إلا الله ولا يطاع فيه -
والطاعة عبادة - إلا الله ومن أمر بطاعته من رسول أو ولي.
فالآية تنبىء عن أن المؤمنين اليوم في أمن بعد خوفهم، وأن الله رضي لهم أن
يتدينوا بالإسلام الذي هو دين التوحيد فعليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا
بطاعة غير الله أو من أمر بطاعته.
وإذا تدبرت قوله تعالى: ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي
ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر
بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون﴾: النور: 55 ثم طبقت فقرات الآية على فقرات
قوله تعالى: ﴿اليوم يئس الذين كفروا من دينكم﴾ إلخ وجدت آية سورة
المائدة من مصاديق إنجاز الوعد الذي يشتمل عليه آية سورة النور على أن يكون قوله:
﴿يعبدونني لا يشركون بي شيئا﴾ مسوقا سوق الغاية كما ربما يشعر به قوله:
﴿ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون﴾.
وسورة النور قبل
المائدة نزولا كما يدل عليه اشتمالها على قصة الإفك وآية الجد وآية الحجاب وغير ذلك.
قوله تعالى: ﴿فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم﴾
المخمصة هي المجاعة، والتجانف هو التمايل من الجنف بالجيم وهو ميل القدمين
إلى الخارج مقابل الحنف بالحاء الذي هو ميلهما إلى الداخل.
وفي سياق الآية دلالة أولا على أن الحكم حكم ثانوي اضطراري، وثانيا على أن
التجويز والإباحة مقدر بمقدار يرتفع به الاضطرار ويسكن به ألم الجوع،
وثالثا على أن صفة المغفرة ومثلها الرحمة كما تتعلق بالمعاصي المستوجبة
للعقاب كذلك يصح أن تتعلق بمنشئها، وهو الحكم الذي يستتبع مخالفته تحقق
عنوان المعصية الذي يستتبع العقاب.
بحث علمي في فصول ثلاثة
1 - العقائد في أكل اللحم:
لا ريب أن الإنسان كسائر الحيوان والنبات مجهز بجهاز التغذي يجذب به إلى
نفسه من الأجزاء المادية ما يمكنه أن يعمل فيه ما ينضم بذلك إلى بدنه
وينحفظ به بقاؤه، فلا مانع له بحسب الطبع من أكل ما يقبل الإزدراد والبلع
إلا أن يمتنع منه لتضرر أو تنفر.
أما التضرر فهو كان يجد المأكول يضر ببدنه ضرا جسمانيا لمسمومية ونحوها
فيمتنع عندئذ عن الأكل، أو يجد الأكل يضر ضرا معنويا كالمحرمات التي في
الأديان والشرائع المختلفة، وهذا القسم امتناع عن الأكل فكري.
وأما التنفر فهو الاستقذار الذي يمتنع معه الطبع عن القرب منه كما أن
الإنسان لا يأكل مدفوع نفسه لاستقذاره إياه، وقد شوهد ذلك في بعض الأطفال
والمجانين، ويلحق بذلك ما يستند إلى عوامل اعتقادية كالمذهب أو السنن
المختلفة الرائجة في المجتمعات المتنوعة مثل أن المسلمين يستقذرون لحم
الخنزير، والنصارى يستطيبونه، ويتغذى الغربيون من أنواع الحيوانات أجناسا
كثيرة يستقذرها الشرقيون كالسرطان والضفدع والفأر وغيرها، وهذا النوع من
الامتناع امتناع بالطبع الثاني والقريحة المكتسبة.
فتبين أن الإنسان في التغذي باللحوم على طرائق مختلفة ذات عرض عريض من
الاسترسال المطلق إلى الامتناع، وأن استباحته ما استباح منها اتباع للطبع
كما أن امتناعه عما يمتنع عنه أنما هو عن فكر أو طبع ثانوي.
وقد حرمت سنة بوذا أكل لحوم الحيوانات عامة، وهذا تفريط يقابله في جانب
الإفراط ما كان دائرا بين أقوام متوحشين من إفريقية وغيرها إنهم كانوا
يأكلون أنواع اللحوم حتى لحم الإنسان.
وقد كانت العرب تأكل لحوم الأنعام وغيرها من الحيوان حتى أمثال الفأر
والوزغ، وتأكل من الأنعام ما قتلته بذبح ونحوه، وتأكل غير ذلك كالميتة
بجميع أقسامها كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وكان
القائل منهم يقول: ما لكم تأكلون مما قتلتموه ولا تأكلون مما قتله الله؟!
كما ربما يتفوه بمثله اليوم كثيرون؟ يقول قائلهم: ما الفارق بين اللحم
واللحم إذا لم يتضرر به بدن الإنسان ولو بعلاج طبي فنى فجهاز التغذي لا
يفرق بين هذا وذاك.
وكانت العرب أيضا تأكل الدم، كانوا يملئون المعى من الدم ويشوونه ويطعمونه
الضيف، وكانوا إذا أجدبوا جرحوا إبلهم بالنصال وشربوا ما ينزل من الدم،
وأكل الدم رائج اليوم بين كثير من الأمم غير المسلمة.
وأهل الصين من الوثنية أوسع منهم سنة، فهم - على ما ينقل - يأكلون أصناف
الحيوان حتى الكلب والهر وحتى الديدان والأصداف وسائر الحشرات.
وقد أخذ الإسلام في ذلك طريقا وسطا فأباح من اللحوم ما تستطيعه الطباع
المعتدلة من الإنسان، ثم فسره في ذوات الأربع بالبهائم كالضأن والمعز
والبقر والإبل على كراهية في بعضها كالفرس والحمار، وفي الطير - بغير
الجوارح - مما له حوصلة ودفيف ولا مخلب له، وفي حيوان البحر ببعض أنواع
السمك على التفصيل المذكور في كتب الفقه.
ثم حرم دماءها وكل ميتة منها وما لم يذك بالإهلال به لله عز اسمه، والغرض
في ذلك أن تحيا سنة الفطرة، وهي إقبال الإنسان على أصل أكل اللحم، ويحترم
الفكر الصحيح والطبع المستقيم اللذين يمتنعان من تجويز ما فيه الضرر نوعا،
وتجويز ما يستقذر ويتنفر منه.
2 - كيف أمر بقتل الحيوان والرحمة تأباه؟
ربما يسأل السائل فيقول إن الحيوان ذو روح شاعرة بما يشعر به الإنسان من
ألم العذاب ومرارة الفناء والموت وغريزة حب الذات التي تبعثنا إلى الحذر من
كل مكروه والفرار من ألم العذاب والموت تستدعي الرحمة لغيرنا من أفراد
النوع لأنه يؤلمهم ما يؤلمنا، ويشق عليهم ما يشق علينا، والنفوس سواء.
وهذا القياس جار بعينه في سائر أنواع الحيوان، فكيف يسوغ لنا أن نعذبهم بما
نتعذب به، ونبدل لهم حلاوة الحياة من مرارة الموت، ونحرمهم نعمة البقاء
التي هي أشرف نعمة؟ والله سبحانه أرحم الراحمين فكيف يسع رحمته أن يأمر
بقتل حيوان ليلتذ به إنسان وهما جميعا في أنهما خلقه سواء؟.
والجواب عنه أنه من تحكيم العواطف على الحقائق والتشريع إنما يتبع المصالح الحقيقية دون العواطف الوهمية.
توضيح ذلك أنك إذا تتبعت الموجودات التي تحت مشاهدتك بالميسور مما عندك
وجدتها في تكونها وبقائها تابعة لناموس التحول، فما من شيء إلا وفي إمكانه
أن يتحول إلى آخر، وأن يتحول الآخر إليه بغير واسطة أو بواسطة، لا يوجد
واحد إلا ويعدم آخر، ولا يبقى هذا إلا ويفني ذاك، فعالم المادة عالم
التبديل، والتبدل وإن شئت فقل: عالم الآكل والمأكول.
فالمركبات الأرضية تأكل الأرض بضمها إلى أنفسها وتصويرها بصورة تناسبها أو تختص بها ثم الأرض تأكلها وتفنيها.
ثم النبات يتغذى بالأرض ويستنشق الهواء ثم الأرض تأكله وتجزئه إلى أجزائه الأصلية وعناصره الأولية، ولا يزال أحدهما يراجع الآخر.
ثم الحيوان يتغذى بالنبات والماء ويستنشق الهواء، وبعض أنواعه يتغذى ببعض
كالسباع تأكل لحوم غيرها بالاصطياد، وجوارح الطير تأكل أمثال الحمام
والعصافير لا يسعها بحسب جهاز التغذي الذي يخصها إلا ذلك، وهي تتغذى
بالحبوب وأمثال الذباب والبق والبعوض وهي تتغذى بدم الإنسان وسائر الحيوان
ونحوه، ثم الأرض تأكل الجميع.
فنظام التكوين وناموس الخلقة الذي له الحكومة المطلقة المتبعة على
الموجودات هو الذي وضع حكم التغذي باللحوم ونحوها، ثم هدى أجزاء الوجود إلى
ذلك، وهو الذي سوى الإنسان تسوية صالحة للتغذي بالحيوان والنبات جميعا.
وفي مقدم جهازه الغذائي أسنانه المنضودة نضدا صالحا للقطع والكسر والنهش
والطحن من ثنايا ورباعيات وأنياب وطواحن، فلا هو مثل الغنم والبقر من
الأنعام لا تستطيع قطعا ونهشا، ولا هو كالسباع لا تستطيع طحنا ومضغا.
ثم القوة الذائقة المعدة في فمه التي تستلذ طعم اللحوم ثم الشهوة المودعة في سائر أعضاء هضمه جميع هذه تستطيب اللحوم وتشتهيها.
كل ذلك هداية تكوينية وإباحة من مؤتمن الخلقة، وهل يمكن الفرق بين الهداية
التكوينية، وإباحة العمل المهدي إليه بتسليم أحدهما وإنكار الآخر؟.
والإسلام دين فطري لا هم له إلا إحياء آثار الفطرة التي أعفتها الجهالة
الإنسانية، فلا مناص من أن يستباح به ما تهدي إليه الخلقة وتقضي به الفطرة.
وهو كما يحيي بالتشريع هذا الحكم الفطري يحيي أحكاما أخرى وضعها واضع
التكوين، وهو ما تقدم ذكره من الموانع من الاسترسال في حكم التغذي أعني حكم
العقل بوجوب اجتناب ما فيه ضرر جسماني أو معنوي من اللحوم، وحكم الإحساسات
والعواطف الباطنية بالتحذر والامتناع عما يستقذره ويتنفر منه الطباع
المستقيمة، وهذان الحكمان أيضا ينتهي أصولهما إلى تصرف من التكوين، وقد
اعتبرهما الإسلام فحرم ما يضر نماء الجسم، وحرم ما يضر بمصالح المجتمع
الإنساني، مثل ما أهل به لغير الله، وما اكتسب من طريق الميسر والاستقسام
بالأزلام ونحو ذلك، وحرم الخبائث التي تستقذرها الطباع.
وأما حديث الرحمة المانعة من التعذيب والقتل فلا شك أن الرحمة موهبة لطيفة
تكوينية أودعت في فطرة الإنسان وكثير مما اعتبرنا حاله من الحيوان، إلا أن
التكوين لم يوجدها لتحكم في الأمور حكومة مطلقة وتطاع طاعة مطلقة، فالتكوين
نفسه لا يستعمل الرحمة استعمالا مطلقا، ولو كان ذلك لم يوجد في دار الوجود
أثر من الآلام والأسقام والمصائب وأنواع العذاب.
ثم الرحمة الإنسانية في نفسها ليست خلقا فاضلا على الإطلاق كالعدل، ولو كان
كذلك لم يحسن أن نؤاخذ ظالما على ظلمه أو نجازي مجرما على جرمه ولا أن
نقابل عدوانا بعدوان وفيه هلاك الأرض ومن عليها.
ومع ذلك لم يهمل الإسلام أمر الرحمة بما أنها من مواهب التكوين، فأمر بنشر
الرحمة عموما، ونهى عن زجر الحيوان في القتل، ونهى عن قطع أعضاء الحيوان
المذبوح وسلخه قبل زهاق روحه - ومن هذا الباب تحريم المنخنقة والموقوذة -
ونهى عن قتل الحيوان وآخر ينظر إليه، ووضع للتذكية أرفق الأحكام بالحيوان
المذبوح وأمر بعرض الماء عليه ونحو ذلك مما يوجد تفصيله في كتب الفقه.
ومع ذلك كله الإسلام دين التعقل لا دين العاطفة فلا يقدم حكم العاطفة على
الأحكام المصلحة لنظام المجتمع الإنساني ولا يعتبر منه إلا ما اعتبره
العقل، ومرجع ذلك إلى اتباع حكم العقل.
وأما حديث الرحمة الإلهية وأنه تعالى أرحم الراحمين، فهو تعالى غير متصف
بالرحمة بمعنى رقة القلب أو التأثر الشعوري الخاص الباعث للراحم على التلطف
بالمرحوم، فإن ذلك صفة جسمانية مادية تعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل معناها
إفاضته تعالى الخير على مستحقه بمقدار ما يستحقه، ولذلك ربما كان ما نعده
عذابا رحمة منه تعالى وبالعكس، فليس من الجائز في الحكمة أن يبطل مصلحة من
مصالح التدبير في التشريع اتباعا لما تقترحه عاطفة الرحمة الكاذبة التي
فينا، أو يساهل في جعل الشرائع محاذية للواقعيات.
فتبين من جميع ما مر أن الإسلام يحاكي في تجويز أكل اللحوم وفي القيود التي
قيد بها الإباحة والشرائط التي اشترطها جميعا أمر الفطرة: فطرة الله التي
فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم!.
3 - لماذا بني الإسلام على التذكية؟
وهذا سؤال آخر يتفرع على السؤال المتقدم، وهو أنا سلمنا أن أكل اللحوم مما
تبيحه الفطرة والخلقة فهلا اقتصر في ذلك بما يحصل على الصدفة ونحوها بأن
يقتصر في اللحوم بما يهيئه الموت العارض حتف الأنف، فيجمع في ذلك بين حكم
التكوين بالجواز، وحكم الرحمة بالإمساك عن تعذيب الحيوان وزجره بالقتل أو
الذبح من غير أن يعدل عن ذلك إلى التذكية والذبح؟.
وقد تبين الجواب عنه مما تقدم في الفصل الثاني، فإن الرحمة بهذا المعنى غير واجب الاتباع بل اتباعه يفضي إلى إبطال أحكام الحقائق.
وقد عرفت أن الإسلام مع ذلك لم يأل جهدا في الأمر بإعمال الرحمة قدر ما يمكن في هذا الباب حفظا لهذه الملكة اللطيفة بين النوع.
على أن الاقتصار على إباحة الميتة وأمثالها مما لا ينتج التغذي به إلا فساد
المزاج ومضار الأبدان هو بنفسه خلاف الرحمة، وبعد ذلك كله لا يخلو عن
الحرج العام الواجب نفيه.
بحث روائي:
في
تفسير العياشي، عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما نزلت آية: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾
إلا وعلي شريفها وأميرها، ولقد عاتب الله أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله
وسلم) في غير مكان وما ذكر عليا إلا بخير: . أقول: وروي في
تفسير البرهان، عن موفق بن أحمد، عن عكرمة، عن ابن عباس: مثله إلى قوله: وأميرها. ورواه أيضا العياشي عن عكرمة.
وقد نقلنا الحديث سابقا عن الدر المنثور.
وفي بعض الروايات عن الرضا (عليه السلام) قال: ليس في
القرآن ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ إلا في حقنا وهو من الجري أو من باطن التنزيل.
وفيه، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول
الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ قال: العهود: . أقول: ورواه
القمي، أيضا في تفسيره عنه. وفي التهذيب، مسندا عن محمد بن مسلم قال: سألت
أحدهما (عليهما السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام﴾
فقال: الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه الذي عنى الله
تعالى: . أقول: والحديث مروي في الكافي، والفقيه، عنه عن أحدهما، وروى هذا
المعنى العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن أحدهما، وعن زرارة عن الصادق
(عليه السلام)، ورواه القمي في تفسيره، ورواه في المجمع، عن أبي جعفر وأبي
عبد الله (عليه السلام).
وفي
تفسير القمي: في قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله﴾ الآية
الشعائر: الإحرام والطواف والصلاة في مقام إبراهيم والسعي بين الصفا
والمروة، والمناسك كلها من شعائر الله، ومن الشعائر إذا ساق الرجل بدنة في
حج ثم أشعرها أي قطع سنامها أو جلدها أو قلدها ليعلم الناس أنها هدي فلا
يتعرض لها أحد. وإنما سميت الشعائر ليشعر الناس بها فيعرفوها، وقوله: ﴿ولا
الشهر الحرام﴾ وهو ذو الحجة وهو من الأشهر الحرم، وقوله: ﴿ولا الهدي﴾ وهو
الذي يسوقه إذا أحرم المحرم، وقوله: ﴿ولا القلائد﴾ قال: يقلدها النعل التي
قد صلى فيها. قوله: ﴿ولا آمين البيت الحرام﴾ قال: الذين يحجون البيت وفي
المجمع، قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام): نزلت هذه الآية في رجل من بني
ربيعة يقال له: الحطم. قال: وقال السدي: أقبل الحطم بن هند البكري حتى أتى
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وحده وخلف خيله خارج المدينة فقال: إلى ما
تدعو؟ وقد كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لأصحابه: يدخل عليكم
اليوم رجل من بني ربيعة يتكلم بلسان شيطان فلما أجابه النبي (صلى الله عليه
وآله وسلم) قال؟ أنظرني لعلي أسلم ولي من أشاوره، فخرج من عنده فقال رسول
الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لقد دخل بوجه كافر، وخرج بعقب غادر، فمر
بسرح من سروح المدينة فساقه وانطلق به وهو يرتجز ويقول: قد لفها الليل
بسواق حطم ليس براعي إبل ولا غنم. ولا بجزار على ظهر وضم باتوا نياما وابن
هند لم ينم. بات يقاسيها غلام كالزلم خدلج الساقين ممسوح القدم. ثم أقبل من
عام قابل حاجا قد قلد هديا فأراد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن
يبعث إليه فنزلت هذه الآية: ﴿ولا آمين البيت الحرام﴾. قال: وقال ابن زيد:
نزلت يوم الفتح في ناس يؤمون البيت من المشركين يهلون بعمرة، فقال
المسلمون: يا رسول الله إن هؤلاء مشركون مثل هؤلاء دعنا نغير عليهم فأنزل
الله تعالى الآية.
أقول: روى الطبري القصة عن السدي وعكرمة، والقصة الثانية عن ابن زيد وروي
في الدر المنثور، القصة الثانية عن ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم وفيه: أنه
كان يوم الحديبية.
والقصتان جميعا لا توافقان ما هو كالمتسلم عليه عند المفسرين وأهل النقل أن سورة
المائدة نزلت في حجة الوداع، إذ لو كان كذلك كان قوله: ﴿إنما المشركون نجس فلا
يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾: البراءة: 28، وقوله: ﴿فاقتلوا
المشركين حيث وجدتموهم﴾: البراءة: 5 الآيتان جميعا نازلتين قبل قوله: ﴿ولا
آمين البيت الحرام﴾ ولا محل حينئذ للنهي عن التعرض للمشركين إذا قصدوا
البيت الحرام.
ولعل شيئا من هاتين القصتين أو ما يشابههما هو السبب لما نقل عن ابن عباس
ومجاهد وقتادة والضحاك: أن قوله: ﴿ولا آمين البيت الحرام﴾ منسوب بقوله:
﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ الآية وقوله: ﴿إنما المشركون نجس فلا
يقربوا المسجد الحرام﴾ الآية، وقد وقع حديث النسخ في
تفسير القمي، وظاهره أنه رواية.
ومع ذلك كله تأخر سورة
المائدة نزولا يدفع ذلك كله، وقد ورد من طرق أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أنها
ناسخة غير منسوخة على أن قوله تعالى فيها: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ الآية
يأبى أن يطرء على بعض آيها نسخ وعلى هذا يكون مفاد قوله: ﴿ولا آمين البيت
الحرام﴾ كالمفسر بقوله بعد: ﴿ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد
الحرام أن تعتدوا﴾، أي لا تذهبوا بحرمة البيت بالتعرض لقاصديه لتعرض منهم
لكم قبل هذا، ولا غير هؤلاء ممن صدوكم قبلا عن المسجد الحرام أن تعتدوا
عليهم بإثم كالقتل أو عدوان كالذي دون القتل من الظلم بل تعاونوا على البر
والتقوى.
وفي الدر المنثور: أخرج أحمد وعبد بن حميد: في هذه الآية يعني قوله:
﴿وتعاونوا على البر﴾ الآية: والبخاري في تاريخه، عن وابصة قال: أتيت رسول
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا لا أريد أن أدع شيئا من البر والإثم
إلا سألته عنه فقال لي: يا وابصة أخبرك عما جئت تسأل عنه أم تسأل؟ قلت: يا
رسول الله أخبرني قال: جئت لتسأل عن البر والإثم، ثم جمع أصابعه الثلاث
فجعل ينكت بها في صدري ويقول: يا وابصة استفت قبلك استفت نفسك البر ما
اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب، وتردد في
الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. وفيه:، أخرج أحمد وعبد بن حميد وابن حبان
والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي أمامة: أن رجلا سأل النبي (صلى
الله عليه وآله وسلم) عن الإثم فقال: ما حاك في نفسك فدعه. قال: فما
الإيمان؟ قال: من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. وفيه: أخرج ابن أبي
شيبة وأحمد والبخاري في الأدب ومسلم والترمذي والحاكم والبيهقي في الشعب عن
النواس بن