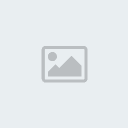بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿1﴾
الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿2﴾ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ﴿3﴾ مَلِكِ
يَوْمِ الدِّينِ ﴿4﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿5﴾
بيان:
قوله تعالى: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ الناس ربما يعملون عملا أو يبتدئون
في عمل ويقرنونه باسم عزيز من أعزتهم أو كبير من كبرائهم، ليكون عملهم ذاك
مباركا بذلك متشرفا، أو ليكون ذكرى يذكرهم به، ومثل ذلك موجود أيضا في باب
التسمية فربما يسمون المولود الجديد من الإنسان، أو شيئا مما صنعوه أو
عملوه كدار بنوها أو مؤسسة أسسوها باسم من يحبونه أو يعظمونه، ليبقى الاسم
ببقاء المسمى الجديد، ويبقى المسمى الأول نوع بقاء ببقاء الاسم كمن يسمي
ولده باسم والده ليحيي بذلك ذكره فلا يزول ولا ينسى.
وقد جرى كلامه تعالى هذا المجرى، فابتدأ الكلام باسمه عز اسمه ليكون ما
يتضمنه من المعنى معلما باسمه مرتبطا به، وليكون أدبا يؤدب به العباد في
الأعمال والأفعال والأقوال، فيبتدءوا باسمه ويعملوا به، فيكون ما يعملونه
معلما باسمه منعوتا بنعته تعالى مقصودا لأجله سبحانه فلا يكون العمل هالكا
باطلا مبترا، لأنه باسم الله الذي لا سبيل للهلاك والبطلان إليه.
وذلك أن الله سبحانه يبين في مواضع من كلامه: أن ما ليس لوجهه الكريم هالك
باطل، وأنه: سيقدم إلى كل عمل عملوه مما ليس لوجهه الكريم، فيجعله هباء
منثورا، ويحبط ما صنعوا ويبطل ما كانوا يعملون، وأنه لا بقاء لشيء إلا وجهه
الكريم فما عمل لوجهه الكريم وصنع باسمه هو الذي يبقى ولا يفنى، وكل أمر
من الأمور إنما نصيبه من البقاء بقدر ما لله فيه نصيب، وهذا هو الذي يفيده
ما رواه الفريقان عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: كل أمر ذي
بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر الحديث.
والأبتر هو المنقطع الآخر، فالأنسب أن متعلق الباء في البسملة أبتدىء
بالمعنى الذي ذكرناه فقد ابتدأ بها الكلام بما أنه فعل من الأفعال، فلا
محالة له وحدة، ووحدة الكلام بوحدة مدلوله ومعناه، فلا محالة له معنى ذا
وحدة وهو المعنى المقصود إفهامه من إلقاء الكلام، والغرض المحصل منه.
وقد ذكر الله سبحانه الغرض المحصل من كلامه الذي هو جملة
القرآن إذ قال: ﴿تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله﴾ المائدة: 16 إلى غير ذلك من
الآيات التي أفاد فيها: أن الغاية من كتابه وكلامه هداية العباد، فالهداية جملة
هي المبتدئة باسم الله الرحمن الرحيم، فهو الله الذي إليه مرجع العباد، وهو
الرحمن يبين لعباده سبيل رحمته العامة للمؤمن والكافر، مما فيه خيرهم في
وجودهم وحياتهم، وهو الرحيم يبين لهم سبيل رحمته الخاصة بالمؤمنين وهو
سعادة آخرتهم ولقاء ربهم وقد قال تعالى: ﴿ورحمتي وسعت كل شيء وسأكتبها
للذين يتقون﴾ الأعراف: 156.
فهذا بالنسبة إلى جملة القرآن.
ثم إنه سبحانه كرر ذكر السورة في كلامه كثيرا كقوله تعالى: ﴿فأتوا بسورة مثله﴾ يونس: 38.
وقوله: ﴿فأتوا بعشر سور مثله مفتريات﴾ هود: 13.
وقوله تعالى: ﴿إذا أنزلت سورة﴾ التوبة: 86.
وقوله: ﴿سورة أنزلناها وفرضناها﴾ النور: 1.
فبان لنا من ذلك: أن لكل طائفة من هذه الطوائف من كلامه التي فصلها قطعا
قطعا، وسمي كل قطعة سورة نوعا من وحدة التأليف والتمام، لا يوجد بين أبعاض
من سورة ولا بين سورة وسورة، ومن هنا نعلم: أن الأغراض والمقاصد المحصلة من
السور مختلفة، وأن كل واحدة منها مسوقة لبيان معنى خاص ولغرض محصل لا تتم
السورة إلا بتمامه، وعلى هذا فالبسملة في مبتدأ كل سورة راجعة إلى الغرض
الخاص من تلك السورة.
فالبسملة في سورة الحمد راجعة إلى غرض السورة والمعنى المحصل منه، والغرض
الذي يدل عليه سرد الكلام في هذه السورة هو حمد الله بإظهار العبودية له
سبحانه بالإفصاح عن العبادة والاستعانة وسؤال الهداية، فهو كلام يتكلم به
الله سبحانه نيابة عن العبد، ليكون متأدبا في مقام إظهار العبودية بما أدبه
الله به.
وإظهار العبودية من العبد هو العمل الذي يتلبس به العبد، والأمر ذو البال
الذي يقدم عليه، فالابتداء باسم الله سبحانه الرحمن الرحيم راجع إليه،
فالمعنى باسمك أظهر لك العبودية.
فمتعلق الباء في بسملة الحمد الابتداء ويراد به تتميم الإخلاص في مقام العبودية بالتخاطب.
وربما يقال إنه الاستعانة ولا بأس به ولكن الابتداء أنسب لاشتمال السورة على الاستعانة صريحا في قوله تعالى: ﴿وإياك نستعين﴾.
وأما الاسم، فهو اللفظ الدال على المسمى مشتق من السمة بمعنى العلامة أو من
السمو بمعنى الرفعة وكيف كان فالذي يعرفه منه اللغة والعرف هو اللفظ الدال
ويستلزم ذلك أن يكون غير المسمى، وأما الإسلام بمعنى الذات مأخوذا بوصف من
أوصافه فهو من الأعيان لا من الألفاظ وهو مسمى الاسم بالمعنى الأول كما أن
لفظ العالم من أسماء الله تعالى اسم يدل على مسماه وهو الذات مأخوذة بوصف
العلم وهو بعينه اسم بالنسبة إلى الذات الذي لا خبر عنه إلا بوصف من أوصافه
ونعت من نعوته والسبب في ذلك أنهم وجدوا لفظ الاسم موضوعا للدال على
المسمى من الألفاظ، ثم وجدوا أن الأوصاف المأخوذة على وجه تحكي عن الذات
وتدل عليه حال اللفظ المسمى بالاسم في أنها تدل على ذوات خارجية، فسموا هذه
الأوصاف الدالة على الذوات أيضا أسماء فأنتج ذلك أن الاسم كما يكون أمرا
لفظيا كذلك يكون أمرا عينيا، ثم وجدوا أن الدال على الذات القريب منه هو
الاسم بالمعنى الثاني المأخوذ بالتحليل، وأن الاسم بالمعنى الأول إنما يدل
على الذات بواسطته، ولذلك سموا الذي بالمعنى الثاني اسما، والذي بالمعنى
الأول اسم الاسم، هذا ولكن هذا كله أمر أدى إليه التحليل النظري ولا ينبغي
أن يحمل على اللغة، فالاسم بحسب اللغة ما ذكرناه.
وقد شاع النزاع بين المتكلمين في الصدر الأول من الإسلام في أن الاسم عين
المسمى أو غيره وطالت المشاجرات فيه، ولكن هذا النوع من المسائل قد اتضحت
اليوم اتضاحا يبلغ إلى حد الضرورة ولا يجوز الاشتغال بها بذكر ما قيل وما
يقال فيها والعناية بإبطال ما هو الباطل وإحقاق ما هو الحق فيها، فالصفح عن
ذلك أولى.
وأما لفظ الجلالة، فالله أصله الإله، حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، وإله من
أله الرجل يأله بمعنى عبد، أو من أله الرجل أو وله الرجل أي تحير، فهو
فعال بكسر الفاء بمعنى المفعول ككتاب بمعنى المكتوب سمي إلها لأنه معبود أو
لأنه مما تحيرت في ذاته العقول، والظاهر أنه علم بالغلبة، وقد كان مستعملا
دائرا في الألسن قبل نزول
القرآن يعرفه العرب الجاهلي كما يشعر به قوله تعالى: ﴿ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله﴾ الزخرف: 87.
قوله تعالى: ﴿فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا﴾ الأنعام: 136.
ومما يدل على كونه علما أنه يوصف بجميع الأسماء الحسنى وسائر أفعاله
المأخوذة من تلك الأسماء من غير عكس، فيقال: الله الرحمن الرحيم ويقال: رحم
الله وعلم الله، ورزق الله، ولا يقع لفظ الجلالة صفة لشيء منها ولا يؤخذ
منه ما يوصف به شيء منها.
ولما كان وجوده سبحانه، وهو إله كل شيء يهدي إلى اتصافه بجميع الصفات
الكمالية كانت الجميع مدلولا عليها به بالالتزام، وصح ما قيل إن لفظ
الجلالة اسم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال وإلا فهو علم
بالغلبة لم تعمل فيه عناية غير ما يدل عليه مادة أله.
وأما الوصفان: الرحمن الرحيم، فهما من الرحمة، وهي وصف انفعالي وتأثر خاص
يلم بالقلب عند مشاهدة من يفقد أو يحتاج إلى ما يتم به أمره فيبعث الإنسان
إلى تتميم نقصه ورفع حاجته، إلا أن هذا المعنى يرجع بحسب التحليل إلى
الإعطاء والإفاضة لرفع الحاجة وبهذا المعنى يتصف سبحانه بالرحمة.
والرحمن، فعلان صيغة مبالغة تدل على الكثرة، والرحيم فعيل صفة مشبهة تدل
على الثبات والبقاء ولذلك ناسب الرحمن أن يدل على الرحمة الكثيرة المفاضة
على المؤمن والكافر وهو الرحمة العامة، وعلى هذا المعنى يستعمل كثيرا في
القرآن، قال تعالى: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ طه: 5.
وقال: ﴿قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا﴾ مريم: 75.
إلى غير ذلك، ولذلك أيضا ناسب الرحيم أن يدل على النعمة الدائمة والرحمة
الثابتة الباقية التي تفاض على المؤمن كما قال تعالى: ﴿وكان بالمؤمنين
رحيما﴾ الأحزاب: 43.
وقال تعالى: ﴿إنه بهم رءوف رحيم﴾ التوبة: 117.
إلى غير ذلك، ولذلك قيل: إن الرحمن عام للمؤمن والكافر والرحيم خاص بالمؤمن.
وقوله تعالى: ﴿الحمد لله﴾ الحمد على ما قيل هو الثناء على الجميل الاختياري
والمدح أعم منه، يقال: حمدت فلانا أو مدحته لكرمه، ويقال: مدحت اللؤلؤ على
صفائه ولا يقال: حمدته على صفائه، واللام فيه للجنس أو الاستغراق والمال
هاهنا واحد.
وذلك أن الله سبحانه يقول: ﴿ذلكم الله ربكم خالق كل شيء﴾ غافر: 62.
فأفاد أن كل ما هو شيء فهو مخلوق لله سبحانه، وقال: ﴿الذي أحسن كل شيء خلقه﴾ السجدة: 7.
فأثبت الحسن لكل شيء مخلوق من جهة أنه مخلوق له منسوب إليه، فالحسن يدور
مدار الخلق وبالعكس، فلا خلق إلا وهو حسن جميل بإحسانه ولا حسن إلا وهو
مخلوق له منسوب إليه، وقد قال تعالى: ﴿هو الله الواحد القهار﴾ الزمر: 4.
وقال: ﴿وعنت الوجوه للحي القيوم﴾ طه: 111.
فأنبأ أنه لم يخلق ما خلق بقهر قاهر ولا يفعل ما فعل بإجبار من مجبر بل
خلقه عن علم واختيار فما من شيء إلا وهو فعل جميل اختياري له فهذا من جهة
الفعل، وأما من جهة الاسم فقد قال تعالى: ﴿الله لا إله إلا هو له الأسماء
الحسنى﴾ طه: 8.
وقال تعالى ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه﴾ الأعراف: 180.
فهو تعالى جميل في أسمائه وجميل في أفعاله، وكل جميل منه.
فقد بان أنه تعالى محمود على جميل أسمائه ومحمود على جميل أفعاله، وأنه ما
من حمد يحمده حامد لأمر محمود إلا كان لله سبحانه حقيقة لأن الجميل الذي
يتعلق به الحمد منه سبحانه، فلله سبحانه جنس الحمد وله سبحانه كل حمد.
ثم إن الظاهر من السياق وبقرينة الالتفات الذي في قوله: ﴿إياك نعبد﴾ الآية
أن السورة من كلام العبد، وأنه سبحانه في هذه السورة يلقن عبده حمد نفسه
وما ينبغي أن يتأدب به العبد عند نصب نفسه في مقام العبودية، وهو الذي
يؤيده قوله: ﴿الحمد لله﴾.
وذلك أن الحمد توصيف، وقد نزه سبحانه نفسه عن وصف الواصفين من عباده حيث
قال: ﴿سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين﴾ الصافات: 160.
والكلام مطلق غير مقيد، ولم يرد في كلامه تعالى ما يؤذن بحكاية الحمد عن
غيره إلا ما حكاه عن عدة من أنبيائه المخلصين، قال تعالى في خطابه لنوح
(عليه السلام): ﴿فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين﴾ المؤمنون:
28.
وقال تعالى حكاية عن إبراهيم (عليه السلام): ﴿الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق﴾ إبراهيم: 39.
وقال تعالى لنبيه محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) في بضعة مواضع من كلامه: ﴿وقل الحمد لله﴾ النمل: 93.
وقال تعالى حكاية عن داود وسليمان (عليهما السلام) ﴿وقالا الحمد لله﴾ النمل: 15.
وإلا ما حكاه عن أهل الجنة وهم المطهرون من غل الصدور ولغو القول والتأثيم كقوله.﴿وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين﴾ يونس: 10.
وأما غير هذه الموارد فهو تعالى وإن حكى الحمد عن كثير من خلقه بل عن جميعهم، كقوله تعالى: ﴿والملائكة يسبحون بحمد ربهم﴾ الشورى: 5.
وقوله ﴿ويسبح الرعد بحمده﴾ الرعد: 13 وقوله ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده﴾ الإسراء: 44.
إلا أنه سبحانه شفع الحمد في جميعها بالتسبيح بل جعل التسبيح هو الأصل في
الحكاية وجعل الحمد معه، وذلك أن غيره تعالى لا يحيط بجمال أفعاله وكمالها
كما لا يحيطون بجمال صفاته وأسمائه التي منها جمال الأفعال، قال تعالى:
﴿ولا يحيطون به علما﴾ طه: 110 فما وصفوه به فقد أحاطوا به وصار محدودا
بحدودهم مقدرا بقدر نيلهم منه، فلا يستقيم ما أثنوا به من ثناء إلا من بعد
أن ينزهوه ويسبحوه عن ما حدوه وقدروه بأفهامهم، قال تعالى: ﴿إن الله يعلم
وأنتم لا تعلمون﴾ النحل: 74، وأما المخلصون من عباده تعالى فقد جعل حمدهم
حمده ووصفهم وصفه حيث جعلهم مخلصين له، فقد بان أن الذي يقتضيه أدب
العبودية أن يحمد العبد ربه بما حمد به نفسه ولا يتعدى عنه، كما في الحديث
الذي رواه الفريقان عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): لا أحصي ثناء عليك
أنت كما أثنيت على نفسك الحديث فقوله في أول هذه السورة: الحمد لله، تأديب
بأدب عبودي ما كان للعبد أن يقوله لو لا أن الله تعالى قاله نيابة وتعليما
لما ينبغي الثناء به.
وقوله تعالى: ﴿رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين﴾ وقرأ الأكثر ملك
يوم الدين فالرب هو المالك الذي يدبر أمر مملوكه، ففيه معنى الملك، ومعنى
الملك الذي عندنا في ظرف الاجتماع هو نوع خاص من الاختصاص وهو نوع قيام شيء
بشيء يوجب صحة التصرفات فيه، فقولنا العين الفلانية ملكنا معناه: أن لها
نوعا من القيام والاختصاص بنا يصح معه تصرفاتنا فيها ولو لا ذلك لم تصح تلك
التصرفات وهذا في الاجتماع معنى وضعي اعتباري غير حقيقي وهو مأخوذ من معنى
آخر حقيقي نسميه أيضا ملكا، وهو نحو قيام أجزاء وجودنا وقوانا بنا فإن لنا
بصرا وسمعا ويدا ورجلا، ومعنى هذا الملك أنها في وجودها قائمة بوجودنا غير
مستقلة دوننا بل مستقلة باستقلالنا ولنا أن نتصرف فيها كيف شئنا وهذا هو
الملك الحقيقي.
والذي يمكن انتسابه إليه تعالى بحسب الحقيقة هو حقيقة الملك دون الملك
الاعتباري الذي يبطل ببطلان الاعتبار والوضع، ومن المعلوم أن الملك الحقيقي
لا ينفك عن التدبير فإن الشيء إذا افتقر في وجوده إلى شيء فلم يستقل عنه
في وجوده لم يستقل عنه في آثار وجوده، فهو تعالى رب لما سواه لأن الرب هو
المالك المدبر وهو تعالى كذلك.
وأما العالمين: فهو جمع العالم بفتح اللام بمعنى ما يعلم به كالقالب
والخاتم والطابع بمعنى ما يقلب به وما يختم به وما يطبع به، يطلق على جميع
الموجودات وعلى كل نوع مؤلف الأفراد والأجزاء منها كعالم الجماد وعالم
النبات وعالم الحيوان وعالم الإنسان وعلى كل صنف مجتمع الأفراد أيضا كعالم
العرب وعالم العجم وهذا المعنى هو الأنسب لما يئول إليه عد هذه الأسماء
الحسنى حتى ينتهي إلى قوله مالك يوم الدين على أن يكون الدين وهو الجزاء
يوم القيامة مختصا بالإنسان أو الإنس والجن فيكون المراد بالعالمين عوالم
الإنس والجن وجماعاتهم ويؤيده ورود هذا اللفظ بهذه العناية في
القرآن كقوله تعالى ﴿واصطفاك على نساء العالمين﴾ آل عمران: 42.
وقوله تعالى: ﴿ليكون للعالمين نذيرا﴾ الفرقان: 1، وقوله تعالى: ﴿أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين﴾ الأعراف: 80.
وأما مالك يوم الدين فقد عرفت معنى المالك وهو المأخوذ من الملك بكسر
الميم، وأما الملك وهو مأخوذ من الملك بضم الميم، فهو الذي يملك النظام
القومي وتدبيرهم دون العين، وبعبارة أخرى يملك الأمر والحكم فيهم.
وقد ذكر لكل من القرائتين، ملك ومالك وجوه من التأييد غير أن المعنيين من
السلطنة ثابتان في حقه تعالى، والذي تعرفه اللغة والعرف أن الملك بضم الميم
هو المنسوب إلى الزمان يقال: ملك العصر الفلاني، ولا يقال مالك العصر
الفلاني إلا بعناية بعيدة، وقد قال تعالى: ﴿ملك يوم الدين﴾ فنسبه إلى
اليوم، وقال أيضا: ﴿لمن الملك اليوم لله الواحد القهار﴾ غافر: 16.
بحث روائي:
في العيون، والمعاني، عن الرضا (عليه السلام): في معنى قوله: بسم الله قال
(عليه السلام): يعني أسم نفسي بسمة من سمات الله وهي العبادة، قيل له: ما
السمة؟ قال العلامة.
أقول وهذا المعنى كالمتولد من المعنى الذي أشرنا إليه في كون الباء
للابتداء فإن العبد إذا وسم عبادته باسم الله لزم ذلك أن يسم نفسه التي
ينسب العبادة إليها بسمة من سماته.
وفي التهذيب، عن الصادق (عليه السلام)، وفي العيون، وتفسير العياشي، عن
الرضا (عليه السلام): أنها أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى
بياضها.
أقول: وسيجيء معنى الرواية في الكلام على الاسم الأعظم.
وفي العيون، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنها من
الفاتحة وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يقرأها ويعدها آية منها،
ويقول فاتحة الكتاب هي السبع المثاني أقول: وروي من طرق أهل السنة والجماعة
نظير هذا المعنى فعن الدارقطني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم): إذا قرأتم الحمد فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها
أم
القرآن والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها.
وفي الخصال، عن الصادق (عليه السلام) قال: ما لهم؟ قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله فزعموا أنها بدعة إذا أظهروها.
وعن الباقر (عليه السلام): سرقوا أكرم آية في كتاب الله بسم الله الرحمن
الرحيم، وينبغي الإتيان به عند افتتاح كل أمر عظيم أو صغير ليبارك فيه.
أقول والروايات عن أئمة أهل البيت في هذا المعنى كثيرة، وهي جميعا تدل على
أن البسملة جزء من كل سورة إلا سورة البراءة، وفي روايات أهل السنة
والجماعة ما يدل على ذلك.
ففي صحيح مسلم، عن أنس قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أنزل علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم.
وعن أبي داود عن ابن عباس وقد صححوا سندها قال: إن رسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم) كان لا يعرف فصل السورة، وفي رواية انقضاء السورة حتى ينزل
عليه، بسم الله الرحمن الرحيم.
أقول وروي هذا المعنى من طرق الخاصة عن الباقر (عليه السلام).
وفي الكافي، والتوحيد، والمعاني، وتفسير العياشي، عن الصادق (عليه السلام)
في حديث: والله إله كل شيء، الرحمن بجميع خلقه، الرحيم بالمؤمنين خاصة.
وروي عن الصادق (عليه السلام): الرحمن اسم خاص بصفة عامة والرحيم اسم عام بصفة خاصة.
أقول: قد ظهر مما مر وجه عموم الرحمن للمؤمن والكافر واختصاص الرحيم
بالمؤمن، وأما كون الرحمن اسما خاصا بصفة عامة والرحيم اسما عاما بصفة خاصة
فكأنه يريد به أن الرحمن خاص بالدنيا ويعم الكافر والمؤمن والرحيم عام
للدنيا والآخرة ويخص المؤمنين، وبعبارة أخرى: الرحمن يختص بالإفاضة
التكوينية التي يعم المؤمن والكافر، والرحيم يعم التكوين والتشريع الذي
بابه باب الهداية والسعادة، ويختص بالمؤمنين لأن الثبات والبقاء يختص
بالنعم التي تفاض عليهم والعاقبة للتقوى.
وفي كشف الغمة، عن الصادق (عليه السلام) قال: فقد لأبي (عليه السلام) بغلة
فقال لئن ردها الله علي لأحمدنه بمحامد يرضيها فما لبث أن أتي بها بسرجها
ولجامها فلما استوى وضم إليه ثيابه رفع رأسه إلى السماء وقال الحمد لله ولم
يزد، ثم قال ما تركت ولا أبقيت شيئا جعلت أنواع المحامد لله عز وجل، فما
من حمد إلا وهو داخل فيها.
قلت: وفي العيون، عن علي (عليه السلام): أنه سئل عن تفسيرها فقال: هو أن
الله عرف عباده بعض نعمه عليهم جملا إذ لا يقدرون على معرفة جميعها
بالتفصيل لأنها أكثر من أن تحصى أو تعرف، فقال: قولوا الحمد لله على ما
أنعم به علينا.
أقول: يشير (عليه السلام) إلى ما مر من أن الحمد، من العبد وإنما ذكره الله بالنيابة تأديبا وتعليما.
بحث فلسفي:
البراهين العقلية ناهضة على أن استقلال المعلول وكل شأن من شئونه إنما هو
بالعلة، وأن كل ما له من كمال فهو من أظلال وجود علته، فلو كان للحسن
والجمال حقيقة في الوجود فكماله واستقلاله للواجب تعالى لأنه العلة التي
ينتهي إليه جميع العلل، والثناء والحمد هو إظهار موجود ما بوجوده كمال
موجود آخر وهو لا محالة علته وإذا كان كل كمال ينتهي إليه تعالى فحقيقة كل
ثناء وحمد تعود وتنتهي إليه تعالى، فالحمد لله رب العالمين.
قوله تعالى: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾ الآية، العبد هو المملوك من الإنسان
أو من كل ذي شعور بتجريد المعنى كما يعطيه قوله تعالى: ﴿إن كل من في
السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا﴾ مريم: 93.
والعبادة مأخوذة منه وربما تفرقت اشتقاقاتها أو المعاني المستعملة هي فيها
لاختلاف الموارد، وما ذكره الجوهري في الصحاح أن أصل العبودية الخضوع فهو
من باب الأخذ بلازم المعنى وإلا فالخضوع متعد باللام والعبادة متعدية
بنفسها.
وبالجملة فكان العبادة هي نصب العبد نفسه في مقام المملوكية لربه ولذلك
كانت العبادة منافية للاستكبار وغير منافية للاشتراك فمن الجائز أن يشترك
أزيد من الواحد في ملك رقبة أو في عبادة عبد، قال تعالى: ﴿إن الذين
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين﴾ غافر: 60.
وقال تعالى: ﴿ولا يشرك بعبادة ربه أحدا﴾ الكهف: 110 فعد الإشراك ممكنا
ولذلك نهى عنه، والنهي لا يمكن إلا عن ممكن مقدور بخلاف الاستكبار عن
العبادة فإنه لا يجامعها.
والعبودية إنما يستقيم بين العبيد ومواليهم فيما يملكه الموالي منهم، وأما
ما لا يتعلق به الملك من شئون وجود العبد ككونه ابن فلان أو ذا طول في
قامته فلا يتعلق به عبادة ولا عبودية، لكن الله سبحانه في ملكه لعباده على
خلاف هذا النعت فلا ملكه يشوبه ملك ممن سواه ولا أن العبد يتبعض في نسبته
إليه تعالى فيكون شيء منه مملوكا وشيء، آخر غير مملوك، ولا تصرف من
التصرفات فيه جائز وتصرف آخر غير جائز كما أن العبيد فيما بيننا شيء منهم
مملوك وهو أفعالهم الاختيارية وشيء غير مملوك وهو الأوصاف الاضطرارية، وبعض
التصرفات فيهم جائز كالاستفادة من فعلهم وبعضها غير جائز كقتلهم من غير
جرم مثلا، فهو تعالى مالك على الإطلاق من غير شرط ولا قيد وغيره مملوك على
الإطلاق من غير شرط ولا قيد فهناك حصر من جهتين، الرب مقصور في المالكية،
والعبد مقصور في العبودية، وهذه هي التي يدل عليه قوله: إياك نعبد.
حيث قدم المفعول وأطلقت العبادة.
ثم إن الملك حيث كان مقتوم الوجود بمالكه كما عرفت مما مر، فلا يكون حاجبا
عن مالكه ولا يحجب عنه، فإنك إذا نظرت إلى دار زيد فإن نظرت إليها من جهة
أنها دار أمكنك أن تغفل عن، زيد وإن نظرت إليها بما أنها ملك زيد لم يمكنك
الغفلة عن مالكها وهو زيد.
ولكنك عرفت أن ما سواه تعالى ليس له إلا المملوكية فقط وهذه حقيقته فشيء
منه في الحقيقة لا يحجب عنه تعالى، ولا النظر إليه يجامع الغفلة عنه تعالى،
فله تعالى الحضور المطلق، قال سبحانه: ﴿أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد
ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط﴾ حم السجدة: 54، وإذا
كان كذلك فحق عبادته تعالى أن يكون عن حضور من الجانبين.
أما من جانب الرب عز وجل، فأن يعبد عبادة معبود حاضر وهو الموجب للالتفات المأخوذ في قوله تعالى إياك نعبد عن الغيبة إلى الحضور.
وأما من جانب العبد، فأن يكون عبادته عبادة عبد حاضر من غير أن يغيب في
عبادته فيكون عبادته صورة فقط من غير معنى وجسدا من غير روح أو يتبعض
فيشتغل بربه وبغيره، إما ظاهرا وباطنا كالوثنيين في عبادتهم لله ولأصنامهم
معا أو باطنا فقط كمن يشتغل في عبادته بغيره تعالى بنحو الغايات والأغراض
كان يعبد الله وهمه في غيره، أو يعبد الله طمعا في جنة أو خوفا من نار فإن
ذلك كله من الشرك في العبادة الذي ورد عنه النهي، قال تعالى: ﴿فاعبد الله
مخلصا له الدين﴾ الزمر: 2، وقال تعالى: ﴿ألا لله الدين الخالص والذين
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى الله يحكم
بينهم فيما هم فيه يختلفون﴾ الزمر: 3.
فالعبادة إنما تكون عبادة حقيقة، إذا كان على خلوص من العبد وهو الحضور
الذي ذكرناه، وقد ظهر أنه إنما يتم إذا لم يشتغل بغيره تعالى في عمله فيكون
قد أعطاه الشركة مع الله سبحانه في عبادته ولم يتعلق.
قلبه في عبادته رجاء أو خوفا هو الغاية في عبادته كجنة أو نار فيكون عبادته
له لا لوجه الله، ولم يشتغل بنفسه فيكون منافيا لمقام العبودية التي لا
تلائم الإنية والاستكبار، وكان الإتيان بلفظ المتكلم مع الغير للإيماء إلى
هذه النكتة فإن فيه هضما للنفس بإلغاء تعينها وشخوصها وحدها المستلزم لنحو
من الإنية والاستقلال بخلاف إدخالها في الجماعة وخلطها بسواد الناس فإن فيه
إمحاء التعين وإعفاء الأثر فيؤمن به ذلك.
وقد ظهر من ذلك كله: أن إظهار العبودية بقوله: ﴿إياك نعبد﴾ لا يشتمل على
نقص من حيث المعنى ومن حيث الإخلاص إلا ما في قوله: ﴿إياك نعبد﴾ من نسبة
العبد العبادة إلى نفسه المشتمل بالاستلزام على دعوى الاستقلال في الوجود
والقدرة والإرادة مع أنه مملوك والمملوك لا يملك شيئا، فكأنه تدورك ذلك
بقوله تعالى وإياك نستعين، أي إنما ننسب العبادة إلى أنفسنا وندعيه لنا مع
الاستعانة بك لا مستقلين بذلك مدعين ذلك دونك، فقوله: إياك نعبد وإياك
نستعين لإبداء معنى واحد وهو العبادة عن إخلاص، ويمكن أن يكون هذا هو الوجه
في اتحاد الاستعانة والعبادة في السياق الخطابي حيث قيل إياك نعبد وإياك
نستعين من دون أن يقال: إياك نعبد أعنا واهدنا الصراط المستقيم وأما تغيير
السياق في قوله: ﴿اهدنا الصراط﴾ الآية.
فسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
فقد بان بما مر من البيان في قوله إياك نعبد وإياك نستعين الآية الوجه في
الالتفات من الغيبة إلى الحضور، والوجه في الحصر الذي يفيده تقديم المفعول،
والوجه في إطلاق قوله: نعبد، والوجه في اختيار لفظ المتكلم مع الغير،
والوجه في تعقيب الجملة الأولى بالثانية، والوجه في تشريك الجملتين في
السياق، وقد ذكر المفسرون نكات أخرى في أطراف ذلك من أرادها فليراجع كتبهم
وهو الله سبحانه غريم لا يقضى دينه.