هشام الحيالي
الرتبــــــة


رقم العضوية : 12
الجنــس : 
المواليد : 15/08/1969
التسجيل : 23/12/2012
العمـــــــــــــــــر : 55
البـــــــــــــــــرج : 
الأبـراج الصينية : 
عدد المساهمات : 616
نقـــــــــاط التقيم : 1318
السٌّمعَــــــــــــــة : 0
علم بلدك : 
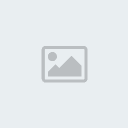
 |  موضوع: تفسير سورة البقرة عدد آياتها 286 ( آية 26-57 ) موضوع: تفسير سورة البقرة عدد آياتها 286 ( آية 26-57 )  السبت أبريل 27, 2013 6:21 pm السبت أبريل 27, 2013 6:21 pm | |
| تفسير سورة البقرة عدد آياتها 286 ( آية 26-57 )
وهي مدنية
{ 26 - 27 } { إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ * الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ }
يقول تعالى { إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا } أي: أيَّ مثل كان { بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا } لاشتمال الأمثال على الحكمة, وإيضاح الحق, والله لا يستحيي من الحق، وكأن في هذا, جوابا لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة، واعترض على الله في ذلك. فليس في ذلك محل اعتراض. بل هو من تعليم الله لعباده ورحمته بهم. فيجب أن تتلقى بالقبول والشكر. ولهذا قال: { فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ } فيتفهمونها، ويتفكرون فيها.
فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل، ازداد بذلك علمهم وإيمانهم، وإلا علموا أنها حق، وما اشتملت عليه حق، وإن خفي عليهم وجه الحق فيها لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثا، بل لحكمة بالغة، ونعمة سابغة.
{ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا } فيعترضون ويتحيرون، فيزدادون كفرا إلى كفرهم، كما ازداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم، ولهذا قال: { يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا } فهذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية. قال تعالى: { وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ } فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية، ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة [وضلالة] وزيادة شر إلى شرهم، ولقوم منحة [ورحمة] وزيادة خير إلى خيرهم، فسبحان من فاوت بين عباده، وانفرد بالهداية والإضلال.
ثم ذكر حكمته في إضلال من يضلهم وأن ذلك عدل منه تعالى فقال: { وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ } أي: الخارجين عن طاعة الله; المعاندين لرسل الله; الذين صار الفسق وصفهم; فلا يبغون به بدلا، فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى، كما اقتضت حكمته وفضله هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال الصالحة.
والفسق نوعان: نوع مخرج من الدين، وهو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان; كالمذكور في هذه الآية ونحوها، ونوع غير مخرج من الإيمان كما في قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا } [الآية].
ثم وصف الفاسقين فقال: { الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ } وهذا يعم العهد الذي بينهم وبينه والذي بينهم وبين عباده الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة والإلزامات، فلا يبالون بتلك المواثيق; بل ينقضونها ويتركون أوامره ويرتكبون نواهيه; وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق.
{ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ } وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة، فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان به والقيام بعبوديته، وما بيننا وبين رسوله بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام بحقوقه، وما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب; وسائر الخلق بالقيام بتلك الحقوق التي أمر الله أن نصلها.
فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق، وقاموا بها أتم القيام، وأما الفاسقون، فقطعوها، ونبذوها وراء ظهورهم; معتاضين عنها بالفسق والقطيعة; والعمل بالمعاصي; وهو: الإفساد في الأرض.
فـ { فَأُولَئِكَ } أي: من هذه صفته { هُمُ الْخَاسِرُونَ } في الدنيا والآخرة، فحصر الخسارة فيهم; لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم; ليس لهم نوع من الربح؛ لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان; فمن لا إيمان له لا عمل له; وهذا الخسار هو خسار الكفر، وأما الخسار الذي قد يكون كفرا; وقد يكون معصية; وقد يكون تفريطا في ترك مستحب، المذكور في قوله تعالى: { إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ } فهذا عام لكل مخلوق; إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح; والتواصي بالحق; والتواصي بالصبر; وحقيقة فوات الخير; الذي [كان] العبد بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه.
{ 28 } ثم قال تعالى: { كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ }
هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار، أي: كيف يحصل منكم الكفر بالله; الذي خلقكم من العدم; وأنعم عليكم بأصناف النعم; ثم يميتكم عند استكمال آجالكم; ويجازيكم في القبور; ثم يحييكم بعد البعث والنشور; ثم إليه ترجعون; فيجازيكم الجزاء الأوفى، فإذا كنتم في تصرفه; وتدبيره; وبره; وتحت أوامره الدينية; ومن بعد ذلك تحت دينه الجزائي; أفيليق بكم أن تكفروا به; وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه وحماقة ؟ بل الذي يليق بكم أن تؤمنوا به وتتقوه وتشكروه وتخافوا عذابه; وترجوا ثوابه.
{ 29 } { هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }
{ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } أي: خلق لكم, برا بكم ورحمة, جميع ما على الأرض, للانتفاع والاستمتاع والاعتبار.
وفي هذه الآية العظيمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة, لأنها سيقت في معرض الامتنان، يخرج بذلك الخبائث, فإن [تحريمها أيضا] يؤخذ من فحوى الآية, ومعرفة المقصود منها, وأنه خلقها لنفعنا, فما فيه ضرر, فهو خارج من ذلك، ومن تمام نعمته, منعنا من الخبائث, تنزيها لنا.
وقوله: { ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }
{ اسْتَوَى } ترد في القرآن على ثلاثة معاني: فتارة لا تعدى بالحرف، فيكون معناها, الكمال والتمام, كما في قوله عن موسى: { وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى } وتارة تكون بمعنى " علا " و " ارتفع " وذلك إذا عديت بـ " على " كما في قوله تعالى: { ثم استوى على العرش } { لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ } وتارة تكون بمعنى " قصد " كما إذا عديت بـ " إلى " كما في هذه الآية، أي: لما خلق تعالى الأرض, قصد إلى خلق السماوات { فسواهن سبع سماوات } فخلقها وأحكمها, وأتقنها, { وهو بكل شيء عليم } فـ { يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها } و { يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ } يعلم السر وأخفى.
وكثيرا ما يقرن بين خلقه للخلق وإثبات علمه كما في هذه الآية, وكما في قوله تعالى: { أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ } لأن خلقه للمخلوقات, أدل دليل على علمه, وحكمته, وقدرته.
{ 30 - 34 } { وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ * وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ * وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ }
هذا شروع في ذكر فضل آدم عليه السلام أبي البشر أن الله حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك, وأن الله مستخلفه في الأرض.
فقالت الملائكة عليهم السلام: { أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا } بالمعاصي { وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ } [و]هذا تخصيص بعد تعميم, لبيان [شدة] مفسدة القتل، وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة المجعول في الأرض سيحدث منه ذلك, فنزهوا الباري عن ذلك, وعظموه, وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خال من المفسدة فقالوا: { وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ } أي: ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك، { وَنُقَدِّسُ لَكَ } يحتمل أن معناها: ونقدسك, فتكون اللام مفيدة للتخصيص والإخلاص، ويحتمل أن يكون: ونقدس لك أنفسنا، أي: نطهرها بالأخلاق الجميلة, كمحبة الله وخشيته وتعظيمه, ونطهرها من الأخلاق الرذيلة.
قال الله تعالى للملائكة: { إِنِّي أَعْلَمُ } من هذا الخليفة { مَا لَا تَعْلَمُونَ } ؛ لأن كلامكم بحسب ما ظننتم, وأنا عالم بالظواهر والسرائر, وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة, أضعاف أضعاف ما في ضمن ذلك من الشر فلو لم يكن في ذلك, إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين, والشهداء والصالحين, ولتظهر آياته للخلق, ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة, كالجهاد وغيره, وليظهر ما كمن في غرائز بني آدم من الخير والشر بالامتحان, وليتبين عدوه من وليه, وحزبه من حربه, وليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه, واتصف به, فهذه حكم عظيمة, يكفي بعضها في ذلك.
ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام, فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض, أراد الله تعالى, أن يبين لهم من فضل آدم, ما يعرفون به فضله, وكمال حكمة الله وعلمه فـ { عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا } أي: أسماء الأشياء, وما هو مسمى بها، فعلمه الاسم والمسمى, أي: الألفاظ والمعاني, حتى المكبر من الأسماء كالقصعة، والمصغر كالقصيعة.
{ ثُمَّ عَرَضَهُمْ } أي: عرض المسميات { عَلَى الْمَلَائِكَةِ } امتحانا لهم, هل يعرفونها أم لا؟.
{ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } في قولكم وظنكم, أنكم أفضل من هذا الخليفة.
{ قَالُوا سُبْحَانَكَ } أي: ننزهك من الاعتراض منا عليك, ومخالفة أمرك. { لَا عِلْمَ لَنَا } بوجه من الوجوه { إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا } إياه, فضلا منك وجودا، { إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ } العليم الذي أحاط علما بكل شيء, فلا يغيب عنه ولا يعزب مثقال ذرة في السماوات والأرض, ولا أصغر من ذلك ولا أكبر.
الحكيم: من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق, ولا يشذ عنها مأمور، فما خلق شيئا إلا لحكمة: ولا أمر بشيء إلا لحكمة، والحكمة: وضع الشيء في موضعه اللائق به، فأقروا, واعترفوا بعلم الله وحكمته, وقصورهم عن معرفة أدنى شيء، واعترافهم بفضل الله عليهم; وتعليمه إياهم ما لا يعلمون.
فحينئذ قال الله: { يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ } أي: أسماء المسميات التي عرضها الله على الملائكة; فعجزوا عنها، { فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ } تبين للملائكة فضل آدم عليهم; وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذا الخليفة، { قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } وهو ما غاب عنا; فلم نشاهده، فإذا كان عالما بالغيب; فالشهادة من باب أولى، { وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ } أي: تظهرون { وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ }
ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم; إكراما له وتعظيما; وعبودية لله تعالى، فامتثلوا أمر الله; وبادروا كلهم بالسجود، { إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى } امتنع عن السجود; واستكبر عن أمر الله وعلى آدم، قال: { أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا } وهذا الإباء منه والاستكبار; نتيجة الكفر الذي هو منطو عليه; فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره واستكباره.
وفي هذه الآيات من العبر والآيات; إثبات الكلام لله تعالى; وأنه لم يزل متكلما; يقول ما شاء; ويتكلم بما شاء; وأنه عليم حكيم، وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالوجب عليه; التسليم; واتهام عقله; والإقرار لله بالحكمة، وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة; وإحسانه بهم; بتعليمهم ما جهلوا; وتنبيههم على ما لم يعلموه.
وفيه فضيلة العلم من وجوه:
منها: أن الله تعرف لملائكته; بعلمه وحكمته ، ومنها: أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم; وأنه أفضل صفة تكون في العبد، ومنها: أن الله أمرهم بالسجود لآدم; إكراما له; لما بان فضل علمه، ومنها: أن الامتحان للغير; إذا عجزوا عما امتحنوا به; ثم عرفه صاحب الفضيلة; فهو أكمل مما عرفه ابتداء، ومنها: الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن; وبيان فضل آدم; وأفضال الله عليه; وعداوة إبليس له; إلى غير ذلك من العبر.
{ 35 - 36 } { وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ * فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ }
لما خلق الله آدم وفضله; أتم نعمته عليه; بأن خلق منه زوجة ليسكن إليها; ويستأنس بها; وأمرهما بسكنى الجنة; والأكل منها رغدا; أي: واسعا هنيئا، { حَيْثُ شِئْتُمَا } أي: من أصناف الثمار والفواكه; وقال الله له: { إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى }
{ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ } نوع من أنواع شجر الجنة; الله أعلم بها، وإنما نهاهما عنها امتحانا وابتلاء [أو لحكمة غير معلومة لنا] { فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ } دل على أن النهي للتحريم; لأنه رتب عليه الظلم.
فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهيا عنه; حتى أزلهما، أي: حملهما على الزلل بتزيينه. { وَقَاسَمَهُمَا } بالله { إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ } فاغترا به وأطاعاه; فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم والرغد; وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة.
{ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ } أي: آدم وذريته; أعداء لإبليس وذريته، ومن المعلوم أن العدو; يجد ويجتهد في ضرر عدوه وإيصال الشر إليه بكل طريق; وحرمانه الخير بكل طريق، ففي ضمن هذا, تحذير بني آدم من الشيطان كما قال تعالى { إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ } { أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا }
ثم ذكر منتهى الإهباط إلى الأرض، فقال: { وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ } أي: مسكن وقرار، { وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ } انقضاء آجالكم, ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها, وخلقت لكم، ففيها أن مدة هذه الحياة, مؤقتة عارضة, ليست مسكنا حقيقيا, وإنما هي معبر يتزود منها لتلك الدار, ولا تعمر للاستقرار.
{ 37 } { فَتَلَقَّى آدَمُ }
{ فَتَلَقَّى آدَمُ } أي: تلقف وتلقن, وألهمه الله { مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ } وهي قوله: { رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا } الآية، فاعترف بذنبه وسأل الله مغفرته { فَتَابَ } الله { عَلَيْهِ } ورحمه { إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ } لمن تاب إليه وأناب.
وتوبته نوعان: توفيقه أولا, ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانيا.
{ الرَّحِيمِ } بعباده, ومن رحمته بهم, أن وفقهم للتوبة, وعفا عنهم وصفح.
{ 38 - 39 } { قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }
كرر الإهباط, ليرتب عليه ما ذكر وهو قوله: { فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى } أي: أيَّ وقت وزمان جاءكم مني -يا معشر الثقلين- هدى, أي: رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني, ويدنيكم مني; ويدنيكم من رضائي، { فمن تبع هداي } منكم, بأن آمن برسلي وكتبي, واهتدى بهم, وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب, والامتثال للأمر والاجتناب للنهي، { فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ }
وفي الآية الأخرى: { فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى }
فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء:
نفي الخوف والحزن والفرق بينهما, أن المكروه إن كان قد مضى, أحدث الحزن, وإن كان منتظرا, أحدث الخوف، فنفاهما عمن اتبع هداه وإذا انتفيا, حصل ضدهما, وهو الأمن التام، وكذلك نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداه وإذا انتفيا ثبت ضدهما، وهو الهدى والسعادة، فمن اتبع هداه, حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى، وانتفى عنه كل مكروه, من الخوف, والحزن, والضلال, والشقاء، فحصل له المرغوب, واندفع عنه المرهوب، وهذا عكس من لم يتبع هداه, فكفر به, وكذب بآياته.
فـ { أولئك أصحاب النار } أي: الملازمون لها, ملازمة الصاحب لصاحبه, والغريم لغريمه، { هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } لا يخرجون منها، ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
وفي هذه الآيات وما أشبهها, انقسام الخلق من الجن والإنس, إلى أهل السعادة, وأهل الشقاوة, وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك، وأن الجن كالإنس في الثواب والعقاب, كما أنهم مثلهم, في الأمر والنهي.
ثم شرع تعالى يذكِّر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه فقال:
{ 40 - 43 } { يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ * وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ * وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ * وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ }
{ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ } المراد بإسرائيل: يعقوب عليه السلام، والخطاب مع فرق بني إسرائيل, الذين بالمدينة وما حولها, ويدخل فيهم من أتى من بعدهم, فأمرهم بأمر عام، فقال: { اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ } وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة بعضها، والمراد بذكرها بالقلب اعترافا, وباللسان ثناء, وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه.
{ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي } وهو ما عهده إليهم من الإيمان به, وبرسله وإقامة شرعه.
{ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ } وهو المجازاة على ذلك.
والمراد بذلك: ما ذكره الله في قوله: { وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ [وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي] } إلى قوله: { فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ }
ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده, وهو الرهبة منه تعالى, وخشيته وحده, فإن مَنْ خشِيَه أوجبت له خشيته امتثال أمره واجتناب نهيه.
ثم أمرهم بالأمر الخاص, الذي لا يتم إيمانهم, ولا يصح إلا به فقال: { وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ } وهو القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بالإيمان به, واتباعه, ويستلزم ذلك, الإيمان بمن أنزل عليه، وذكر الداعي لإيمانهم به، فقال: { مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ } أي: موافقا له لا مخالفا ولا مناقضا، فإذا كان موافقا لما معكم من الكتب, غير مخالف لها; فلا مانع لكم من الإيمان به, لأنه جاء بما جاءت به المرسلون, فأنتم أولى من آمن به وصدق به, لكونكم أهل الكتب والعلم.
وأيضا فإن في قوله: { مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ } إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به, عاد ذلك عليكم, بتكذيب ما معكم, لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء، فتكذيبكم له تكذيب لما معكم.
وأيضا, فإن في الكتب التي بأيدكم, صفة هذا النبي الذي جاء بهذا القرآن والبشارة به، فإن لم تؤمنوا به, كذبتم ببعض ما أنزل إليكم, ومن كذب ببعض ما أنزل إليه, فقد كذب بجميعه، كما أن من كفر برسول, فقد كذب الرسل جميعهم.
فلما أمرهم بالإيمان به, نهاهم وحذرهم من ضده وهو الكفر به فقال: { وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ } أي: بالرسول والقرآن.
وفي قوله: { أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ } أبلغ من قوله: { ولا تكفروا به } لأنهم إذا كانوا أول كافر به, كان فيه مبادرتهم إلى الكفر به, عكس ما ينبغي منهم, وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى بهم من بعدهم.
ثم ذكر المانع لهم من الإيمان, وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبدية، فقال: { وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا } وهو ما يحصل لهم من المناصب والمآكل, التي يتوهمون انقطاعها, إن آمنوا بالله ورسوله, فاشتروها بآيات الله واستحبوها, وآثروها.
{ وَإِيَّايَ } أي: لا غيري { فَاتَّقُونِ } فإنكم إذا اتقيتم الله وحده, أوجبت لكم تقواه, تقديم الإيمان بآياته على الثمن القليل، كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل, فهو دليل على ترحل التقوى من قلوبكم.
ثم قال: { وَلَا تَلْبِسُوا } أي: تخلطوا { الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ } فنهاهم عن شيئين, عن خلط الحق بالباطل, وكتمان الحق؛ لأن المقصود من أهل الكتب والعلم, تمييز الحق, وإظهار الحق, ليهتدي بذلك المهتدون, ويرجع الضالون, وتقوم الحجة على المعاندين؛ لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته, ليميز الحق من الباطل, ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين، فمن عمل بهذا من أهل العلم, فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم.
ومن لبس الحق بالباطل, فلم يميز هذا من هذا, مع علمه بذلك, وكتم الحق الذي يعلمه, وأمر بإظهاره, فهو من دعاة جهنم, لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم, فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين.
ثم قال: { وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ } أي: ظاهرا وباطنا { وَآتُوا الزَّكَاةَ } مستحقيها، { وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ } أي: صلوا مع المصلين، فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل الله وآيات الله, فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة, وبين الإخلاص للمعبود, والإحسان إلى عبيده، وبين العبادات القلبية البدنية والمالية.
وقوله: { وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ } أي: صلوا مع المصلين, ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبها، وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة لأنه عبّر عن الصلاة بالركوع، والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها.
{ 44 } { أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ }
{ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ } أي: بالإيمان والخير { وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ } أي: تتركونها عن أمرها بذلك، والحال: { وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ } وأسمى العقل عقلا لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير, وينعقل به عما يضره، وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به, وأول تارك لما ينهى عنه، فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله, أو نهاه عن الشر فلم يتركه, دل على عدم عقله وجهله, خصوصا إذا كان عالما بذلك, قد قامت عليه الحجة.
وهذه الآية, وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل, فهي عامة لكل أحد لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ } وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر, لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين، وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: أمر غيره ونهيه, وأمر نفسه ونهيها، فترك أحدهما, لا يكون رخصة في ترك الآخر، فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين, والنقص الكامل أن يتركهما، وأما قيامه بأحدهما دون الآخر, فليس في رتبة الأول, وهو دون الأخير، وأيضا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله، فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة.
{ 45 - 48 } { وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ * الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ * وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ }
أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه، وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديها، والصبر عن معصية الله حتى يتركها, والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها، فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور, ومن يتصبر يصبره الله، وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان, وتنهى عن الفحشاء والمنكر, يستعان بها على كل أمر من الأمور { وَإِنَّهَا } أي: الصلاة { لَكَبِيرَةٌ } أي: شاقة { إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ } فإنها سهلة عليهم خفيفة؛ لأن الخشوع, وخشية الله, ورجاء ما عنده يوجب له فعلها, منشرحا صدره لترقبه للثواب, وخشيته من العقاب، بخلاف من لم يكن كذلك, فإنه لا داعي له يدعوه إليها, وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه.
والخشوع هو: خضوع القلب وطمأنينته, وسكونه لله تعالى, وانكساره بين يديه, ذلا وافتقارا, وإيمانا به وبلقائه.
ولهذا قال: { الَّذِينَ يَظُنُّونَ } أي: يستيقنون { أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ } فيجازيهم بأعمالهم { وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ } فهذا الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم التسلي في المصيبات, ونفس عنهم الكربات, وزجرهم عن فعل السيئات، فهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفات العاليات، وأما من لم يؤمن بلقاء ربه, كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء عليه.
ثم كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته, وعظا لهم, وتحذيرا وحثا.
وخوفهم بيوم القيامة الذي { لَا تَجْزِي } فيه، أي: لا تغني { نَفْسٌ } ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين { عَنْ نَفْسٍ } ولو كانت من العشيرة الأقربين { شَيْئًا } لا كبيرا ولا صغيرا وإنما ينفع الإنسان عمله الذي قدمه.
{ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا } أي: النفس, شفاعة لأحد بدون إذن الله ورضاه عن المشفوع له, ولا يرضى من العمل إلا ما أريد به وجهه، وكان على السبيل والسنة، { وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ } أي: فداء { ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب } ولا يقبل منهم ذلك { وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ } أي: يدفع عنهم المكروه، فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه، فقوله: { لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا } هذا في تحصيل المنافع، { وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ } هذا في دفع المضار, فهذا النفي للأمر المستقل به النافع.
{ ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل } هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن يملكه بعوض, كالعدل, أو بغيره, كالشفاعة، فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين, لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة من النفع, وأن يعلقه بالله الذي يجلب المنافع, ويدفع المضار, فيعبده وحده لا شريك له ويستعينه على عبادته.
{ 49 - 57 } { وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ * وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ * وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ * ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ * ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ }
هذا شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل فقال: { وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ } أي: من فرعون وملئه وجنوده وكانوا قبل ذلك { يَسُومُونَكُمْ } أي: يولونهم ويستعملونهم، { سُوءَ الْعَذَابِ } أي: أشده بأن كانوا { يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ } خشية نموكم، { وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ } أي: فلا يقتلونهن، فأنتم بين قتيل ومذلل بالأعمال الشاقة، مستحيي على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه فهذا غاية الإهانة، فمن الله عليهم بالنجاة التامة وإغراق عدوهم وهم ينظرون لتقر أعينهم.
{ وَفِي ذَلِكم } أي: الإنجاء { بَلَاءٌ } أي: إحسان { مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ } فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره.
ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسى أربعين ليلة لينزل عليهم التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة، ثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من بعده, أي: ذهابه.
{ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ } عالمون بظلمكم, قد قامت عليكم الحجة, فهو أعظم جرما وأكبر إثما.
ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى بأن يقتل بعضكم بعضا فعفا الله عنكم بسبب ذلك { لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } الله.
{ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً } وهذا غاية الظلم والجراءة على الله وعلى رسوله، { فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ } إما الموت أو الغشية العظيمة، { وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ } وقوع ذلك, كل ينظر إلى صاحبه، { ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }
ثم ذكر نعمته عليكم في التيه والبرية الخالية من الظلال وسعة الأرزاق، فقال: { وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ } وهو اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب، ومنه الزنجبيل والكمأة والخبز وغير ذلك.
{ وَالسَّلْوَى } طائر صغير يقال له السماني، طيب اللحم، فكان ينزل عليهم من المن والسلوى ما يكفيهم ويقيتهم { كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } أي: رزقا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين, فلم يشكروا هذه النعمة, واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب.
{ وَمَا ظَلَمُونَا } يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا لأن الله لا تضره معصية العاصين, كما لا تنفعه طاعات الطائعين، { وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ } فيعود ضرره عليهم. | |
|






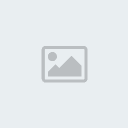


.gif)

.gif)




