مستقبل العالم
بما أننا مسلمون، فإن الثقة والاطمئنان والتفاؤل بمستقبل البشرية تغمر قلوبنا، وإن كل ما يحدث في العالم، وان بعث على الاحساس بالخطر الهائل المخيف، وتوقّعه الخطر الذي يحمل الفناء والدمار للبشرية، ويحوّل الكرة الأرضية إلى رماد ، لتذهب ادراج الرياح جهود البشر كلها عبر آلاف السنين لبناء الأرض وتعميرها.
ولكن، نحن المسلمين، رغم كل ذلك، نعتقد اعتقاداً جازماً، أنه لابد أن تدوم الحياة ويعيش الإنسان، بعدنا سنين متمادية، وربما ملايين السنين، ولا تفنى بمثل هذه البساطة.
نعتقد، بكل ثقة واطمئنان، أنه سيولد بعدنا الكثير من المسلمين، يعيشون في هذه الحياة ويرحلون، فلا يخطر في أذهاننا هذا المصير الرهيب لعمر العالم، وهو انتهاء عمر الإنسان وعمر الأرض.
إن تعاليم الأنبياء قد بعثت في نفوسنا الأمان والاطمئنان، وفي الواقع إننا نؤمن في أعماق قلوبنا، بالامدادات الغيبية.
فإذا قيل لنا: إن هناك مذنّباً عظيماً، يسير بسرعة هائلة جنونية في الفضاء، وبعد ستة أشهر سيصل المدار الأرض، ثم يصطدم بالأرض بقوة، ليحوّلها بلحظة واحدة إلى رماد، فإن ذلك لا يثير فينا الفزع والخوف، إنّ أعماقنا مليئة بالاطمئنان والثقة، بأن حديقة البشرية الجديدة العهد بالتفتّح والازدهار، لا تفنى بمثل هذه السهولة.
أجل.. كما أننا نؤمن بأن العالم لا يفنى بالمذنّب الطائر، أو بغيره من الحوادث الفضائية؛ كذلك نؤمن بأن العالم لا يفنى بيد البشر نفسه، بواسطة القوى المخرّبة التي صنعها الإنسان بنفسه، أجل إننا لا نصدق بذلك، بفضل الالهام المعنوي، والمدد الغيبي، الذي اقتبسناه من تعاليم الأنبياء.
ولكن الآخرين هل يمتلكون مثل هذا الايمان أم لا؟ هل تعرف نفوسهم هذه الثقة والاطمئنان والتفاؤل بمستقبل الإنسان والأرض، والحياة المدنية، والسعادة والعدالة والحرية؟ كلا.
وبين الفينة والأخرى، تقرأ في الصحف، أو نستمع في أحاديث الزعماء، وقادة السياسة العالمية وخطبهم، للآراء المفزعة حول المستقبل المخيف، الذي ينتظر البشرية.
فإذا لم نمتلك في أعماقنا ذلك الاعتقاد، الذي بعثه الدين فينا، وفقدنا الايمان المدد الغيبي، واعتمدت أحكامنا على العوامل، والعلل الظاهرية فحسب؛ فلابد أن نعتقد بأن هؤلاء المتشائمين، على حق في نظراتهم حول المستقبل البشري.
لماذا لا نكون متشائمين؟ إن العالم الذي يتوقف مصيره، على زر يضغطه انسان، وبعد ذلك تعمل الآلات المخرّبة عملها المخيف، التي لا يعلم مداها إلاّ الله، العالم الذي يقف على فوهة بركان، وعلى ركام هائل من البارود، وشرارة واحدة، تكفي لأن يشبّ الحريق في العالم كله، فأين موضع التفاؤل بالمستقبل، ولماذا لا نكون متشائمين؟.
يقول (رسل) في كتابه (الطموحات الجديدة): (ان العصر الحديث، الذي تواءمت فيه الحيرة والذهول والقلق، مع الضعف والعجز، وقد شملت هذه الحالة التعيسة الجميع؛ فنرى بأننا نسير إلى حرب لا يرغب فيها أيّ واحد منّا، حرب يعلم جميعنا، بأنها سوف تقذف بالقسم الأعظم من البشر إلى العدم والفناء؛ ونحن كالأرنب المذعور الذي يقف مصعوقاً أمام الحية، ننظر بفزع إلى الخطر الهائل الزاحف إلينا، ولا ندري ماذا نعمل لنوقفه عند حدّه؟
ونسمع باستمرار حكايات القنابل المدمّرة، الذرية، والهيدروجينية، والمدن التي سُويت مع التراب بفعل هذه القنابل، ونسمع بخيول الجيش الروسي، وتتناقل فيما بيننا، أحاديث المجاعات، والجرائم الوحشية؛ ولكن، رغم أن العقل يفرض علينا أن نرتجف من المستقبل المخيف، لأن جزءاً من وجودنا يلتذّ به، وبذلك يحدث جرح عميق في روحنا ويمزّقها إلى قسم سليم، وقسم غير سليم، ولكن، رغم ذلك، لا نتّخذ قراراً حاسماً للوقوف بوجهه).
ولكن هل يتمكن البشر أن يتخذ مثل هذا القرار الحاسم؟
ويقول رسل أيضاً: (إن تأريخ نشأة الإنسان طويلٌ؛ ولكنه بالنسبة لعمر الأرض ، قصيرٌ جداً؛ فإنهم يعتقدون بأن عمر الإنسان مليون سنة فحسب؛ ويعتقد الكثير ومنهم انشتاين، بأن الإنسان، قد طوى المراحل المقدّرة لحياته، ولا تمضي إلاّ سنوات قليلة، ليبيد نفسه ويقضي عليها بقدراته العلمية نفسها).
اننا لو اعتمدنا على العوامل الظاهرية فحسب للحكم ولتقييم الأشياء؛ فإن هذا التنبّؤ بدمار الأرض صحيح.
وإن الايمان المعنوي، الايمان بالامدادات الغيبية، وان للعالم رباً يحميه هو وحده الذي يحوّل هذا التشاؤم إلى التفاؤل، وهو الذي يخلق الاطمئنان والايمان، بأن السعادة والتكامل، والحياة الإنسانية، والحياة الحرة الكريمة، والأمن، هي التي تنتظر البشرية في المستقبل.
اننا إذا تقبلنا هذا التشاؤم، واعتقدنا بهذا المستقبل الرهيب، الذي تنبّأ به هؤلاء فسوف يكتسب الوضع، هيئة مضحكة غريبة؛ فإن مثل البشر يكون كالطفل، الذي يأخذ بالنموّ، وحين يمتلك القدرة على إمساك السكين، يمسكها، ثم يطعن بها نفسه وينتحر، ولم ينتفع من وجوده أبداً.
فإنهم يقولون: بأنه قد مرّ على عمر الأرض (40000) مليون سنة، ومرّ على عمر الإنسان ما يناهز المليون سنة؛ فإذا فرضنا أن عمر الأرض سنة واحدة، وقد مرّ عليها ثمانية أشهر، لم يوجد فيها أي كائن حيّ، وفي الشهر التاسع ظهر أول كائن حيّ بصورة بكتريا، أو جرثومة صغيرة، ذات خلية واحدة؛ وفي الأسبوع الثاني من الشهر الأخير من هذه السنة، ظهرت الحيوانات الثدييّة، وفي الربع الأخير، من الساعة الأخيرة، من اليوم الأخير من تلك السنة ظهر الإنسان؛ وبعد مروره بمراحل التوحش والغابية، يأخذ بالتطور والتكامل، ويصل إلى الدقيقة الأخيرة من تلك السنة.
وفي هذه الدقيقة الأخيرة، تتفتق مواهب الإنسان واستعداداته، ويعمل العقل والعلم البشري علمه المثمر، وينتج هذا التمدّن العظيم، في هذه الدقيقة الأخيرة، يتمكن الإنسان أن يثبت بأنه خليفة الله.
ولكن إذا قلنا: بأن الإنسان في هذه الدقيقة الأخيرة، التي يصل فيها إلى هذا التقدم العلمي الكبير، يقضي على نفسه.
إذا قلنا: بأن الإنسان سيحفر قبره، بيد قدراته العلمية نفسها، وليس هناك إلاّ خطوات ويسقط في قبره، إذا كان هذا الانتحار الجماعي، هو المصير الذي ينتظر البشر؛ فحينئذ لابد أن نقول بأن ايجاد مثل هذا الموجود وخلقه كان عبثاً وجزافاً.
أجل.. إن الإنسان المادي لايفكر إلاّ بهذه الطريقة؛ وأما الإنسان الذي نشأ وترعرع، في أحضان التعاليم الإلهية؛ فانه لا يفكر بهذا الاسلوب، انه يؤمن بأن العالم لا يمكن أن يسقط، في أيدي حفنة من المجانين، وهو يعتقد بأن العالم وان توقف اليوم على حافة الخطر، لكن الله الذي أنقذ البشرية في العصور السابقة، بين فترة وأخرى، وأرسل المصلح والمخلص من عالم الغيب، سيقوم بمثل هذا العمل في الظروف الصعبة التي تمرّ بها الإنسان. بعد ذلك، هو يؤمن بأن أعمال العالم لا تصدر عبثاً، هو يؤمن بأن المصير الرهيب، والنهاية المفزعة التي يتصدرها المادي لو تحقّقت، فإنها تتنافى وحكمة الله وعنايته.
إذ مقتضى الحكمة والعناية *** ايصالُ كل ممكن لغاية
كلا، لم يصل عمر العالم لنهايته؛ فإننا لازلنا في بداية الطريق، إن البشرية تنتظر الحكومة القائمة، على العقل والحكمة والخير والسعادة والأمن والرفاه والوحدة العالمية الشاملة؛ الدولة التي يحكمها الصالحون، ويتحقق فيها انتخاب الأصلح بمفهومه الصحيح، إنه يوم السعادة والنور.
(وأشرقت الأرض بنور ربها)؛ إنه اليوم الذي يقول حوله الحديث الشريف: ((إذا قام القائم حكم بالعدل، ارتفع في أيامه الجور، وأمنت به السبل، وأخرجت الأرض بركاتها، ولا يجد الرجل منكم يومئذ موضعاً لصدقته ولا بره؛ وهو قوله تعالى: والعاقبة للمتقين)).
فبدلاً، من أن نجلس يائسين، ذاهلين، يمزّقنا القلق والتوتر؛ ونقول: بأنه قد انتهى عمر البشر، ولم تبق إلاّ خطوات للقبر، الذي حفره الإنسان بيده، وسوف تنقضي الأيام السعيدة.
بدلاً من ذلك كله، يجب أن نزرع التفاؤل في نفوسنا؛ فنقول: بأن هذا الظهور، كما في التجارب السابقة، التي مرّت عليها البشرية، لم يتحقّق إلاّ بعد الشدائد، وانّ الفرج يكون دائماً بعد الشدة، والبرق دائماً يبرق في الظلام.
يقول الامام علي ـ عليه السلام ـ حول ظهور المهدي الموعود:
((حتى تقوم الحرب بكم على ساق، باديةً نواجذها، مملوءةً أخلافها، حلواً رضاعها، علقماً عاقبتها؛ ألا وفي غد ـ وسيأتي غد بما لا تعرفون ـ يأخذ الوالي من غيرها عمالها، على مساوي أعمالها وتُخرج الأرض له افلاذ كبدها ـ وتلقى إليه سلماً مقاليدها، فيريكم كيف عدلُ السيرة ويحيى ميت الكتاب والسنّة)).
الامام أميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ يتحدّث في هذه الخطبة، عن مستقبل قاتم رهيب، يتحدّث عن الحروب الوحشية؛ ولكنه، يبشّر بالفجر بعد هذا الليل المظلم؛ ويقول القرآن الكريم: (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أنّ الأرض يرثها عبادي الصالحون)(1).
أجل، إن هذه هي فلسفة المهدوية، ففي الوقت الذي ستحدث فيه الهزّات الشديدة، والمذابح والجرائم، والمآسي الدامية؛ ولكن، رغم ذلك سيظهر الفجر، وستصل البشرية إلى الغد الذي يفيض سعادة، حيث سينتصر فيه العقل على الجهل، والتوحيد على الشرك، والعدالة على الظلم والسعادة على الشقاء، وهذه هي البشارة.
(اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعزّ بها الاسلام وأهله، وتذلّ بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك، والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدينا والآخرة).
ـــــــــــ
(1) الأنبياء: 105.
من بحوث : الشهيد الشيخ مرتضى المطهري






.gif)

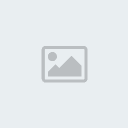








.gif)

.gif)




